ورقة قُدّمت في المنتدى السنويّ لفلسطين- 2025، والتي نظّمها المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات ومؤسّسة الدراسات الفلسطينيّة، في جلسة نظّمتها مجلّة منهجيّات، بعنوان "التعليم في غزّة منذ السابع من أكتوبر: إبادة تعليميّة ومعجزة الصمود". الدوحة 26 كانون الثاني/ يناير، 2025.
على مدار الأشهر الأولى من العدوان الذي تحوّل تدريجيًّا إلى إبادة جماعيّة، وصُنِّف أحد أقسى الحروب في العصر الحديث، إذ تجاوز حجم الدمار الذي خلّفه ما شهدته الحرب العالميّة الثانية، أصبحت غزّة، المدينة الساحليّة الجميلة، أكثر دمارًا من درسدن الألمانيّة التي عُدّت الأكثر تدميرًا في تلك الحرب. خلقت هذه الحرب تحوّلات عميقة، تضمّنت أشكالًا متعدّدة من الإبادة تجاوزت العنصر البشريّ، خصوصًا الأطفال وكبار السنّ، إلى تدمير شواهد التاريخ التي تعود إلى أكثر من ثلاثة آلاف عام. كما أحدثت تغييرات ديموغرافيّة، نتيجة تدمير المدينة وبنيتها التحتيّة.
جاء تدمير التعليم في قلب العدوان، فلم تبقَ مدرسة واحدة على حالها. بين مدارس دُمّرت بالكامل، وأخرى تحوّلت إلى مأوى للنازحين، أصبحت مدرسة مُعدّة لتعليم 500 طفل مأوًى للآلاف، والطفل الذي كان بالكاد يستطيع أن يقضي 6 ساعات في المدرسة، بات يعيش فيها بالكامل، ويقف في طوابير جديدة بدلًا من طابور الصباح: طوابير لم تعلّمه الحريّة، بل أمعنت في تعليمه نقيضها. وطوال هذه الأشهر، كان البقاء على قيد الحياة أولويّة الأهالي، في ظلّ عدوان يتعمّد قتلهم، وقتل أسباب الحياة المادّيّة والمعنويّة ومقوّماتها.
عندما بدأت مشاهد النزوح والهجرة التي رافقت مخيّلة الفلسطينيّ بالعودة من جديد، برز دور المجتمع المحلّيّ بشكل واضح. كانت بنية المجتمع الأصيلة لا تزال قائمة، وامتدّت بجناحيها لتحمي الفلسطينيّ في غزّة من الفناء. قدّم هذا المجتمع كلّ ما يملك، مدركًا أنّه الجدار الأخير أمام الانهيار. ومع كلّ مبادرة لتقديم العون، كانت الأسئلة تتزايد من دون أن يجد لها إجابات. فما الذي يدفع أمّة ما إلى الانتحار فلسفيًّا، كما تتساءل عبثيّة ألبير كامو؟ وما الذي يجعل أيّ ثقافة، مهما بلغ غناها وتنوّعها، تصنع أصنامًا خاصّة بها، كما تشير حنّة آرندت؟ وما الذي يجعل الهويّات قاتلة، كما يطرح أمين معلوف؟
تكمن الإجابة في اللحظة التي يتوقّف فيها العقل عن التساؤل، ويبدأ الخوف في بناء الجدران. إنّها الإجابة نفسها التي تجعل التعليم بلا جدوى، عندما يستند إلى معارف مستوردة من الخارج، منفصلة عن السياق المحلّيّ، ولا تعترف بالمتعلّم ومعرفته الفريدة جزءًا أساسيًّا من العمليّة التعليميّة، وعندما يصبح التعليم بلا تفاعل حقيقيّ، وتُقدّم الأفكار والرؤى جاهزة ومغلّفة، فيتحوّل المتعلّم إلى متلقٍّ في مرتبة أدنى، وتصبح الإجابات الجاهزة هي الطريق الوحيد، ما يجعل الوعي بالواقع بعيد المنال، يخلق إنسانًا ومجتمعًا عاجزَين، قانعين، وغير حُرّين.
فما التغيير الذي أحدثته الإبادة في سياق غزّة على المجتمع؟ وكيف وضعت الحرب النظام التقليديّ للتعليم عند مفترق طرق، بات معه المتعلّم في غزّة مضطرًّا إلى الحياد عنه؟
سيزيف الغزّيّ
هل أدّت الحروب المتكرّرة إلى سيطرة عقدة سيزيف؟ تقول الأسطورة إنّ الآلهة حكمت عليه بحمل صخرة عظيمة إلى قمّة جبل شاهق، وعند بلوغه القمّة، تتدحرج الصخرة مجدّدًا إلى الأسفل، ليعود في كلّ مرة إلى حملها من جديد. هل هناك سيزيف غزّيّ جديد أغضب الآلهة أيضًا؟
هذا هو الشعور الذي سيطر على الغزّيّين، وعلى التربويّين منهم، من معلّمين وفاعلين ومكتبيّين، إذ وجدوا أنفسهم أمام معاناة لا تنتهي، وكأنّ كلّ بناء ينجزونه عليهم أن يعيدوا بناءه في كلّ مرّة، ولكن من نقطة أدنى على جبلٍ لا ينتهي من الهموم. تعبّر أسطورة سيزيف عن عبثيّة الحياة التي يعيشها الإنسان، حيث لا شيء أقسى من العمل بلا جدوى، ولا أشدّ وطأة من اضطرار الغزّيّين إلى البدء من جديد، مرّة تلو الأخرى، من دون أمل في الوصول إلى النهاية.
جاءت استجابة المجتمع، على رغم كلّ الأسئلة التي ظلّت بلا إجابات، والإيمان الذي تخلخل في كلّ ما هو مألوف، لتعبّر عن شعور الغزّيّ بضرورة البحث عن طرق جديدة، للتحرّر والانعتاق من قيود الماضي، ومعتقدات باتت محلّ شكّ وريبة. كانت هذه الاستجابة نتاجًا لأسئلة كبرى تكوّنت لأنّ شيئًا ما قد تهدّم، ولأنّ الطريق نحو أن نصبح شعبًا حقيقيًّا يسلكه الغزّيّ من أصعب مساراته.
عندما تحوّل الأطفال إلى هياكل عظميّة بفعل الجوع، وتجمّدت الدماء في أطراف الرضّع بفعل البرد؛ وعندما هاجمت الكلاب المسعورة الجدّات اللاتي كُنّ مصدر الأمان، والخيط الذي يربطنا بماضينا وعودتنا، وصرن عاجزات هاربات من المصير نفسه؛ وعندما أصابت رصاصة طائرة مسيّرة الأمّ في رأسها، وتحدّثت الطائرة نفسها بصوت آليّ، تطلب من ابنتها وباقي أفراد العائلة أن يمضوا من دون أن يلتفتوا أو يحاولوا إنقاذها؛ في تلك اللحظات، تكون الأسئلة صعبة حتمًا، ولا مجال لمنطقة راحة أو شعور بالأمان. كما لا إجابة عن أيّ سؤال، وأنت تبيت ولا تعرف إن كان سقف البيت أو الخيمة سيصمد فوق رأسك ورأس من تحبّ، أم أنّه سينهار في أيّ لحظة.
معاني الإبادة
تقسو حرب الإبادة المستمرّة على غزّة، بتاريخها وحاضرها، في ظلّ وضع يمكن وصفه بالكارثيّ منذ الأيّام الأولى والشهر الأوّل. نعجز عن إيجاد وصف لغويّ قادر على رسم صورة الواقع المؤلم. يقضي أهالي غزّة شتاءهم الثاني في خيام لا تحميهم، ولا تحمي أطفالهم من المطر أو القذائف التي تنهمر فوق رؤوسهم، من دون توقّف، منذ خمسة عشر شهرًا، في بثّ مباشر أمام الكاميرات.
تُنسف المدينة، وتُمسح بتاريخها وحاضرها، ببنيانها وتركيبتها. تُهدم البيوت فوق رؤوس من تبقّى من ساكنيها، تُرمى القذائف فوق رؤوس أطفال صغيرة، كان من المفترض أن تعيش الربيع، وتنمو في ظلّ عائلاتها. يعجز الآباء عن حماية أطفالهم، ويتملّكهم العجز، وتسيطر عليهم الوحشة التي خلّفتها الحرب وغلبها اليأس، يختنق الصوت في الصدور. يؤثر الكثيرون الصمت، ويختارون الموت البطيء بفعل القهر والحزن. يجرّب البعض الكتابة، موجّهين النصوص والرسائل إلى أنفسهم، لإيمانهم بأنّ أحدًا لن يقرأ مأساتهم. تُكتب كلّ يوم نصوص كثيرة، يختار أصحابها أن يخاطب كلّ منهم نفسه على الأقل. ينتشر الشعور بالخذلان بين الخيام، يمتلئ الصمت الناتج عن إناء فارغ ليس فيه إلّا الحزن، يعيش فيه الآباء والأمّهات وحدهم، ويبات أطفالهم جوعى. يتنافس البعض على توفير لقمة العيش، فتنتج عن ذلك ظواهر اجتماعيّة لم تكن موجودة في الماضي، لكنّه الإحباط الشديد الذي يولّد الفوضى. يبدأ النسيج الاجتماعيّ بالتفكّك، وتبدأ الأبواب والأذرع التي كانت مفتوحة بالتهالك والتعب، فلم تعد تقوى على ممارسة دورها في احتضان الآخرين. لم تعد ذراعا الإنسان قادرة حتّى على احتضانه نفسه، ولم تعد تكفيه لدرء الحزن والبرد عن قلوب أطفاله الذين سرقهم البرد والوحشة.
تنظر على امتداد الأفق، فتشاهد اللون الأبيض على مدّ البصر. يختلط أبيض الأكفان بأبيض الخيام المهترئة، وتُسمع أصوات الابتهال والشكوى التي لا تصل، تحجبها الطائرات عن السماء. تصطاد الطائرات السكينة، وتحرق نيران الموت الخيام. تركض الأمّهات بحثًا عن أطفالهنّ بين النيران، ينقذن من استطعن، ويفشلن في إنقاذ البقيّة الذين يموتون حرقًا في قماش الخيام التي تأكلها النيران.
تتحرّك الأيادي من دون أن تبصر، تبحث عن الأحبّة وقد أصابها العمى، وفقأت نيران القصف واليأس عيونها. يعيش مليونا إنسان في مساحة لا تتجاوز العشرة بالمئة من مساحة غزّة، بلا بنية تحتيّة. تتولّد فيروسات شلل الأطفال في المياه العادمة التي لا مجال لتصريفها، بينما يدّعي العدوّ أنّها منطقة إنسانيّة. لا مكان ليهرب إليه الأطفال من الأمراض وسوء التغذية الشديد.
تستبدل الطفولة أحلامها وخيالاتها بمعارف جديدة تغلب عليها القسوة. يُستبدل المطبخ الدافئ والطعام الذي تحضّره الأمّ في بيتها، بأجواء البرد في التكيّة، حيث يتسابق الأطفال حاملين أواني غير صالحة، بعيون ملوّنة ومفتوحة، يحاولون أن يعودوا إلى عائلاتهم ببعض الطعام إن استطاعوا، بعد وقوف طويل في طابور يهين طفولتهم وإنسانيّتهم. يحدث ذلك بعد الوقوف ساعات في طابور المياه الصالحة للشرب في أيّام الشتاء الباردة، من غير ملابس تحميهم، وبأحذية مهترئة بالكاد تعينهم على المشي.
يشاهد الآباء أطفالهم يكبرون بلا معنى واضح لحياتهم، بعيدًا عن حقيبة المدرسة، وغرفة الألعاب التي تركوها في بيتهم الذي قضمته الجرافات، ورأوا صورته على التلفاز في نشرة أخبار، أو في مقطع بثّه الجنود محتفلين بتفجيره، إهداء لعيد ميلاد طفل آخر، يشاهد والده يقضي على حياة أطفال آخرين. يتواصل العبث، واللا معنى، واللا جدوى من دون نهاية واضحة.
تغلق المعابر والمنافذ حتّى أمام احتماليّة الهروب من الموت. يخلق آخرون من طفولة ضائعة أسطورة طفولة منعدمة الخيارات. يموت الكبار في التزاحم على طابور الخبز، لأنّ الاحتلال يمنع حتّى الدقيق من الدخول. يصطفّ أطفال آخرون في سوق المدينة الذي يشبه لعبة الموت، تدور فيه الأيّام بلا معنى. يقف الأطفال في السوق ليبيعوا المعلّبات، وبعض الفواكه المجفّفة التي وصلت في صناديق مساعدات منتهية الصلاحيّة، رمت بها الطائرات، وقتلت بعضًا من أصدقائهم.
يبيع الأطفال ويتعلّمون القسوة بدلًا من المحبّة. يتعلّمون الحساب ببقايا عملات حديديّة أصبحت غير صالحة للتداول، في ظلّ استهلاكها وعدم السماح بدخول أيّ نقد أو تداول طبيعيّ. تضطرّهم الحياة إلى التعامل مع قيم مختلفة، ناتجة عن تعقيدات التضخّم والعمولات التي يحصل عليها التجّار وقطّاع الطرق. لا تكفيهم هذه العملات التي يعودون بها لشراء الحلوى وبعض المعلّبات.
يتعلّم الأطفال أنواع الطائرات التي يرونها في السماء، ويعرفون الصفة والموصوف والتمييز والمبتدأ والخبر، من أمثلة تقتلهم بدلًا من أن تعلّمهم الخيال.
الجذر والأصل في مواجهة الإبادة
في بداية العدوان، استند المجتمع الفلسطينيّ في غزّة إلى تركيبة أصيلة، في ظلّ انهيار جميع المنظومات الرسميّة، وتدمير الاحتلال للمرافق والمباني والهيئات. ومع انقطاع أيّ دعم حقيقيّ من خارج غزّة، سوى بعض المساعدات التي تهين كرامة الإنسان، والتي يتحكّم بها الاحتلال بشكل كامل، في ظلّ إغلاق المعابر التجاريّة، وتدمير الأراضي الزراعيّة والسيطرة عليها، وانعدام أيّ قدرة للإنتاج الذي يكفي حاجة الناس، ومغادرة الغزّيّين منازلهم بفعل أوامر الإخلاء، والتدمير الوحشيّ لبيوتهم وممتلكاتهم والبنية التحتيّة، وانعدام أيّ وسيلة للمواصلات، وخروج سكّان الشمال والجنوب عبر حواجز التفتيش والاعتقال والمهانة باتّجاه مناطق الوسط، لم يكن ممكنًا البقاء والحياة كلّ هذه المدّة، من دون أن يستند الفلسطينيّ المتعب على أخيه وجاره. فتحت الناس بيوتها، وتقاسمت كلّ ما تملك مع من تعرفه ومن لا تعرفه من النازحين. ظهرت مبادرات مجتمعيّة مبنيّة على قيم متأصّلة في المجتمع، حمته من الانهيار الكامل. كان التعاضد المجتمعيّ الأصيل نقطة ضوء وحيدة في ظلّ عتمة الحرب، بينما كانت أخبار العنف، وأشلاء الأطفال الممزّقة التي تنقلها وسائل الإعلام، لا تحوّل هذا الشعور بالتعاطف إلى قوّة دافعة ومؤثّرة لوقف الموت. ومع ذلك، لم يتوقّف المجتمع عن تقديم كلّ ما يملك. لم يعد أيّ شخص يعيش في منزله بشكل طبيعيّ، إمّا لأنّ منزله قُصف وجُرّف في غزّة والشمال ورفح، أو لأنّه يشارك منزله مع العشرات في مناطق الوسط، ما يمنع أيّ حياة طبيعيّة للجميع.
لم تكن البيوت المفتوحة، ومشاركة الممتلكات، وتقاسم الطعام، وأحضان المواساة هي المشهد الوحيد؛ فقد برزت المبادرات المجتمعيّة على يد مبادرين حقيقيّين، أضفوا على مفهوم المبادرات والمجتمعيّة بعدًا جديدًا، منحها شيئًا من القداسة. فقد جاءت هذه المبادرات، بفكرتها ورغبتها الصادقة في المساهمة، متحدّية كلّ ما سبق من مآسٍ، لتشكّل تجربة تعليميّة مجتمعيّة وشعبيّة حقيقيّة، تتجاوز عباءة التعليم الرسميّ وغير الرسميّ، لتصل إلى الأطفال الأكثر معاناة وتأثّرًا بحرب الإبادة.
لم تكن المناهج التقليديّة شرطًا ضروريًّا للبدء، إذ لم يعد يسمح الوقت باللحاق بخطط الوزارات، كما أنّ المدارس لم تعد قائمة بوظيفتها المعتادة؛ فهي إمّا تحوّلت إلى مأوى للأطفال وعائلاتهم، أو تعرّضت للهدم والتدمير. في ظلّ هذه الظروف، تغيّر دور المدرسة ليصبح مختلفًا تمامًا؛ فلم تعد هناك جدران تفصل الأطفال عن عالمهم الخارجيّ، ولا صفوف مثل غرف السجون، ولا تعليم "بنكيّ" يتعامل معهم باعتبارهم أرقامًا، أو بيضًا يُنتج في فقّاسات الدجاج، كما وصفها كلّ من باولو فريري ومنير فاشة في أمثلة تصف العمليّة التعليميّة السابقة.
قدّمت المبادرات والتعليم في خيمة بيضاء مثلّثة الشكل، فرصة ليكون التعليم تحرّريًّا وانعتاقيًّا، فتخلّت المدرسة عن طابور الصباح، وتحيّة العلم، والنمط التقليديّ لدور المعلّم. أصبح المعلّم شريكًا للطفل، وابنًا للبيئة ذاتها التي خلّفتها الإبادة. كان عنوان الدرس الأوّل هو الرفض؛ رفض الخيمة مصيرًا يتكرّر، وكان هذا الفعل في حدّ ذاته ممارسة حقيقيّة للحرّيّة، واستمراره تجسيدًا عمليًّا للأمل. تحرّر التعبير، وتحرّرت الأسئلة من القيود، بينما غابت جميع الإجابات، المطلقة منها والبسيطة.
سيُسجّل في تاريخ الإبادة حين يُكتب، وفي تجربة التعليم في غزّة حين تُروى، أنّ المبادرين المجتمعيّين كانوا أوّل من بحث عن الأمل ووجدوه، ومعه انطلقت العمليّة التعليميّة من جديد في قطاع غزّة. انطلقت المبادرة من الشباب، ولحقت بهم المؤسّسات والوزارات ومنظّمات الأمم المتّحدة. ما كان يُعتبر مستحيلًا أصبح واقعًا بفعلهم. كانت التقاطة الأمل على يد الشباب لحظة تأسيس لزمن جديد، ومرحلة تعيد مع الوقت صياغة المفاهيم وتشكيلها، بناءً على أنّ الفرضيّات التي قامت عليها النظريّات السابقة ودوافع المفكّرين المعروفين، لم تعد كافية لتفسير الواقع اليوم، وأنّ فهم الحقيقة الحاليّة يتطلّب نهجًا مختلفًا. لم تكن هذه المبادرة سوى نتيجة طبيعيّة لمجتمع فلسطينيّ أصيل، حمى نفسه بنفسه من الفناء، ومدّ يده لنفسه، وتفوّق على أقصى التصوّرات والآمال، مسخّرًا العمل المجتمعيّ لتعزيز الترابط والنسيج المجتمعيّ الفلسطينيّ. ولولا تكوين المجتمع الأصيل المستند إلى قيم أصيلة، لأفنته الإبادة.
من الخطأ الحكم على ما يحدث الآن في ما يتعلّق بالتعليم، أو محاولة تضنيفه، لكن يبدو واضحًا أنّ مفهوم التحرّر بات يبحث عن ثوب جديد يناسب سياق غزّة. من الضروريّ إعادة التفكير في التعليم من منظور جديد يبقيه مجتمعيًّا. فكما احتضن المجتمع المبادرات، وانتشرت المساحات التعليميّة من دون إطار واضح أو تصنيف، وكما تشارك الطفل والمعلّم والأهالي في العمليّة التعليميّة من منطلق الحاجة إلى النهوض، في ظلّ واقع فرضه اليأس، وكما أنّ أحد أهم تعريفات التنوير هو الخوض في العتمة قبل الوصول إلى النور، فقد مرّت هذه المبادرات بمخاضها الخاصّ، بدءًا من واقع فقدت فيه كلّ الإمكانات، إلى واقع تحرّكه الرغبة التي تُعرّف بأنّها جوهر الفلسفة، بخلاف المعرفة الجاهزة التي تجعل الإنسان في حالة سكينة عاجزة. دفعت هذه الرغبة نحو الفعل وإعادة تعريف الأولويّات، فتجلّى ذلك في سعي الناس إلى التعليم، واعتبروها ضالّتهم التي تحميهم من المجهول الذي خلّفته الحرب.
جاءت المبادرة باتّجاه التعليم باعتباره أوّل مظهر للبناء وسط الخراب، وكأنّ استعادته ستمكّن الأهالي من حماية أطفالهم، والبحث عن إجابات لامتلاك المستقبل. ويبقى الأمل أن تؤدّي هذه التشاركيّة التي فرضها الظرف، إلى استدامة العمليّة التعليميّة برؤيتها المجتمعيّة ونهجها الجديد.

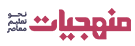


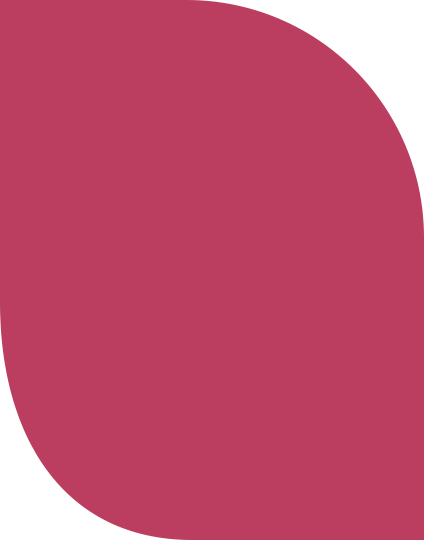

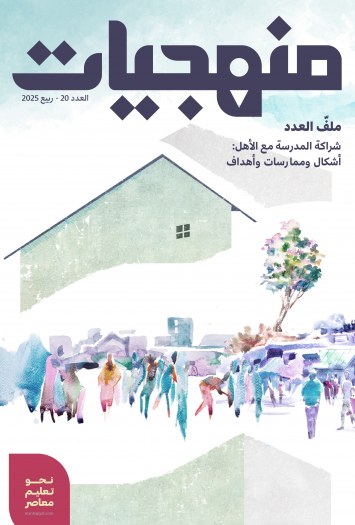






 نشر في عدد (20) ربيع 2025
نشر في عدد (20) ربيع 2025 

