ورقة قُدّمت في المنتدى السنويّ لفلسطين- 2025، والتي نظّمها المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات ومؤسّسة الدراسات الفلسطينيّة، في جلسة نظّمتها مجلّة منهجيّات، بعنوان "التعليم في غزّة منذ السابع من أكتوبر: إبادة تعليميّة ومعجزة الصمود". الدوحة 26 كانون الثاني/ يناير، 2025.
شموع غزّة الأولى:
في حرب الإبادة الجماعيّة التي يشهدها قطاع غزّة، تبدّلت حياة المعلّم؛ ترك بيته وكلّ ما يملك خلفه باحثًا عن النجاة، نازحًا ومهجّرًا قسرًا، حاله حال بقيّة عائلات الشعب الفلسطينيّ.
وسط الظلام الدامس، بادر ثلاثة معلّمين في الشهرين الأوّلين من الحرب، إلى إشعال نور ثلاث شموع. كان المعلّم محمّد العنّابي، والمعلّمة أسماء مصطفى، والمعلّم محمّد الخضري، يقيمون جلساتهم التعليميّة، وينفّذون الأنشطة التعليميّة مع من حولهم من الأطفال، متمرّدين بذلك على الظلم والطغيان، ومؤمنين بقوله صلى اللّه عليه وسلم: "إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن يغرسها فليفعل".
أذكر أنّني في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، كنت أتوسّط الأطفال في جلستي التعليميّة الأولى، داخل مكتبة إحدى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين (الأونروا)، بعد أن أصبحَت مكانًا أقيم فيه مع عائلتي، إثر نزوحنا الثالث في أقلّ من شهر. انطلقت في هذه المبادرة إلى جانب زميلَيّ، الأستاذ محمّد العنّابي والأستاذ محمّد الخضري، فكنّا نقيم جلسات تعليميّة للأطفال في مراكز الإيواء التابعة لوكالة الغوث. وثّقنا هذه الجلسات بروح الأمل والتفاؤل، ونشرناها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، حاملين مطلبنا العادل بممارسة المهنة التي نحبّ وننتمي إليها بشغف. رفعنا صوتنا عاليًا للمطالبة بحقوق الأطفال، مؤكّدين على ضرورة منحهم حقّهم في التعليم مثل بقيّة أطفال العالم.
قمت بتوثيق جلستي التعليميّة الأولى بخجل عميق أمام دماء الشهداء وصرخات الثكالى، واكتفيت بصورة واحدة، نشرتها على صفحاتي الشخصيّة على مواقع التواصل الاجتماعيّ. وفي اليوم التالي وجدت نفسي أستضيف ثلاث وكالات أنباء محلّيّة ودوليّة، باللغتين العربيّة والإنجليزيّة، إذ نشرت هذه الوكالات الخبر مصوّرًا عبر قنواتها الرسميّة. بقيت لأكثر من عام أتحدّث عن الإبادة عبر وسائل الإعلام الدوليّة والمحلّيّة، كتابةً وصوتًا وصورة، بأمل وشغف بالغين، وما زلت أرفع صوتي عاليًا، مطالبةً من يستطيع من زملائي بالنهوض والعمل مع مجموعات الأطفال من حولهم، والاستثمار في أوقاتنا وأوقاتهم، في محاولة دعمهم نفسيًّا ومعنويًّا، ولو بأبسط الإمكانيّات المتاحة.
استطعنا من خلال وسائل الإعلام أن ننقل الرسالة ونؤدّي الأمانة، في اللحظات الأكثر حرجًا وصعوبة في تاريخ الإبادة الجماعيّة والنكبة الفلسطينيّة على الإطلاق. استطعنا استنهاض الهمم واستنفار العزائم البنّاءة لدى زملاء المهنة. كنت أبكي فرحًا عندما يتواصلون معي، مستفسرين عن بداية الطريق، وعن الأدوات التي يمكن أن يستخدموها، أو عن المكتبات التي يمكنهم شراء ما يلزم الأطفال منها. كنت أجيبهم قائلة: "اجمعوا الأطفال في دائرة، واحكوا لهم حكايات هادفة، والعبوا معهم بعض الألعاب البسيطة التي تخفّف عنهم وطأة هذا الوقت العصيب. استمعوا إليهم، واخلقوا مجتمعًا متعاونًا من حولكم، فهذا أضعف الإيمان، إلى حين أن ننجو أو نستشهد واحدًا تلو الآخر".
بدأنا ثلاثة معلّمين مبادرين، ثمّ أصبحنا عشرة، ومع مرور الوقت صار العشرة عشرين، ثمّ مئة، ثمّ مئتين، ثمّ ألفًا، ثمّ آلافًا. آلاف الشموع المضاءة أنارت طريق العلم، لتقول إنّنا شعب حرّ، يؤمن بحقّه في التعليم والتعلّم حتّى الرمق الأخير. آلاف الأصوات ارتفعت مطالبةً بحقّ الطفل الفلسطينيّ في العودة إلى مقاعد الدراسة.
انتقلت العدوى الإيجابيّة إلى مخيّمات النزوح، فبات المعلم رمزًا للنضال، يقف شامخًا بين خيام النازحين، محاطًا بالأطفال، متماسكًا أو محاولًا التماسك، مؤمنًا برسالته السامية. ودّع المعلّم الفلسطينيّ زمن السبّورة والطبشورة، ليعيش زمن الشموخ والثبات على الفكرة والمبدأ، يخوض تجربة تعليميّة غير مسبوقة في العالم بأسره، عُرفت بـ "التعليم الشعبيّ – التعليم بلا مدارس"، والتي وثّقتها وكالات الأنباء من مختلف أنحاء العالم وبمختلف اللغات، لتروي قصص المعلّمين الملهمين في قطاع غزّة.
نجح هؤلاء المعلّمون في إعادة الأمل والحياة إلى من حولهم، في جلسات تعليميّة بسيطة تُعقد يوميًّا لمن نجا من الأطفال. تراهم يمارسون المهنة بشغف على رمال الصحراء في أقصى جنوب رفح، على الحدود بين غزّة ومصر الشقيقة، تارةً، وداخل الخيمة أو أمامها عندما لا تتوفّر الأماكن تارةً أخرى، وعلى أنقاض المنازل المدمّرة، أو في الأراضي الزراعيّة، أو داخل خيام النازحين، وحتّى في البيوت التي ما تزال قائمة.
بل واستطاع العديد من المعلّمين المبادرين إنشاء خيام تعليميّة خاصّة، خُطّت أسماؤها بحروف من دماء القلب، مثل "خيمة الأمل التعليميّة"، و"مدرسة البيت الدافئ". كتبوا قصصًا بطوليّة، تُروى وتُسجّل في تاريخ النضال الفلسطينيّ المتجذّر.
على إثر ذلك، وخلال وقت قصير، استجابت لصوت المعلّم الفلسطينيّ جميع مؤسّسات التعليم المجتمعيّ والمؤسّسات الدوليّة، المعنيّة بالتعليم والإغاثة وحقوق الطفل، على رأسها اليونيسيف، ومؤسّسة عبد المحسن القطّان، ومؤسّسة تامر للتعليم المجتمعيّ، ومؤسّسة معًا، ومركز إبداع المعلّم، ومؤسّسة الثقافة والفكر الحرّ، والنيزك، وغيرها الكثير. بدأت هذه المؤسّسات بالتحرّك بشكل فاعل في هذا المضمار، فقدّمت الدعم للمعلّم المبادر، وأسهمت في إشراك عدد أكبر من المعلّمين في تقديم الخدمة التعليميّة، دعمًا للأطفال في مواجهة الظروف الصعبة.
المحتوى التعليميّ زمن الإبادة
يُحدّد موعد الجلسة التعليميّة بالاتّفاق بين المعلّم وطلّابه، مع مرونة تامّة تراعي الظروف المعيشيّة للأطفال. فغالبًا ما يشارك الأطفال عائلاتهم في تأمين احتياجات أسرهم النازحة الأساسيّة، سواء في مراكز الإيواء أو مخيّمات النزوح. تبدأ الجلسة دائمًا بتفقّد المعلّم أصدقاءَه الصغار، فنحن لا نزال نعيش تحت نيران الإبادة الجماعيّة حتّى هذه اللحظة.
ليس الحضور عاديًّا في ظلّ هذه الظروف؛ فعندما يأتي الطالب محمّد متأخّرًا، سيعني لي هذا أنّه "حيٌّ يُرزق". هذا التأخير يصبح شاهدًا على الحياة وسط الموت، ودليلًا على استمرار الأمل على رغم المآسي.
يلي تفقّد المعلّم طلّابه فقرة التفريغ الانفعاليّ، وهي نشاط يوميّ أساسيّ، نظرًا إلى تعرّض الأطفال المستمرّ للمؤثّرات النفسيّة الصادمة، فوقت الصدمة مستمرّ باستمرار الحرب.
ينتقل المعلّم بعد ذلك إلى منح الأطفال مساحة كافية للتحدّث عن تجاربهم الشخصيّة، وما يجول في خواطرهم، وهو أمر من شأنه أن يسهم في تفريغ الطاقة السلبيّة في دواخلهم. يشرك المعلّم الأطفال في الحوار، معزّزًا المهارات اللغويّة ومهارات الاتّصال والتواصل لديهم.
ينتقل المعلّم إلى تقديم درسه بطريقة غير تقليديّة، تتنوّع بين استخدام الدراما، أو توظيف أسلوب "عباءة الخبير"، ما يعزّز لدى المتعلّمين مهارات التفكير النقديّ، ويكسبهم القدرة على حلّ المشكلات. يمكن أن يأتي الدرس على شكل حكاية أو قصّة ذات مغزى عميق، أو قصّة مسلّية تدخل البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال. كما يمكن أن يُقدّم على شكل لعبة تربويّة يتعلّم منها الطفل ما لا تقدّمه المدارس النظاميّة في إطارها التقليديّ. تشمل هذه الأنشطة تعليم المهارات الأساسيّة، مثل القراءة والكتابة والحساب في مستواه التأسيسيّ، ومهارات كتابة الحروف والكلمات وقراءتها باللغة الإنجليزيّة. كما قد يطلب المعلّم من المتعلّمين الصغار أن يحفظوا سورة من القرآن كلّ أسبوع، ويقوم بتسميعها لهم في يوم محدّد، يُتّفق عليه مسبقًا مع المتعلّمين وذويهم.
أهمّ ما يكتسبه الطفل في هذه الجلسات يمكن تلخيصه في "المهارات الحياتيّة الأساسيّة التي يحتاج إليها". يتعلّم الطفل بالمناقشة والحوار، وبصفته متعلّمًا في هذه الحياة، أن يجد حلولًا للمشكلات اليوميّة التي يواجهها في ظلّ ظروفه الصعبة، بالتعاون مع رفاقه في الخيمة التعليميّة، أو جيرانه في مخيّم نزوحه الجديد، أو مركز الإيواء. في مدرسة الحياة، يكتسب القدرة على تكوين صداقات جديدة، والتعايش مع الظروف، ومدّ يد العون للآخرين عندما يستطيع. كما يتعلّم من واقع التجارب والخبرات التي عاشها قسرًا، أن يكون فردًا مبادرًا في مجتمعه، محبًّا للخير، متسامحًا، مقبلًا على الحياة، وقادرًا على صنع التغيير المنشود.
أدوار المعلّم زمن الإبادة
أدّى المعلم الغزّيّ، في ظلّ الأزمة الإنسانيّة المتفاقمة، أدوارًا متعدّدة، مرابطًا على كلّ ثغور الوطن. وقد أثقل ذلك كاهله، وزاد من حجم مسؤوليّته تجاه أبناء مجتمعه، من أطفال وكبار وشيوخ، لا سيّما في ظلّ غياب دور النظام التعليم الرسميّ الفلسطينيّ.
أصبح المعلّم بين ليلة وضحاها مسعفًا تعليميًّا أوّليًّا، مستجيبًا للظروف القاهرة التي فرضت عليه أن يجتهد لإنقاذ الموقف. نراه مسعفًا لعقل الطفل وقلبه وروحه، منقذًا له في حالة غير مسبوقة وظرف استثنائيّ. يجتهد في انتقاء القصص الهادفة ليرويها باحتراف أمام الأطفال، مبتكرًا أساليب تربويّة غير مسبوقة لحلّ المشكلات بتأديته دور الحكواتيّ. كما يقوم بدور المعلّم المرشد النفسيّ للطفل ومن حوله في محيط النزوح، ودور الواعظ الناصح الأمين لتلاميذه، بتوعيتهم بما يدور حولهم. بات المعلّم الأمل الأخير في الحفاظ على الموروث الثقافيّ والهويّة الوطنيّة، بما يقوم به مع الأطفال من أنشطة تعليميّة. كما بات مصلحًا اجتماعيًّا، مهتمًّا بقضايا المجتمع الجديد، مشاركًا وجهاء مجتمعه في مخيّمات النزوح ومراكز الإيواء، لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجههم. وإلى جانب ذلك كلّه، يعمل المعلّم على احتواء الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصّة، ودمجهم في المجتمع الجديد. وتجدر الإشارة إلى أنّ العديد من المعلّمين تلقّوا تدريبات في "لغة الإشارة"، من أجل تيسير التواصل مع الأطفال ذوي الإعاقة السمعيّة.
وأضيف إلى دور المعلّم أيضًا انخراطه في جلسات تثقيفيّة لذوي الأطفال بين حين وآخر، حيث يصبح "اختصاصيًّا نفسيًّا واجتماعيًّا"، مساهمًا بذلك في الاستجابة الطارئة لبرامج الدعم النفسيّ لفئات المجتمع المختلفة، من نساء وأطفال وشيوخ.
أصبح المعلّم المبادر المنخرط في أنشطة التعليم الشعبيّ المختلفة مدرّبًا، ناقلًا تجربته للمقبلين على التجربة من زملاء المهنة. يوثّق عمله بالصوت والصورة والحرف والكلمة، مخاطبًا المنابر التربويّة في الداخل والخارج، ومتحدّثًا عن تجربته في ورش العمل والمؤتمرات الكبرى التي يُدعى إليها من بلدان متنوّعة.
يضاف إلى رصيد المعلّم الغزّيّ المبادر مهمّة "التأريخ"، فبات كاتبًا للتاريخ بوصفه لما حدث، ويحدث معه ومع من حوله. يروي حكايات المعلّمين والأطفال الشهداء والجرحى والمفقودين والناجين، ليصبح بذلك مترجمًا وكاتبًا وراويًا لرواية الإبادة الجماعيّة والإبادة المعرفيّة على حدّ سواء.
بات المعلّم سفيرًا لقومه عبر وكالات الأنباء المرئيّة والمسموعة والمكتوبة، موثّقًا أحداث الإبادة المعرفيّة، ومعزّزًا الرواية الفلسطينيّة، ومساهمّا في حشد الدعم الشعبيّ العالميّ للقضيّة الفلسطينيّة، في ظلّ ما يحدث في غزّة منذ السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر إلى الآن.
التحدّيات التي تواجه المعلّمين المبادرين زمن الإبادة
يواجه المعلّمون المبادرون المنفّذون للأنشطة التعليميّة في قطاع غزّة تحدّيات كبيرة، تحول دون استكمال تنفيذ الأنشطة التعليميّة أحيانًا، بل وتُحدث شللًا في تنفيذها في أحيان أخرى. على رأس هذه التحدّيات مشكلة عدم الشعور بالأمان، والذي لن يتحقّق إلّا بوقف الحرب على غزّة، حيث تُقام الجلسات التعليميّة تحت أزيز الطيران الحربيّ، وأصوات الانفجارات التي تحيط بنا من كلّ مكان، وفي ظلّ استهداف الاحتلال المستمرّ لمراكز الإيواء ومخيّمات النزوح بشكل شبه يوميّ، إضافة إلى مشكلة النزوح المتكرّر للعائلات، إذ يجبرون على مغادرة أماكنهم، والانتقال فورًا إلى أماكن أخرى، ما يعوق استكمال الأنشطة التي بدؤوها، ويعطّل العمل الذي استغرق وقتًا وجهدًا كبيرَين.
علاوة على ذلك، يواجه أهل قطاع غزّة تفاقمًا في الوضع الصحّيّ، إذ تزداد الأمراض والأوبئة الفتّاكة والأمراض الجلديّة، بفعل انتشار الفيروسات، والافتقار إلى مقوّمات الحياة الصحّيّة، بالإضافة إلى شحّ موادّ التنظيف الأساسيّة في الأسواق، ما يسبّب شللًا في القدرة على استكمال الأنشطة التعليميّة في بعض الأماكن، تحسّبًا لخطر انتشار الأوبئة. يُضاف إلى ذلك كلّه غياب دور النظام التعليميّ الفلسطينيّ الرسميّ لمدّة عام كامل.
يزداد الأمر صعوبة على المعلّمين الذين يعملون داخل الخيام، وبأقلّ الإمكانيّات، إذ يعجز المعلّم المبادر عن توفير ما يلزمه للقيام بعمله الخيريّ، من قرطاسيّة، وكتب ومطبوعات تعليميّة، ووسائل تعليميّة أساسيّة، يصعب جدًّا الحصول عليها، وإذا وجدت، فإنّ أسعارها تتجاوز خمسة أضعاف قيمتها الحقيقيّة.
ما يزيد الأمر تعقيدًا ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم من التوجّه نحو نمط التعليم الإلكترونيّ في غزّة، للالتحاق بالفصول الافتراضيّة التي كانت الوزارة قد أنشأتها في رام اللّه. ففي ظلّ انعدام قدرة الأسر الفلسطينيّة على توفير أجهزة ذكيّة لأبنائها، وصعوبة الحصول على إنترنت سريع، تواجه هذه الأسر تحدّيات كبيرة، مثل عدم قدرتها على دفع تكاليف شحن الهواتف في نقاط الشحن بالطاقة الشمسيّة المدفوعة الأجر، وتكاليف الإنترنت المدفوعة، والاضطرار إلى الانتقال إلى أماكن بعيدة عن المخيّمات، مثل "مقاهي الإنترنت"، ما يعرّض حياتهم وحياة أطفالهم إلى الخطر. تزيد هذه التحدّيات من صعوبة الوضع على العائلات، فضلًا عن عجزهم عن تأمين قرطاسيّة تعليميّة لأبنائهم في زمن الإبادة والمجاعة، بعد أن أصبح تأمين أبسط احتياجات الحياة، مثل الطعام والماء، أمرًا في غاية الصعوبة.
وعلى رغم ذلك كلّه، تمكّنّا، نحن المعلّمون المبادرون، من أن نكون صوت الحرف والقلم النابض، المطالب أمام العالم أجمع بحقّ الطفل الفلسطينيّ في العودة إلى مقاعد الدراسة. أرسلنا رسالتنا السامية حول ضرورة الالتفاف حولنا، نحن المعلّمون المبادرون الذين رفعنا شعار "سنبقى المعلّمين الرساليّين ما دمنا على قيد الحياة". نعم للتعليم ولو في مراكز الإيواء، وسط خيامنا في مخيّمات النزوح. نعم للتعليم ولو أغلقت كلّ المدارس أبوابها، سنكون نحن المدارس. نعم للتعليم ولو أُحرقت كلّ الكتب لإشعال نار الطهو، سنكون نحن الكتب. نعم للتعليم ولو على رمال الصحراء، ولو في المنفى، ولو فوق الركام والأنقاض، في الشوارع وعلى الأرصفة، سنكون نحن المنهاج والنهج ونحن الطريق والطريقة، سنكون نحن الأمل رغم الألم، آملين من المولى عزّ وجلّ فرجًا وعودة قريبة إلى دارنا وديارنا ومدارسنا.

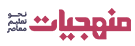


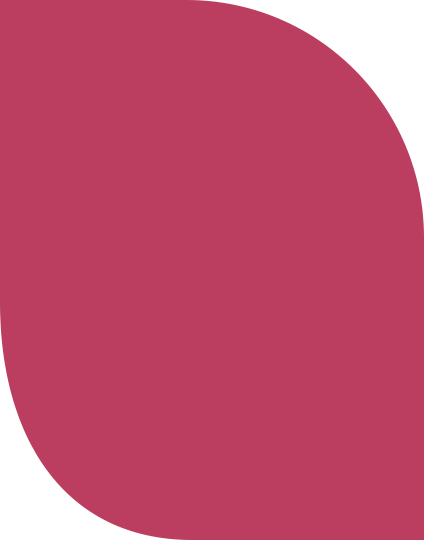

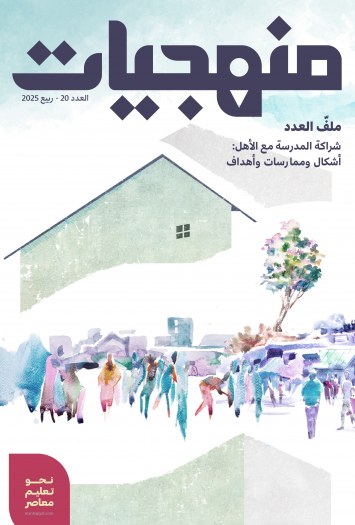






 نشر في عدد (20) ربيع 2025
نشر في عدد (20) ربيع 2025 

