ورقة قُدّمت في المنتدى السنويّ لفلسطين- 2025، والتي نظّمها المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات ومؤسّسة الدراسات الفلسطينيّة، في جلسة نظّمتها مجلّة منهجيّات، بعنوان "التعليم في غزّة منذ السابع من أكتوبر: إبادة تعليميّة ومعجزة الصمود". الدوحة 26 كانون الثاني/ يناير، 2025.
يتجذّر المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ في تاريخ طويل من التعاون والعمل التطوّعيّ، إذ يتجلّى ذلك في مفهوم محلّيّ يُعرف بـ"العَونة"، والذي يعكس تكاتف الأفراد لمساندة بعضهم البعض في شتّى جوانب الحياة. شكّل هذا المبدأ، في سياق سياسيّ واجتماعيّ معقّد، الأساس الذي قامت عليه العديد من المنظّمات والجمعيّات الأهليّة الفلسطينيّة.
برز دور مؤسّسات المجتمع المدنيّ عبر المراحل التاريخيّة المختلفة، منذ النكبة وحتّى اليوم، إذ وفّرت خدمات أساسيّة لم تكن متاحة للشعب الفلسطينيّ، مثل الإغاثة الصحّيّة والغذائيّة، والحماية الحقوقيّة من ممارسات الاحتلال القمعيّة، مثل الاعتقال الإداريّ، والمحاكم العسكريّة غير القانونيّة. كما شملت جهودها دعم الزراعة وحماية المزارعين، وتعزيز الثقافة والفنون، وتشجيع المشاريع الصغيرة، وتمكين المرأة وضمان حقوقها، إلى جانب توفير خدمات تعليميّة غير رسميّة.
انطلقت هذه المؤسّسات من نوًى شعبيّة ومبادرات قاعديّة في القرى والمخيّمات والمدن، لتتطوّر لاحقًا إلى مؤسّسات منظّمة تخضع لقوانين محلّيّة، تحصل على تمويلها من جهات متنوّعة.
مع تفاقم التحدّيات في ظلّ الوضع السياسيّ المتقلّب، واستمرار الاحتلال في ممارساته القمعيّة، تعاظم دور مؤسّسات المجتمع المدنيّ في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة، لتصبح في مواجهة تحدّيات استثنائيّة في مجالات متعدّدة. لم تقتصر جهود هذه المؤسّسات على توفير موادّ الإغاثة فحسب، مثل الغذاء والمأوى، بل بادرت إلى إطلاق مبادرات أكثر استدامة، مثل المشاريع الزراعيّة، والخدمات الطبّيّة الأوّليّة والثانويّة، ودعم المرأة اقتصاديًّا عبر المشاريع الصغيرة، وبرامج تطوير القدرات، بالإضافة إلى إنشاء المراكز التعليميّة غير الرسميّة، وبرامج الدعم النفسيّ والاجتماعيّ الموجّهة إلى الأطفال في سنّ المدرسة، واليافعين، وطلّاب الجامعات.
تنوّعت تخصّصات هذه المؤسّسات لتشمل التعليم المساند، وبرامج النشاطات اللامنهجيّة والرياضيّة والترفيهيّة، والعمل التطوّعيّ والكشفيّ، ما جعلها جزءًا أساسيًّا من منظومة الاستجابة الشاملة للمجتمع المدنيّ، لدورها المحوريّ في بناء قدرات الأجيال، وإعدادهم لمواجهة التحدّيات المستقبليّة.
يستعرض هذا المقال تطوّر دور المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ، في ظلّ الإبادة الجماعيّة والتعليميّة المستمرّة في غزّة، مع الإشارة إلى أنّ الإبادة المعرفيّة ليست جديدة، بل قائمة منذ بدء الاحتلال الإسرائيليّ. يركّز المقال على تقسيم مراحل الاستجابة للحرب في غزّة، وفقًا لإطار الاستجابة النفسيّة للصدمة والكوارث، بدءًا بمرحلة الصدمة، مرورًا بمرحلة ردّة الفعل أو الأزمة، ومرحلة التكيّف المبكّرة، ومرحلة ما بعد الصدمة، وصولًا إلى مرحلة التعافي. ومع ذلك، يوضّح المقال أنّ ما يجري في غزّة لا يتجاوز مرحلة التكيّف المبكّر، نظرًا إلى استمرار حرب الإبادة، ما يقتضي تقسيم مرحلة التكيّف إلى مرحلتين: التكيّف المبكّر والتكيّف المزمن.
يتناول المقال أيضًا كيفيّة الانتقال من مرحلة الصدمة على مستوى المؤسّسات، وطرح أسئلة مثل "ماذا يمكن أن نفعل؟ وهل لنا دور فعليّ؟"، إلى مرحلة الأزمة التي تركّز على توفير المساعدات الطارئة، مثل الغذاء والدواء والدعم النفسيّ، ثمّ إلى مرحلة التحرّك نحو مرحلة التكيّف المبكّر، إذ تُنظّم الجهود الفرديّة لتوفير بعض التعليم. ومع استمرار الأزمة، يتمّ الانتقال إلى مرحلة التكيّف المزمن، والتي تهدف إلى إنقاذ الأطفال من فاقد تعليميّ يتّسع، ليشمل اليوم عامًا دراسيًّا ونصف العام.
مرحلة الصدمة
لم تدُم هذه المرحلة عدّة أسابيع، أو حتّى عدّة أيام، فقد شهدنا مع بداية الحرب والدمار غير المسبوق صدمة جماعيّة، طالت كلّ مكوّنات المجتمع، وأصبح السؤال الملحّ لدى لعديد من المؤسّسات التي كانت تقدّم خدمات متطوّرة، أو خدمات "رفاهيّة" لم تعد على سلّم الأولويّات، ولم تعد متاحة في الحرب: ما دورنا؟ ماذا يمكن أن نفعل؟ شهدت ردّات الفعل تفاوتًا كبيرًا، إذ حاولت بعض المؤسّسات أن تحافظ على هويّتها بما تقدّمه اليوم، بينما تعاملت مؤسّسات مع الوضع الراهن باعتباره فترة استثنائيّة، تحتاج إلى ردّات فعل استثنائيّة، وإن كانت خارجة عن اختصاصها، مثل توفير الغذاء، والدواء، والرزم الشخصيّة. كما تباينت سرعة استجابة المؤسّسات، وهو أمر متوقّع في ظلّ هذه الظروف الإباديّة الاستثنائيّة، فشعرت بعض المؤسّسات أنّ ما يمكن أن تقدّمه لا يحتاج إليه الناس حاليًّا، مثل خدمة التعليم؛ فمع استهداف البنية التحتيّة والمدارس، توقّف التعليم الرسميّ بالكامل. ومع الحصار والنزوح، وانقطاع الموادّ الغذائيّة، واستهداف الأطفال بشكل غير مسبوق، أصبح من غير المتخيّل أن نتحدّث عن التعليم بينما يُباد أطفالنا. ولكنّ هذه المرحلة لم تدم طويلًا، وانتقل المجتمع بأكمله إلى مرحلة الاستجابة الطارئة.
مرحلة الاستجابة الطارئة (مرحلة ردّة الفعل/ الأزمة)
مع اشتداد شراسة حرب الإبادة، وتصاعدها إلى عنف غير مسبوق ضدّ الشعب الفلسطينيّ في قطاع غزّة، وفي ظلّ تدمير البنية التحتيّة، واستهداف المدارس والمربّعات السكنيّة، شهد قطاع غزّة نزوحًا داخليًّا واسعًا وسريعًا، سارعت على إثره مؤسّسات المجتمع المدنيّ إلى إطلاق استجابات عاجلة، لتوفير أساسيّات الحياة، من غذاء ودواء وملجأ، مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدّمتها الأطفال والنساء. وأشارت تقارير صادرة عن مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيّة (OCHA)، إلى تضرّر آلاف المساكن، وانهيار العديد من المدارس، أو تحوّلها إلى مراكز إيواء، ما فرض تحدّيًا إضافيًّا أمام الجهات المدنيّة، المُطالَبة بتوفير مساحات آمنة، ودعم نفسيّ واجتماعيّ عاجل (OCHA, 2024).
تمثّل أحد أبرز نماذج هذه الاستجابة الطارئة في الجهود التي قادتها مؤسّسة الإغاثة الطبّيّة الفلسطينيّة. فمع تزايد الإصابات وارتفاع أعداد الجرحى، نشطت فرق طبّيّة متنقّلة تابعة للمؤسّسة في الأحياء والمخيّمات الأكثر تضرّرًا، لتقديم الإسعافات الأوّليّة والعلاجات الأساسيّة، لا سيّما في المواقع التي بات الوصول إليها بالغ الصعوبة جرّاء استمرار القصف. ووفقًا لتقرير نشرته المؤسّسة في أواخر سنة 2023 (PMRS, 2023)، تجاوز عدد المرضى الذين تلقّوا خدمات إسعافيّة في المراكز المؤقّتة التي أقامتها المؤسّسة، خمسة آلاف شخص خلال الأسابيع الأولى من الحرب. ولم تتوقّف جهود الإغاثة عند توفير الرعاية الطبّيّة؛ إذ شملت أيضًا توزيع طرود غذائيّة، ومستلزمات النظافة الصحّيّة للعائلات التي نزحت من منازلها. وأفادت المؤسّسة أنّ هذه الخطوة كانت ضروريّة للحدّ من خطر تفشّي الأمراض المعدية، في ظلّ الظروف الصحّيّة السيّئة، الناجمة عن الاكتظاظ ونقص المرافق المناسبة.
بالتوازي مع ذلك، كان لمؤسّسة تامر للتعليم المجتمعيّ دور مهمّ في تقديم الاستجابة السريعة للاحتياجات النفسيّة والتعليميّة للأطفال. وبحسب تقرير نشرته المؤسّسة في منتصف سنة 2024، بادرت فرقها الميدانيّة إلى زيارة أماكن الإيواء المؤقّتة، والمدارس التي تحوّلت إلى ملاجئ جماعيّة، وعملوا على تنظيم أنشطة تفريغ نفسيّ، تعتمد أساليب الرسم، واللعب الجماعيّ، والقراءة التفاعليّة، بالتعاون مع عدد من الاختصاصيّين النفسيّين والمتطوّعين الشباب. وبرغم الصعوبات الميدانيّة، نجحت تامر في توفير حقائب تعليميّة، تضمّ كتبًا مبسّطة ووسائل ترفيهيّة للأطفال في أكثر من سبعة عشر موقعًا، مستهدفة نحو ألفَي طفل انقطعوا عن الدراسة. وأشارت المؤسّسة إلى أنّ هدف هذه المبادرات الطارئة كان تقليل الإحساس بالضياع وعدم الاستقرار، ومنح الأطفال مساحة للتعبير عن مخاوفهم وقلقهم (Tamer, 2023).
في المحصّلة، شكّلت هذه النماذج وغيرها عصب الاستجابة الأوّليّة لمؤسّسات المجتمع المدنيّ في غزّة خلال الحرب، إذ جمعت بين توفير الاحتياجات الأساسيّة، سواء الطبّيّة أو الغذائيّة، وبين العمل على الصعيد النفسيّ والاجتماعيّ، ليشعر السكّان المنكوبون بأنّ ثمّة من يساندهم في مواجهة الواقع اليوميّ المتقلّب. وعلى الرغم من محدوديّة الموارد والإمكانيّات، في ظلّ الحصار وازدياد أعداد النازحين، برهنت هذه المؤسّسات على قدرتها على التحرّك المنسّق والسريع، ممهّدة بذلك الطريق للانتقال إلى مرحلة تالية من الاستجابة، تركّز على إعادة تأهيل العمليّة التعليميّة، وتقديم برامج دعم مستدام على المدى البعيد.
مرحلة التكيّف المبكّر
ما إن مرّت صدمة الأيّام الأولى من الحرب، وتيقنّا، شعبًا ومؤسّسات، أنّنا نتعرّض إلى حرب إبادة طويلة المدى، حتّى أدركت مؤسّسات المجتمع المدنيّ حقيقة أكثر عمقًا: المعركة لا تقتصر على تدمير البنية التحتيّة والخدمات الصحّيّة فحسب، بل تطال أيضًا التعليم الفلسطينيّ، بما يمثّله من ركيزة أساسيّة في الصمود وحفظ الهويّة. وقد أشار عدد من الباحثين إلى أنّ "الإبادة المعرفيّة" التي تستهدف التعليم الفلسطينيّ بجميع مكوّناته، من مؤسّسات وطلبة ومعلّمين وعاملين، ليست وليدة اللحظة، وإنّما امتداد لمنهجيّة قديمة تعود إلى نشوء دولة الاحتلال. فقد أدرجت إسرائيل الهجمة على التعليم في سلّم أولويّاتها منذ بدايات المشروع الاستعماريّ، لذا استمرّت في إغلاق المدارس والجامعات مرارًا (Yaqoubi, 2021).
وعلى ضوء ذلك، برزت في غزّة جملة من المبادرات المجتمعيّة والتعليميّة التي يمكن تصنيفها ضمن إطار "التعليم الشعبيّ"، والتي يسعى النشطاء والمعلّمون بتكريسها لنزع السيطرة المعرفيّة من قبضة الاحتلال، وإعادة هيكلة التعليم بما يعكس احتياجات الناس ورؤيتهم.
مع الانتقال إلى مرحلة التكيّف الأولى، بدأ المجتمع المدنيّ بتنظيم مبادرات تعليميّة عفويّة ودعمها، استندت إلى نموذج التعليم الشعبيّ الذي استُلهمت جذوره من الانتفاضة الأولى (1987)؛ فظهرت مبادرات تطوّعيّة قادها معلّمون وناشطون داخل خيام النزوح، حيث شكّلت هذه المساحات ملاذًا آمنًا للأطفال، يُعيد إليهم بعض مظاهر الحياة الطبيعيّة التي افتقدوها وسط أجواء الحرب والنزوح. تضمّنت الأنشطة الغناء، واللعب، وسرد القصص الشعبيّة، إلى جانب الرسم، والتلوين، والدبكة، والمسرح الشعبيّ. لم تكن هذه الفعّاليّات مجرّد وسائل للترفيه، بل أدوات فعّالة لمساعدة الأطفال على تجاوز مشاعر الخوف، واستعادة طفولتهم المفقودة.
مثّلت هذه المساحات بالنسبة إلى المعلّمين المبادرين فرصة لاستعادة توازنهم النفسيّ، وتجديد علاقتهم المهنيّة بالتدريس، إذ أتاحت لهم إمكانيّة ممارسة التعليم في أجواء أكثر تفاعلًا، على رغم شحّ الموارد اللوجستيّة المتاحة. ومع الوقت، بدأت ملامح التعليم الشعبيّ تتبلور في غزّة، مستندة إلى أنشطة تشاركيّة مبتكرة، تنوّعت بين اللعب، وقراءة القصص التي تعيد الأطفال إلى عوالم الطفولة، بالإضافة إلى تقديم دروس في الرياضيّات واللغة، تركّز على المهارات الأساسيّة الضروريّة.
في الوقت نفسه، واجه القائمون على هذه المبادرات تحدّيات كبيرة، تمثّلت في التدمير المتكرّر للمساحات المأهولة، وأزمة الكهرباء، والحرارة الشديدة. وعلى الرغم من ذلك كلّه، واصلوا تقديم الدعم المعرفيّ والوجدانيّ للأطفال، ساعين إلى ترسيخ أساس تعليميّ بديل، يحفظ شعلة التعلّم متّقدة في أصعب الظروف (Wahbeh، 2024).
ومع إصرار الشعب الفلسطينيّ في غزّة على التعلّم، وجدت مؤسّسات المجتمع المدنيّ نفسها أمام رغبة شعبيّة قويّة، ترأّسها أولياء الأمور، لتحقيق هذا الهدف. استجابت المؤسّسات لهذه المطالب، وكرّست جهدها ومواردها لدعم المبادرات الفرديّة، بتقديم مساعدات مادّيّة وعينيّة، شملت توفير القرطاسيّة التي أصبحت شبه معدومة في القطاع، وتأمين أماكن مخصّصة للتعليم، مثل إنشاء خيام، أو تخصيص غرف داخل مراكز الإيواء. كما بذلت جهودًا لتنظيم هذه الخدمات، لضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه المبادرات الفرديّة، وما رافقها من دعم مؤسّسيّ، لم تكن قائمة على منهجيّة مدروسة مسبقًا، بل جاءت استجابة فوريّة وطبيعيّة للأزمة الإنسانيّة الكارثيّة التي فرضتها الحرب على أرض الواقع.
شهدت التدخّلات التعليميّة تنوّعًا في مختلف أنحاء القطاع، فركّزت بعض المؤسّسات على تقديم أنشطة معرفيّة مبنيّة على المعرفة السابقة، بينما طوّرت مؤسّسات أخرى محتوى خاصًّا يلبّي الاحتياجات الأساسيّة، من مهارات أكاديميّة وأنشطة ترفيهيّة، في حين اعتمد العديد من المعلّمين على الكتب المدرسيّة في تحضير لقاءاتهم التعليميّة.
يمكن القول إنّ هذه التدخّلات تميّزت بمرونتها، وقدرتها على التكيّف مع الظروف المتغيّرة، ومع ذلك، فإنّ ما يجمع بينها جميعًا هو طابعها المؤقّت، وإيمان القائمين عليها بأنّ العودة إلى المدارس والحياة الطبيعيّة أمر لا غنى عنه. فهذه المبادرات، سواء المؤسّسيّة أو الفرديّة، لم تكن مبنيّة على رؤية ممنهجة لتعويض الفاقد التعليميّ، بل جاءت بمثابة تكيّف طبيعيّ مع صدمة الواقع الذي فرضته الحرب.
مرحلة التكيّف المزمن
مع استمرار حرب الإبادة، ودخولها شهرها الرابع عشر، لم يعد بالإمكان الحديث عن أنشطة مؤقّتة تشغل الأطفال، وتساعدهم في التفريغ النفسيّ، إذ أصبح الواقع المخيف يواجهنا جميعًا، وبدأ العام الدراسيّ الثاني، واتّسعت الفجوة التعليميّة بشكل لا يمكن علاجه في ظلّ الظروف الراهنة.
لم تعد الحرب في غزّة مجرّد حدث عابر تمكن مواجهته بخطط مؤقّتة؛ فمع إكمالها العام الأوّل، بات واضحًا أنّنا أمام وضع مزمن للغاية، يفرض على الأهالي التنقّل الدائم بين مناطق تتعرّض إلى القصف بشكل يوميّ، وفي ظروف معيشيّة شبه مستحيلة، تتراوح بين البرد القارص في الشتاء، والحرارة العالية في الصيف، الأمر الذي يجعل من مفهوم "الاستدامة" التعليميّة تحدّيًا حقيقيًّا. ففي حين تتطلّب أيّ خطط تعليميّة بعيدة المدى حدًّا أدنى من الاستقرار، لا يجد السكّان في غزّة ملاذًا آمنًا في الحرب، ما يدفع بمؤسّسات المجتمع المدنيّ إلى ابتكار مقاربات جديدة، للتعامل مع واقع "التكيّف المزمن" في ظلّال إبادة المستمرّة.
خلافًا لدول أخرى، يلجأ سكّانها إلى مناطق أكثر أمانًا أو دول مجاورة خلال الحروب (مثل العراق وسوريا، حيث نزح اللاجئون إلى الأردنّ ولبنان وتركيّا)، يواجه النازحون في غزّة حصارًا مُطبقًا وإغلاقًا للمعابر، فلا توجد "مناطق خضراء" فعليًّا، يمكن أن تُقام فيها هياكل تعليميّة مؤقّتة، أو مرافق لخدمات الرعاية النفسيّة والاجتماعيّة تُقدّم على مدى زمنيّ معقول. ووفق تقارير أمميّة صدرت في أواخر سنة 2024، تتزايد أعداد النازحين يوميًّا، بلا بارقة أمل بالأمان في الأفق، ما يجعل محاولات إنشاء مدارس أو برامج دعم متكاملة، تصطدم بغياب البيئة الحاضنة التي تتيح استقرار الطالب أو المعلّم، ولو نسبيًّا.
ومع اتّساع الفجوة التي تفصل الأطفال عن حقّهم الأساسيّ في التعليم، تتفاقم التحدّيات في المرحلتَين الابتدائيّة والإعداديّة التي تُكتسَب فيها المهارات التأسيسيّة، إذ يفقد الكثير من الطلاب قدرتهم على التركيز جرّاء النزوح المتكرّر وقلّة الأمان. ووفقًا للقاءات ميدانيّة أجرتها مؤسّسة تامر للتعليم المجتمعيّ (Wahbeh، 2024)، يتسبّب غياب الاستقرار الأمنيّ في ظهور حالات التشتّت المعرفيّ والقلق الحادّ، إذ لا يمكن للطلّاب وضع تصوّر مستقبليّ حول انتظام دوامهم الدراسيّ، أو حتّى بقائهم في المكان نفسه لفترة كافية. وتشدّد مؤسّسات محلّيّة، مثل جمعيّة الثقافة والفكر الحرّ (CFTA، 2024)، على الأثر الكبير للقلق في تعطيل قدرة الأطفال على مواصلة الدراسة، ما يتطلّب تدخّلات نفسيّة واجتماعيّة أكثر تنظيمًا.
وعلى رغم الإجماع على صعوبة تحقيق استدامة حقيقيّة في هذه الظروف، ما تزال مؤسّسات المجتمع المدنيّ تواصل عملها، مثل مؤسّسة النيزك، ومؤسّسة تامر للتعليم المجتمعيّ، ومنتدى شارك الشبابيّ، وغيرها من المبادرات الفرديّة والمؤسّسات الصغيرة. يمكن إطلاق مصطلح التكيّف المزمن على أنشطة هذه المؤسّسات، إذ تحاول خلق برامج تعليميّة شبه دائمة، وترسيخها ما أمكن في الأماكن التي يمكن وصفها بأنّها آمنة نسبيًّا، وفي الغالب يعني ذلك أنّ القصف المتكرّر يحدث حولها، ولكن لا يصيبها. تعمل هذه المؤسّسات على تثبيت الخيام التعليميّة، لتأمين مكان ثابت ويوميّ يتيح للأسر النازحة تعليم أبنائها، مع تنظيم دروس تأسيسيّة، وجلسات دعم نفسيّ. على رغم الجهود المبذولة، تواجه المؤسّسات تحدّيات كبيرة على أرض الواقع، يأتي في مقدّمتها تأمين الخيام. وحتّى عند توفيرها من خلال التعاون مع جهات أمميّة، مثل النيزك واليونيسف، تبرز عقبات أخرى تتعلّق بالحفاظ عليها وحمايتها، بالإضافة إلى نقلها وإقامتها في مواقع النزوح. إلى جانب ذلك، يشكّل توفير الطعام للأطفال أثناء الأنشطة التعليميّة تحدّيًا جوهريًّا، لا سيّما في شمال القطاع، حيث تعاني المناطق مجاعةً شاملة وحصارًا خانقًا، يزيد من صعوبة تلبية الاحتياجات الأساسيّة.
تتنوّع الموادّ التعليميّة المستخدمة. ولكن، مع إطلاق وزارة التربية والتعليم للرزم التعليميّة المختصرة، بادرت المؤسّسات إلى تبنّي هذه الرزم وإثرائها. وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة الأطفال الذين فقدوا عامهم الدراسيّ، أو اضطرّوا إلى التنقّل المتكرّر، في متابعة الدروس الأساسيّة بسرعة، كلّما أتيحت لهم فرصة استقرار مؤقّتة.
يطرح هذا الواقع سؤالًا جادًّا حول ما إذا كان السعي إلى الاستدامة التعليميّة منطقيًّا في ظلّ حرب إباديّة. يرى بعض المراقبين أنّه لا مجال للحديث عن خطط بعيدة المدى، ما دامت المقوّمات الأساسيّة للبقاء (الكهرباء، المياه، الأمان...) شبه معدومة. لكنّ آخرين يجادلون بأنّ هذه المبادرات، حتّى لو بدت هشّة أو متقطّعة، فإنّها تُبقي على جذوة التعلّم مشتعلة، وتحافظ على قدر من المهارات الأساسيّة لدى جيل يواجه ظروفًا استثنائيّة. وبالنظر إلى تجارب سابقة في التاريخ الفلسطينيّ، يشير هؤلاء إلى أنّ نماذج التعليم الشعبيّ أرست من قبل أسس بُنى تعليميّة مقاومة ومبتكرة، تحوّلت لاحقًا إلى قواعد ثابتة في بنية المجتمع التعليميّ.
بعد عام كامل على الحرب، يبدو من غير الواقعيّ الحديث عن استدامة راسخة بمعناها التنمويّ التقليديّ. ومع ذلك، فقد أفرزت المحاولات المتواصلة لتثبيت خيام تعليميّة، وإعداد مناهج مختصرة، وحزم دعم نفسيّ، تجارب ميدانيّة يمكن أن تتطوّر عند أوّل انفراج مستقبليّ. فهذه المبادرات قادرة على حماية ولو جزء من الذاكرة المعرفيّة لدى الأطفال، وتأسيس حالة مرنة من التعلّم، قد تصبح مستقبلًا نواة لنهضة تعليميّة أشمل، إذا ما توقّف العدوان. ويظلّ الأمل قائمًا في أنّ "التعليم المصرّ على الحياة" سيُشكّل خطّ دفاع معرفيًّا، يعوق الإبادة الثقافيّة التي يسعى الاحتلال لفرضها.
ما بعد الحرب… التعافي
ربّما يصعب تصوّر ما سيحدث بعد انتهاء الحرب، أو حتّى تخيّل نهايتها في ظلّ استمرارها العنيف، ولكنّ الأكيد أنّنا أمام مفترق طرق في منظومة التعليم الفلسطينيّة. لا ينبغي أن تكون خطّتنا المستقبليّة العودة إلى التعليم كما كان، بل علينا التخطيط من اليوم لإعادة إحياء التعليم، وبناء المنظومة على أسس التعلّم الشعبيّ والتحرّريّ الذي سيحرّرنا من القيود المفروضة علينا، ويسهم في إعادة بناء النسيج المجتمعيّ، وتعافي الناجين من الإبادة ليتمكّنوا من الاستمرار، وخلق جيل مفكّر، ومتسائل، ومبتكر، قادر على بناء وطنه، في ظلّ ظروف محلّيّة وإقليميّة وعالميّة لا تعمل في الغالب لصالحه. وإذا كانت الحرب قد أثبتت شيئًا، فهو أنّ الفلسطينيّين هم من سيبنون فلسطين.
يشير تراكم المبادرات وتجارب المجتمع المدنيّ على مدى عام من الحرب، إلى أنّ دور هذه المؤسّسات يتجاوز الاستجابة الطارئة، ويقدّم نموذجًا جديدًا في التعليم. فقد أصبحت مساحات التعليم غير الرسميّ ذات دور أساسيّ في تعلّم الطلبة، وقد يؤدّي ذلك إلى خلق نموذج مرن وجديد في النظام التعليميّ، يتبنّى رؤية تعليميّة قادرة على استيعاب تحدّيات الواقع، مع الحفاظ على الهويّة الفلسطينيّة، وصقل مهارات الأطفال، وتمكينهم من مواجهة مستقبل مليء بالعقبات.
في هذا السياق، تبرز أهمّيّة التجربة الفلسطينيّة وأصالتها من جهة، والحاجة الملحّة إلى وضع خطط استراتيجيّة، ترتكز على معلومات وبيانات دقيقة ومُحدّثة من الميدان من جهة أخرى. كما تبرز ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا لتأمين استمرار التعليم على رغم الحصار. وفي سياق آخر، يصبح الانفتاح على التجارب الدوليّة المماثلة في الحروب عبر التاريخ أمرًا حيويًّا، بدءًا من الحرب العالميّة الثانية، وصولًا إلى الإبادة الجماعيّة في رواندا والبوسنة. ومع ذلك، يظلّ التمويل أحد أبرز التحدّيات التي تواجه المجتمع المدنيّ حاليًّا، سواء على الصعيد المحلّيّ أو الدوليّ. وهنا يُطرح التساؤل: كيف يمكن فرض الهويّة والرواية الفلسطينيّة على المموّل الأجنبيّ، في ظلّ حاجتنا إلى برنامج تعليميّ يعزّز الهويّة الفلسطينيّة، ويحمي الرواية التاريخيّة، لا سيّما تلك المرتبطة بالإبادة، ويسهم في مواجهة الإبادة المعرفيّة بجميع أشكالها؟
على الرغم من شحّ الموارد وحالة عدم الاستقرار، يبقى الرهان على الشباب الفلسطينيّين، الذين يقودون الاستجابة الحاليّة في الحرب، وعمليّة التعليم في المجتمع المدنيّ. أثبت هؤلاء الشباب قدرتهم على تجنيد الدعم المادّيّ والمعنويّ خلال العام الماضي، مستندين إلى إرث غنيّ من تجارب مؤسّسات المجتمع المدنيّ، ما يوفّر أساسًا يمكن البناء عليه مستقبلًا، لتعزيز التعليم والحفاظ على الهويّة الفلسطينيّة.
المراجع
- الزريعي، منار. (2024). دور مؤسّسات المجتمع المحلّيّ في دعم التعليم أثناء الحرب: تجربة جمعيّة الثقافة والفكر الحرّ في غزّة. منهجيّات.
- وهبة، نادر. (2024). مبادرات التعليم الشعبيّ في غزّة: تجارب المعلّمين وتحدّياتهم. مؤسّسة الدراسات الفلسطينيّة.
- اليعقوبي، يحيى. (2021). التعليم الشعبيّ: هكذا أفشل الفلسطينيّون محاولات تجهيل جيل الانتفاضة.
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). (2024). Humanitarian update #225.
- Palestinian Medical Relief Society. (2023). Serving the most vulnerable.
- The Tamer Institute for Community Education. (2023). Tamer Institute Annual Report.

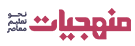


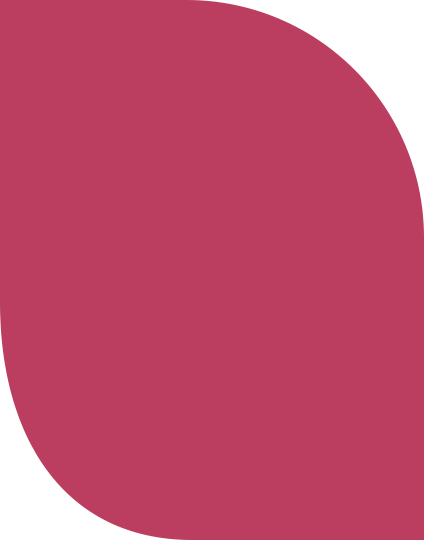

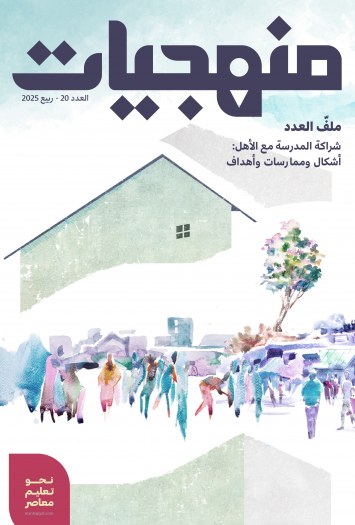






 نشر في عدد (20) ربيع 2025
نشر في عدد (20) ربيع 2025 

