لا شكّّ أنّ الإنسان هو الرأسمال الحقيقيّ لكلّ تنمية بشريّة هادفة، ذلك أنّه الأساس الذي يبنى عليه تقدّم الأمم أو تخلّفها، فلا خير في أمّة لا تقدّر الفرد، فهو الوسيلة والغاية في الآن نفسه: الوسيلة لتقدّم المجتمعات وبنائها، والغاية لأنّ كلّ مجتمع يروم بناء فرد صالح، متشبّع بالقيم المتّفق عليها اجتماعيًّا. ولمّا كان الأمر كذلك، أجمع أهل العلم على أهمّيّة المدرسة، ومكانتها في تربية النشء وإعداده إعدادًا متكاملًا، فيسعى ذلك الإعداد المخطّط له سلفًا، لتكوين مواطن صالح يخدم محيطه أوّلًا، وعالمه ثانيًا. وهكذا اهتمّت المدارس التربويّة، والمذاهب الفلسفيّة التي صدر عنها كثير من العلوم (علوم التربية، وعلم ديداكتيك الموادّ، وعلم النفس النمائيّ...) بشخصيّة الطفل المتعلّم، وكانت غاية هذه العلوم - بالنسبة إلى العقل التربويّ الغربيّ - الإجابة عن ثلاثة أسئلة: من هو الطفل؟ كيف ندرّسه؟ ماذا ندرّسه؟
وللإجابة عن هذه الأسئلة، اهتمّ المختصّون في مجال التربية بدراسة الفعل التعليميّ، ووضع فرضيّات خلصوا باستخدامها إلى تأسيس علم الديداكتيك، باعتباره علمًا يهتمّ بكيفيّة تدريس الموادّ المعرفيّة، والطريقة الأنسب لتدريس كلّ مادّة منها؛ ومن ثمّ كان الحديث عن ديداكتيك مادّة التاريخ، وديداكتيك مادّة اللغة العربيّة، وغيرهما؛ وعلى هذا الأساس أصبح لكلّ مادّة من الموادّ ما يسمّى عند أهل التربية بالديداكتيك الخاصّة.
لم يقف الأمر بالمختصّين الغربيّين عند هذا الحدّ، بل أثروا بحوثهم بكثير من الطرائق البيداغوجيّة التي عقدوا العزم على جعلها وسائل مجدية في تمرير المعرفة إلى المتعلّم، ومن ثمّ جعله ذاتًا قادرة على استثمار مهاراته لحلّ المشكلة التي تواجهه، باعتبارها عمليّة يستخدم فيها الفرد معرفته المكتسبة من أجل تحقيق المطلوب في موقف غير مألوف لديه (شحاتة، وآخرون. 2003)، ولم تكن بحوثهم صادرة من فراغ أو وليدة اللحظة، بل هي بحوث أرست معالمها من نظريّات فلسفيّة ولغويّة ونفسيّة. بالإضافة إلى هذا كلّه، تناولت البحوث تلك النظريّات وفق مقاربة تتناسب والمحيط السوسيو-ثقافيّ للمتعلّم، إيمانًا منهم بأنّ المدرسة وسيلة لتحقيق فلسفة اجتماعيّة وثقافيّة وسياسيّة، محدّدة مسبقًا بغايات المجتمع السياسيّ ومؤسّساته (المير، وآخرون. 1996). فالمتعلّم- عندهم - ظاهرة اجتماعيّة وثقافيّة معقّدة، يصعب فكّ رموزها من دون مدارسة علميّة تستجلي بنياته النفسيّة والفكريّة، وتقف عند مؤهّلاته العلميّة؛ وهو فوق هذا وذاك إنسان، وإنسانيّته تقتضي أن يراعى في تعليمه ما للإنسان من حقّ في الحرّيّة والكرامة واحترام الغير، لأنّ سلامة المجتمع تتحدّد أساسًا بسلامة أفراده (أرماندو. 2005). وهذه الأمور أقطاب توجيهيّة ينطلق منها التعليم الغربيّ، ليرسّخ ثقافة الديمقراطيّة في ميدان التعليم، قبل أن يرسّخها في المجتمع، لأنّ مجتمعاتهم لا تستمدّ هذه الثقافة من الشعارات الفارغة، والتصوّرات العاجزة عن الأجرأة والتطبيق، بل تستمدّها من المدرسة. فلكي يكون المواطن متشبّعًا بقيم الديمقراطيّة، لابدّ أن تُدمج هذه القيم في برنامجه التعليميّ، ويبقى للمدرسة الدور الأساس في زرع هذه الثقافة.
تلاؤم النظريّة والبيئة الثقافيّة - الاجتماعيّة
إنّ تقدّم المدرسة الغربيّة - في كندا وفرنسا مثلًا - على مثيلاتها العربيّة، جاء نتيجة مجهودات جبّارة تكلّف بها - بالإضافة إلى الإرادة الإصلاحيّة الصادقة للدولة - كلّ من علماء التربية وعلماء النفس والمختصّين في مجال التدريس. وتوّجت مجهوداتهم بمدارس نظريّة متعدّدة الاتّجاهات، لكنّها تسعى في معظمها لتطوير العمليّة التعليميّة داخل الفصل، والرقيّ بفعل التعلّم إلى حالة من التمدرس العلميّ الممنهج الذي يصدر عن نظريّات تربويّة حديثة، وطرائق بيداغوجيّة روعي في صياغتها واقع المتعلّم الغربيّ، وقدراته الإدراكيّة، ومحيطاه الثقافيّ والاقتصاديّ؛ وهو الأمر الذي أدّى إلى مناقشة علميّة بين كثير من العلماء والدارسين، فكان أن نتج عن هذه المناقشة إنتاج فكريّ تربويّ، جسّدته كثير من المؤلّفات التي تناولت فعل التعلّم بالدرس والتحليل، وبرز على الساحة التربويّة علماء كبار من أمثال: كزافييه روجيرس، وجان بياجي، وهاربارت، وفيليب بيرنو، وآخرون.
وعلى الضفّة الأخرى، يبدو جليًّا أنّ الواقع في حقل التربية العربيّ على خلاف ما هو عليه الحال في المدارس الغربيّة؛ فهو واقع يعيش تخبّطًا في المنهج، وضبابيّة في التخطيط والاستشراف، وعجزًا عن تنزيل الرؤى الإصلاحيّة بشكل ناجح، وذلك لأسباب ذاتيّة وأخرى موضوعيّة. ويبقى من أهمّ هذه الأسباب أنّ طرق التدريس في مدارسنا، غالبًا ما تستمدّ مرجعيّتها النظريّة من واقع غربيّ متقدّم ليس بيننا وبينه نقط التقاء، فلا مجال للمقارنة بين الفصل الفرنسيّ والفصل المغربيّ مثلًا، أو بين المجتمع الألمانيّ ومجتمعنا، أو بين الأسرة العربيّة والأسرة الأمريكيّة المختلفة في شتّى المجالات. وعلى الرغم من هذا كلّه، تجد فلسفتنا في الإشراف التربويّ - ولا سيّما على مستوى التخطيط المركزيّ - تُسقط نظريّات ورؤى جاهزة ومستوردة، على واقع مدرسيّ عربيّ يتخبّط في أزماته المتنوّعة، وبالتالي تصبح هذه الرؤى وتلك النظريّات ضعيفة الجذع عديمة النفع، لا تمّت جذورها بصلة لتربة المدرسة العربيّة وإشكالاتها العميقة.
الانفصام عن الواقع
إنّ هذه المفارقة التربويّة التي يعيشها نظامنا التعليميّ العربيّ، بسبب ثقافة الاستيراد، أدّت بالمدرسة العربيّة - باستثناء بعض التجارب العربيّة الرائدة - إلى منزلق خطير، إذ أصبحت مدارسنا تعيش حالة من الانفصام في الشخصيّة، والتي يمكن لأيّ مهتمّ أن يرصد أعراضها بالنظر إلى ما يُطالب به المدرّس العربيّ داخل الفصل. فهذا الأخير مطالب بتمرير المعرفة وفق نظريّات تربويّة وبيداغوجيّات تدريس، نشأت وترعرعت في تربة المدارس الغربيّة. بل هو مدعوّ كذلك إلى تفعيل هذه النظريّات في مدرسة عربيّة، نعرف جيّدًا إمكاناتها وإكراهاتها، كما نعرف أحوال تلاميذها الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وما هم عليه من ضعف في مواصفات التخرّج.
ولعلّ هذه المفارقة التربويّة التي تفرض على المدرّسين في بلادنا، بتوجيه من الوزارة وتأطير من فلسلفة إشرافنا التربويّ، هي ما تجعل مدارسنا العربيّة تعيش حالة اكتئاب نفسيّ، ناجم عن معالجة أدوائها بأدوية غيرها، كما تُفقد المدرّسين الثقة بالنفس، لأنّهم يدركون أنّ مشاكلنا لا يمكن حلّها بمقاربات دخيلة عليها؛ ففي المغرب مثلًا، كان يجدر بمن بلور برنامج المخطّط الاستعجاليّ الذي راهن على جعل المتعلّم في قلب منظومة التربية والتكوين (وزارة التربية الوطنيّة، 2008)، أن يناقش مع المشرفين التربويّين الذين يشاركون في صياغة السياسات التربويّة العامّة للوزارة، ويتمتّعون بقوّة اقتراحيّة وازنة، مخاطر الاستغراب الثقافيّ في علوم التربية والتدريس. فكلّ النظريّات التي تروج في ميدان التربية في عالمنا العربيّ، استُورِدَت من الغرب، وكأنّ هؤلاء المشرفين ربّما لا يتحمّسون، أو لعلّهم يجدون إكراهات موضوعيّة، تحول بينهم وبين الأخذ بآليّات المنهج العلميّ الذي يقتضي دراسة الحالة؛ أي واقع المدرسة العربيّة اعتمادًا على الملاحظة والوصف والتحليل، بهدف الوصول إلى تصوّرات تؤدّي إلى بناء نظريّات تربويّة ذات هويّة وطنيّة.
إنّنا لا ندين هنا انفتاح إشرافنا التربويّ على النظريّات التربويّة الغربيّة، وعلى علوم التربية الحديثة بمختلف أنواعها، فهذا أمر له من الوجوب ما هو مفروغ من الخوض فيه بالحديث، ولكنّنا ندين التقليد الأعمى الذي يلبس التلميذ العربيّ جلباب التلميذ الغربيّ، فيأتي اللباس على غير قياس وبصيرة. صحيح أنّ جهاز الإشراف التربويّ يحظى بمنزلة أكاديميّة وخبرة تربويّة لا يستهان بهما، ما يؤهّله من تقديم مقاربة تعاونيّة واعية تهدف إلى تطوير مهارات الأداء الصفّيّ للمعلّمين، وتجويد استراتيجيّاتهم في تمرير المعرفة وبنائها مع المتعلّمين، بهدف الرفع من مردوديّة العمليّة التربويّة ككلّ، لكنّ الأصحّ من هذا كذلك أنّ فلسفة هذا الإشراف تعيش حالة من الاغتراب التربويّ، في مختلف المهمّات المسندة إليها تنظيرًا وتطبيقًا، ويمكننا الوقوف على مظاهر ذلك في الأمثلة التالية:
- - يتشرّب إشرافنا التربويّ الفلسفة التربويّة الغربيّة ويقتات من علومها ونظريّاتها، لذا تجد معظم أطره – سواء تلك التي تشتغل ضمن فرق تربويّة مركزيّة، وتعمل على تقديم الاقتراحات المتعلّقة بتحديد الاختيارات التربويّة والتوجّهات العامّة في الوطن العربيّ، أو تلك التي تحمل على عاتقها مهمّة تنزيل سياسة الوزارة وأجرأتها على أرض الواقع – متأثّرة بشكل أو بآخر بالفكر التربويّ الغربيّ، ويظهر هذا واضحًا في ما تروّج إليه في الندوات واللقاءات التربويّة، من مقاربات تربويّة غربيّة الهوى؛ مثل التدريس بالكفايات، وبيداغوجيا الإدماج، وتقنيّة التدريس وفق المستوى المناسب؛ ناهيك عن مختلف نظريّات التعلّم الحديثة، بدءًا من النظريّة السلوكيّة، ومرورًا بالنظريّة المعرفيّة، وانتهاء بالنظريّة البِنائيّة. وهنا يبقى السؤال الدائم حول مدى صلاحيّة هذه المقاربات وتلك النظريّات لواقع المتعلّم في المدرسة العربيّة، خصوصًا إذا علمنا أنّ تراثنا العربيّ لا يخلو من آراء حول أساليب التعليم؛ فصاحب المقدّمة تحدّث عن بيان وجه الصواب في تعليم المتعلّم، والذي يتحقّق بدعم ملكته بوسائل التكرار ومسايرة وتيرة تعلّمه، وتقريب الفكرة منه بأمثلة حسّيّة، وتلقينه العلوم وفق قاعدة التدرّج (ابن خلدون، 1981).
- - إنّ إلقاء نظرة بسيطة على إسهامات إشرافنا التربويّ في مجالات البحث العلميّ وما يعتمده من مراجع، يؤكّد انبهار أصحابه بما أنتجه العقل التربويّ الغربيّ من علوم ونظريّات تربويّة، ونتيجة لذلك تنحصر بحوثهم - أحيانًا - في دوائر من الاقتباس والترجمة والتكرار، من دون أن يكون لها حظّ من إعمال للعقل في المقروء الغربيّ، أو تكييفه أو تحديثه؛ وكلّ بحث تربويّ لا تتأصّل أوراقه العلميّة من تربته الوطنيّة، لا يمكنه إطلاقًا أن يضع يده على مكمن الداء في منظومتنا التربويّة العربيّة.
بعض خطوات تأصيل الإشراف التربويّ
إيمانًا منّا بما لجهاز الإشراف التربويّ من كفاءة معرفيّة بيداغوجيّة، فإنّنا نأمل من أطره - سواء تلك التي تشتغل في دوائر التخطيط ورسم السياسات، أو تلك التي تقع على عاتقها مهمّات الأجرأة والمتابعة والتنزيل- أن تكون:
- - باحثة في تراثنا العربيّ عمّا قد يتناثر فيه من آراء تربويّة، يمكن بلورتها في طرح نظريّ تربويّ متكامل.
- - مسهمة بإنتاجات تربويّة تنطلق من واقع مدارسنا العربيّة.
- - متجنّبة إسقاط النظريّات التربويّة الغربيّة بشكل متعسّف على واقعنا التربويّ العربيّ.
- - متواصلة مع المدرّس تواصلًا أفقيًّا غير عموديّ، كون المدرّس هو من الركائز الأساس لكلّ عمل يروم النهوض بالنظام التربويّ (المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، 2021).
- - منصتة لما يسطّره المدرّسون من اقتراحات في مجالسهم التعليميّة، ومؤطّرة لندوات تربويّة تثير نقاشًا بنّاءً وأسئلة عميقة، حول كيفيّة تطوير العمليّة التربويّة في بلادنا، لتنتهي هذا الندوات إلى إنتاج بحوث تربويّة هادفة.
***
ينبغي للإشراف التربويّ الذي يسعى لتطوير الممارسة الصفّيّة في مدارسنا العربيّة، أن يعمل في فرق بحث متعدّدة التخصّصات، على دراسة الصفّ المدرسيّ بما فيه من عوائق ومفارقات، وما يتخلّله من إكراهات ذاتيّة وموضوعيّة، وما تعانيه الجماعة المتعلّمة من تمثّلات معرفيّة تجانب الصواب، وفوارق نفسيّة وذهنيّة متفاوتة، وذلك حتّى يتسنّى له أن يفرز حلولًا علاجيّة تنطلق من واقع المدرسة العربيّة، ومن صميم إشكالاتها المزمنة. ولا يمكن لدراسته تلك أن تكون ناجعة إذا أصرّ فيها على النظر إلى واقعنا التعليميّ بنظّارة فرنسيّة أو كنديّة، لأنّ ذلك سيفضي إلى أشكال كثيرة من التغريب الثقافيّ في ميداننا التربويّ (السورطي، 2009).
المراجع
- ابن خلدون، عبد الرحمن. (1981). المقدّمة، (ص 533-534). بيروت، لبنان: دار القلم.
- أرماندو، أنتونيلو. (2005). التربية والتحليل النفسيّ، التحليل النفسيّ الفرويديّ أنموذجًا. (ترجمة: غريب، عبد الكريم)، (ص 6). منشورات عالم التربية.
- السورطي، يزيد. (2009). السلطويّة في التربية العربيّة، (ص197). مجلّة عالم المعرفة.
- شحاتة، حسن، وآخرون. (2003). معجم المصطلحات التربويّة والنفسيّة (ص 171). مصر: الدار المصريّة اللبنانيّة.
- المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلميّ، تقرير موضوعاتيّ. (2021). مهنة الأستاذ(ة) في المغرب بمعيار المقارنة الدوليّة، (ص 95). المملكة المغربيّة.
- المير، خالد، وآخرون. (1996). الطرائق البيداغوجيّة، سلسلة التكوين التربويّ (04)، (ص 93). الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة.
- وزارة التربية الوطنيّة والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلميّ (2008). من أجل نفس جديد للإصلاح: تقديم البرنامج الاستعجاليّ 2009-2012، (ص 3). المملكة المغربيّة.

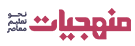


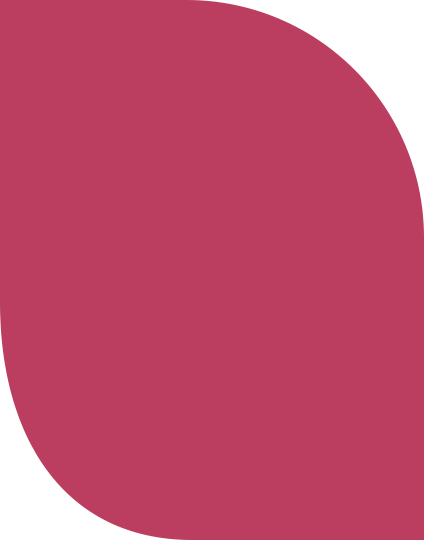

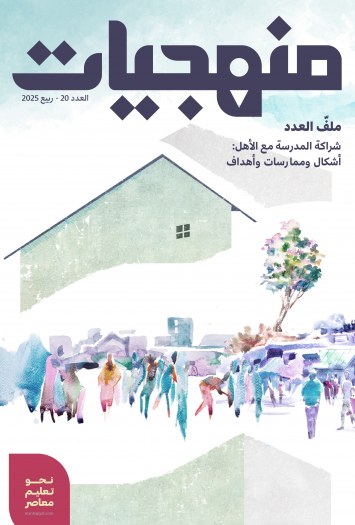






 نشر في عدد (20) ربيع 2025
نشر في عدد (20) ربيع 2025 

