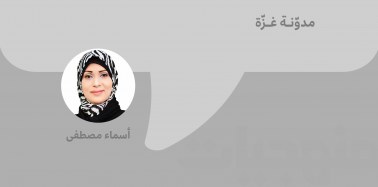عملت في التعليم منذ ما يقارب العشرين عامًا. خلال هذه المدّة، لم أرَ نجاحًا للعمليّة التعليميّة بعيدًا عن هيكل الواقف بمئزره الأبيض أمام السبّورة. آمنت دائمًا أنّ التعليم في الحقيقة يبدأ من المعلّم وينتهي إليه؛ مهما تحرّكت نحوه الكيانات، ومهما دارت حوله أو مُرِّرت إليه المضامين.
واليوم، إذ أطالع وسائل التواصل الاجتماعيّ، والمواقع الإلكترونيّة المُختلفة، تتبدّى لي، وبوضوح، كمّيّة الإغفال للمعلّم نظرًا لما أجده من سعي مقصود/ أو غير مقصود لإغراق التعليم في لجّة التقنية. الجميع اليوم مقتنع أنّ المخرجات المختلفة للتّكنولوجيا هي السّبيل الأمثل لعمليّة تعليميّة مُثلى، وهي في آن الحلّ الأنجع لكلّ مثالب التعليم الكلاسيكيّ البائد، أو السائر نحو الإبادة.
يتحدّثون عن التعليم الجديد المرتكز أساسًا إلى الوسيلة الإلكترونيّة والحواسيب بشكل خاصّ، وكأنّهم يبشّرون بخلاص من كلّ أنواع العجز التي يلمسونها في ميادين التعليم المختلفة. هل يعتقدون مثلًا أنّه بمجرّد أن يدرس الطفل بواسطة جهاز "الآيباد"، سيتمكّن تمكّنًا تامًّا من المعرفة المقدّمة؟ هل يظنّون أنّ التّلميذ سيُحصّل الكفاءات المرجوة بمجرّد استعمال الإنترنت؟ هل اللّوح الإلكترونيّ كفيل بتذليل صعوبات التعلّم على اختلاف أنواعها ومستوياتها؟
أقولها جازمة: لا، ولا عملاقة مدوّية لها سقطة جبل ودويّ رعد.
أنا معلّمة منحازة للإنسان: أوّلًا، من جانب الفروقات الفرديّة في ما يخص القدرات المعرفيّة ومستوى الذكاء؛ فالوسيلة، مهما كان نوعها، لن تساوي شيئًا أمام إنسان لا يُحسن استغلالها الاستغلال الأمثل والأكمل. لهذا، التقنيّة في الحقيقة لا شيء إذا ما وضعت بين يدي من لا حول له ولا قوّة.
ثانيًا، من جانب رؤيتي واقتناعي بأهمّيّة، بل ومفصليّة، العلاقة الإنسانيّة في العمليّة التعليميّة/ التعلّميّة، تلك العلاقة التي تتشكّل مع الأيّام ساقيةً من خلالها تنتقل المعارف من المعلّم إلى المتلقّي/ المتعلّم، في خطوط خاصّة باستقامتها وتعاريجها.
لكن هل تعلمون لماذا أتّخذُ هذا الموقف؟
ببساطة بالغة لأنّني أحبّ عملي، ومن خلال ذلك الحبّ عايشت تفاصيل العمليّة التعليميّة، بل ودقائقها التي لا يمكن لغير المنصهر فيها أن يدركها حتّى ولو أسرج لذلك أكثر الخيال قوّة وسعة.
ببساطة... الآلة أو البرمجيّات الإلكترونيّة لا يمكنها أن تعي أنّ الطفل لم يفهم من خلال ملامحه، كما لا يمكنها الوعي بحالته الشعوريّة في لحظتها، فلا تتمكّن من التقاط ما إذا وصل المحتوى القيميّ للدرس أم لا، وبأيّة درجة...
الآلة لا تفهم ما تفتقده وهو "الوعي والشعور"، وحتّى الذكاء الاصطناعيّ لن يتمكّن من ذلك لأنّه في النهاية رؤية فرد جُعلت برنامجًا يعمل ويتكرّر، ولكن يستحيل أن يتكاثر. وحتّى تتّضح فكرة افتقاد التقنيّة للوعي والشعور أكثر، دعونا نتأمّل حصّة في نشاط القراءة مثلًا، ولنعزل ما استطعنا من تفاصيل في تلك الوضعيّة التعليميّة.
على الوسائل الإلكترونيّة سيقدَّم النصّ مقرونًا، وربّما مرفقًا بصور توضيحيّة، وقد يرافق إدراج النصّ على الشاشة بصوت يعطي تعليمات القراءة جهريّة أو صامتة، ومن الممكن أن تكون العمليّة أكثر ضبطًا فترفق بميقات لحساب وقت محدّد، هو وقت القراءة.
والتقنية لن تعجز عن فتح ميكرفون بشكل آليّ حالما بدأ التّلميذ بالقراءة، لتسجّل الذبذبات وتقارنها بمخزون الذاكرة المدرج مسبقًا لإطلاق أحكام على نوعيّة القراءة. وليس صعبًا أن تترافق القراءة مع مصحّح صوتيّ عند كلّ خطأ يُرتكب... لكن، خارج دائرة الصوت لنطرح السؤال الوجيه: ماذا حدث على مستوى وعي التلميذ؟ ما الانفعالات المتبادلة على طول جمل النصّ وفقراته؟ ما القيم المضافة إلى رصيد التلميذ؟ هل سيشعر بالحبّ أو التقزّز، بالاطمئنان أو القلق... بالدرجة نفسها التي يشعر بها وهو يحتكّ مباشرة بملامح بشريّة، تتغير بليونة حسب محتوى النصّ ومستوى جودة القراءة، والجوّ العام للفصل، وهو يتلقّى من معلّمه كلمات إشادة أو تشجيع آنيّة ومن دون أدنى تأخير؟
إن ضاعت حصّة القراءة أو حصّة التعبير، ضاعت قيّم كثيرة وكفاءات عديدة كنّا نحاول إرساءها بفرد جديد نريد إقحامه في حياة اجتماعيّة بمواصفات رسمناها بأعلى درجات التفاؤل.