بينما كنت أفكّر في كتابة هذه الورقة، كان لاقتباس من ربيع علم الدين صدى عميق في ذهني:
"قرأت شكسبير عندما كان عمري 14 عامًا، لأنّه ما تعلّمناه في المدارس، وأعتقد أنّ هنا تكمن المشكلة: آثار الاستعمار الباقية. لم يكن يسمح لنا التحدّث باللغة العربيّة أثناء الاستراحات في المدارس في لبنان – كان علينا التحدّث إمّا بالفرنسيّة أو الإنجليزيّة، لأنّك إن كنت تتحدّث لغة أجنبيّة، يا إلهي، أنت بالتأكيد متعلّم" (الجارديان، 2015).
في مجال التعليم الدوليّ سريع التطوّر والديناميكيّ، هنالك سؤال مؤثّر يطرح نفسه، ويدعونا إلى التشكيك في خياراتنا وقراراتنا التربويّة: هل نقوم، وبغير قصد، ببناء بيئة تعليميّة لا يكون فيها المعلّمون الذين يتحدّثون اللغة الإنجليزيّة الأصليّة معلّمين فحسب، بل يتمتّعون أيضًا بمكانة شبه أسطوريّة، ما يديم سرد التفرّد اللغويّ؟
من اللغة إلى الحالة: كيف تشكّل تصوّرات أولياء الأمر الخيارات التعليميّة
لطالما كانت الأفضليّة الممنوحة للمعلّمين الناطقين باللغة الإنجليزيّة باعتبارها لغتهم الأمّ، تشكّل تحيّزًا صامتًا، لكن متجذّرًا بعمق، إذ غالبًا ما تدعم المدارس وأولياء الأمر وحتّى الطلاب، من دون وعي، فكرة أنّ الطلاقة اللغويّة منذ الولادة، تعني تدريسًا أكثر كفاءة، وتواصلًا أكثر فعّاليّة، ونتائج تعليميّة متفوّقة.
انتقد هوليداي (2006) هذا التحيّز، إذ صاغ مصطلح "مبدأ المتحدّثين الأصليّين"، أو "Native-Speakerism"، لوصف الأيديولوجيّة التي تدعم المتحدّثين الأصليّين، باعتبارهم المعلّمين المثاليّين للّغة الإنجليزيّة، ما يؤدّي إلى تهميش المعلّمين متعدّدي اللغات، وحماية هياكل السلطة القديمة المتهالكة في التعليم. لا يهمّش هذا المنظور المعلّمين المؤهّلين من غير المتحدّثين الأصليّين باللغة فحسب، بل يديم أيضًا التسلسل الهرميّ اللغويّ الذي يمكن أن يعوق إثراء تجارب تعلّم اللغة. بالإضافة إلى ذلك، جادل موسو ولووردا (2008) بأنّ المتحدّثين الأصليّين وغير الأصليّين هم ببساطة بنى مجتمعيّة، طُوٍّرت بسبب تعميم بعض الاختلافات المتصوّرة من حيث الكفاءة والخبرة اللغويّة. كما تابع الكاتبان النقاش بخصوص التمييز الذي يعانيه المتحدّثون غير الأصليّين، وذكرا أنّ الصور النمطيّة المتعلّقة باللهجة والعرق، تؤدّي دورًا حاسمًا في التمييز ضدّ المتحدّثين غير الأصليّين بها (Moussu & Llurda, 2008). ومع ذلك، هل هذا الافتراض صحيح؟ أم أنّنا نعزّز عن غير قصد التسلسل الهرميّ اللغويّ الذي يهمّش المعلّمين المؤهّلين من خلفيّات لغويّة متنوّعة؟
في أجزاء كثيرة من العالم، ولا سيّما في المنطقة العربيّة، ليست اللغة الإنجليزيّة لغة عالميّة تفتح الأبواب وتتيح الفرص وحسب، ولكنّها أيضًا رمز للحراك الاجتماعيّ والاقتصاديّ. وبالتالي، غالبًا ما يسعى الأهل لتسجيل أبنائهم في المدارس التي توظّف معلّمين ناطقين باللغة الإنجليزيّة، معتقدين أنّ هذا يضمن تلقائيًّا إتقان أطفالهم اللغةَ.
تتجاهل هذه العقليّة بشكل رئيسي حقيقة جوهريّة؛ فالتعليم اللغويّ الفعّال لا يعتمد فقط على لغة المعلّم الأمّ، بل على مهاراته التربويّة، ووعيه الثقافيّ، وقدرته على تعزيز تجارب التعلّم الهادفة. معلّم اللغة المثاليّ ليس بالضرورة الشخص الذي يمتلك اللهجة "المثاليّة"، بل هو الشخص الذي يمكّن الطلّاب من التفكير النقديّ، والانخراط في خطاب هادف، وتطوير الكفاءة العالميّة. لذلك، فإنّه من المهمّ التعرّف إلى كيفيّة تأثّر الأنظمة التعليميّة بالإمبرياليّة. أكّد كاناغاراجا (1999) وفيليبسون (1992)، أنّ تفضيل المتحدّثين الأصليّين باللغة الإنجليزيّة يمكن أن يديم التسلسل الهرميّ، ويعزّز تجاهل التنوّع الغنيّ في القدرات والكفاءات في مناطق مثل العالم العربيّ.
تمتدّ هذه القضيّة إلى ما هو أبعد من ممارسات التوظيف، إذ تسهم أيضًا في تشكيل نظرة الطلّاب ذاتهم إلى تعلّم اللغة. عندما يتعلّم الأطفال على أيدي معلّمين يجسّدون هويّة لغويّة واحدة مهيمنة، فقد يتولّد لديهم انطباع بأنّ تعدّد اللغة لديهم أقلّ قيمة، ما يعزّز الشكّ اللغويّ بالذات، بدلًا من تنمية الثقة (Garcia, 2023).
الإمبرياليّة اللغويّة: التسلسل الهرميّ الخفيّ في المدارس
تجادل نظريّة الإمبرياليّة اللغويّة، كما صاغها فيليبسون (1992) وكاناغاراجا (1999)، بأنّ إعطاء الأولويّة للمتحدّثين الأصليّين باللغة الإنجليزيّة، يديم تسلسلًا هرميًّا متجذّرًا، يقلّل من قيمة المعلّمين متعدّدي اللغات، والمؤهّلين تأهيلًا عاليًا.
تأثير الإمبرياليّة اللغويّة في المشهد التعليميّ العربيّ عميق ومؤثّر؛ فتفضيل المتحدّثين الأصليّين باللغة الإنجليزيّة لا يديم التسلسل الهرميّ اللغويّ فحسب، بل يهمّش أيضًا التراث اللغويّ المتنوّع، والمتأصّل، والفريد من نوعه في المنطقة (Hargreaves, Buchanan, & Quick, 2024). كما تتجلّى هذه الظاهرة في إعطاء الأولويّة للمتحدّثين الأصليّين باللغة الإنجليزيّة، وتفضيلهم على المعلّمين من خلفيّات لغويّة متنوّعة، ما يسهم عن غير قصد في الحفاظ على الهيمنة اللغويّة والثقافيّة في الفصل الدراسيّ. فبحسب كاناغاراجا (1999)، يقيّد هذا التحيّز الخطاب التربويّ، ويقلّل من أهمّيّة التنوّع اللغويّ في خلق تجربة تعليميّة شاملة. وبالتالي، غالبًا ما يساوي الأهل بين أصالة اللغة والحصريّة اللغويّة، ما يستبعد عن غير قصد وجهات نظر التدريس المتنوّعة، ويعزّز التحيّزات الثقافيّة.
نحو نهج شموليّ
استنادًا إلى رؤية باولو فريري وأعماله المؤثّرة، تحت عنوان "علم أصول التدريس للمضطهدين"، أو "Pedagogy of the Oppressed"، فإنّ نظريّته تدعو إلى تعليم يتجاوز حصره بالاكتساب اللغويّ، ويواجه البنى القمعيّة. وبما أنّ اللغة متشابكة مع الهويّة والتراث الثقافيّ في العالم العربيّ، فإنّ تركيز فريري على التعليم الحواريّ والوعي النقديّ، له صدى قويّ ووثيق الصلة بالحاجة إلى مواجهة الإمبرياليّة اللغويّة في المنطقة (Freire, 1970).
بالإضافة إلى ذلك، على المؤسّسات التعليميّة أن تهيّئ بيئة لا تكتفي بتعزيز الكفاءة اللغويّة فحسب، بل تغذّي أيضًا عقليّة دوليّة ضروريّة لتطوير المهارات والكفاءة، لفهم التحدّيات الكبيرة ومعالجتها، بالإضافة إلى تعزيز العقلانيّة والحكمة في التعبير عن وجهات نظر متنوّعة، وذلك بتعزيز تعدّديّة الآراء والأصوات، والاحتفاء بها (Reimers, 2006). وعلى هذا النحو، فإنّه من المهمّ تسليط الضوء على أنظمة تعليميّة أكثر فعّاليّة ودوليّة، تعتزّ بالهويّات الثقافيّة، وتقدّر التنوّع اللغوّي وتعزّزه، وتزوّد المتعلّمين بالمهارات اللازمة للتحليل، والتحقيق، والتنقّل، واكتساب فهم عميق لمحيطهم.
لتحدّي هذا التصوّر المتجذّر بعمق، على المدارس إعادة التفكير في شراكتها مع أولياء الأمور، إذ لم تعد الحصص التقليديّة، والكتيّبات المدرسيّة التي تشيد بـ "المتحدّثين الأصليّين"، نقطة كافية للترويج لبرامج المدرسة. وعوضًا عن ذلك، على المدارس إشراك أولياء الأمور في محادثات نقديّة حول المؤشّرات الحقيقيّة لتعليم اللغة عالي الجودة.
تغيير تصوّرات أولياء الأمر
وهكذا، يظهر السؤال الرئيس: كيف يمكن للمدارس الدوليّة أن تغيّر تصوّرات الآباء المتأصّلة بعمق حول المتحدّثين الأصليّين، لتعزيز نهج أكثر شمولًا وفعّاليّة، وذي صلة عالميًّا، لتعليم اللغة؟
لكسر قيود التسلسلات الهرميّة اللغويّة بشكل حقيقيّ، على المدارس الدوليّة العمل بشكل فاعل، لتحويل توقّعات الوالدين من الامتياز اللغويّ إلى المساواة اللغويّة؛ فيرَون اللغة أداة للمشاركة العالميّة، بدلًا من هويّة ثابتة وموروثة (Jenkins, 2007). إذ، ومع تطوّر التعليم الدوليّ، يصبح من المهمّ تجاوز أسطورة المتحدّثين الأصليّين التي عفا عنها الزمن، وتبنّي نموذج شامل يقدّر الأصوات المتنوّعة، ووجهات النظر العالميّة، والتميّز التربويّ.
أيّ نهج اجتماعيّ عادل للتعليم يجب أن يرفض مفهوم تفوّق المتحدّثين الأصليّين، ويعطي الأولويّة للإنصاف بدلًا من ذلك، بالاعتراف بقيمة المعلّمين متعدّدي اللغات. ووفقًا لنظريّة نانسي فريزر (2009) عن التكافؤ التشاركيّ، فالاستبعاد من المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعيّة أو المهنيّة، القائم على سوء الاعتراف وسوء توزيع الفرص، يؤدّي إلى تعزيز الهياكل القمعيّة. كما تعكس المعاملة التفضيليّة للمتحدّثين الأصليّين أنماطًا أوسع من الاستبعاد، تمنع المعلّمين من خلفيّات لغويّة غير مهيمنة، من الحصول على القدر نفسه من التقدير في سياق تعليم اللغة. وقد يتطلّب تغيير تصوّرات الوالدين جهدًا منهجيًّا، وشفافيّة، وحوارًا هادفًا، يأتي بتثقيف أولياء الأمور، وتعريضهم إلى نماذج لغويّة متنوّعة، وتضمين سياسات التوظيف الشموليّة. بهذا يمكن للمدارس تحويل تعليم اللغة إلى أداة للتمكين، بدلًا من الإقصاء (Thompson & Asanov, 2024).
بناءً على كلّ ما سبق، يمكن تنفيذ استراتيجيّات شاملة، قادرة على تحدّي التحيّزات المتجذّرة وتعزيز الشموليّة:
- - على المدارس تنظيم ورش عمل تفاعليّة، وجلسات تعلّم تجريبيّة، وحلقات نقاش تسلّط الضوء على الأبحاث التي تثبت أنّ فعّاليّة التدريس ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمهارات التربويّة والكفاءة الثقافيّة، أكثر من ارتباطها بحالة اللغة الأمّ. ويمكن تطبيق ذلك بتقديم الأدلّة القائمة على البحث، ومساعدة الآباء في تقدير نقاط القوّة التي يمكن أن يقدّمها المعلّمون غير الناطقين الأصليّين في الفصل الدراسيّ.
- - يمكن خلق فرص للأهل والطلبة للتفاعل مع المعلّمين من خلفيّات لغويّة متنوّعة، ما قد يساعد في تفكيك أسطورة المتحدّث الأصليّ. ويمكن للفعّاليّات المدرسيّة، مثل المعارض الثقافيّة، وأندية اللغات، والأيّام المفتوحة في الفصول الدراسيّة، أن تُظهر فعّاليّة المعلّمين غير الناطقين الأصليّين. تشكّل هذه التجارب تحدّيًا صريحًا للافتراضات القائلة إنّ المتحدّثين الأصليّين فقط هم من يمكنهم تقديم تعلّم لغويّ أصيل، وتسلّط الضوء على فوائد وجهات النظر اللغويّة المتنوّعة.
- - على المدارس تقييم معايير التوظيف الخاصّة بها بشكل نقديّ، للقضاء على التحيّزات لصالح المتحدّثين الأصليّين، فتجعل إعلانات الوظائف تركّز على مؤهّلات المرشّحين المهنيّة والعلميّة، وخبراتهم وكفاءاتهم الثقافيّة، بدلًا من لغتهم الأمّ. إذ تشير الأبحاث إلى أنّ إعلانات الوظائف غالبًا ما تتضمّن لغة تمييزيّة، مثل طلب الكفاءة "الأصليّة" أو "شبه الأصليّة"، والتي يمكن أن تثبّط عزيمة المتقدّمين المؤهّلين غير الأصليّين (Thompson & Asanov, 2024). بمراجعة هذه الممارسات، يمكن للمدرسة بناء طاقم تدريس أكثر تنوّعًا وكفاءة.
- - تسهيل جلسات حوار منظّمة وغير رسميّة، يناقش فيها الأهل مخاوفهم، وتصوّراتهم، وتوقّعاتهم الثقافيّة حول تعلّم اللغة بصراحة. يتماشى هذا النهج مع نظريّة فريزر (2009) للتكافؤ التشاركيّ، ما يضمن سماع جميع الأصوات، وتقديرها واحترامها.
- - تقديم بيانات من التقييمات الداخليّة للمدارس ومن الأبحاث الخارجيّة، لإثبات الادّعاءات بأنّ تعلّم اللغة الفعّال يعتمد على الأساليب التربويّة وخبرة المعلّم، أكثر من اعتماده على حالة اللغة الأمّ (Buchanan, Hargreaves & Quick, 2024).
***
يعزّز الافتراض بأنّ المتحدّثين الأصليّين معلّمون متفوّقون بطبيعتهم التسلسلات الهرميّة اللغويّة ويقوّض الإنصاف، ويحدّ من تعرّض الطلبة إلى النماذج اللغويّة المتنوّعة (Thompson & Asanov, 2024). لذا، على المدارس أن تتحدّى هذه التحيّزات بشكل فاعل ومنهجيّ، لضمان توافق التعليم والتعلّم مع حقائق عالم مترابط ومتعدّد اللغات. فعندما يصرّ الأهل على المتحدّثين الأصليّين، فإنّهم يحدّون عن غير قصد من تعرّض أطفالهم إلى التنوّع اللغويّ الذي سيتعرّضون إليه في تفاعلات العالم الحقيقيّ (Hargreaves, Buchanan, & Quick, 2024).
المراجع
- Canagarajah, S. (1999). Resisting linguistic imperialism in English teaching. Oxford University Press.
- Fraser, N. (2009). Scales of justice: Reimagining political space in a globalizing world. Columbia University Press.
- Garcia, P. (2023). Parents’ attitudes towards native and non-native speakers as potential teachers of their children. (master’s thesis). University of Lleida.
- Hargreaves, E., Buchanan, D., & Quick, L. (2024). Social justice as parity of participation: Fraser’s theory. In E. Hargreaves, D. Buchanan, & L. Quick (Eds.), Children's Life-Histories in Primary Schools (pp. 25-38). Palgrave Macmillan.
Holliday, A. (2006). Native-speakerism. ELT Journal, 60(4), 385-387.
- Jenkins, J. (2007). English as a Lingua Franca: Attitude and Identity. Oxford University Press.
- Moussu, L. & Llurda, E. (2008). Non-native English-speaking English language teachers: History and research. Language Teaching, 41(3), 315-348.
- Phillipson, R. (1992). Linguistic imperialism. Oxford University Press.
- Reimers, F. (2006). Citizenship, identity And education: Examining the public purposes of schools in an age of globalization. Prospects, 36, 275-294
- Thompson, A. & Asanov, E. (2024). "Nonnative? Next!" Native-speakerism in world language job advertisements. Studies in Second Language Learning and Teaching, 14(1), 49–74.

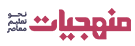


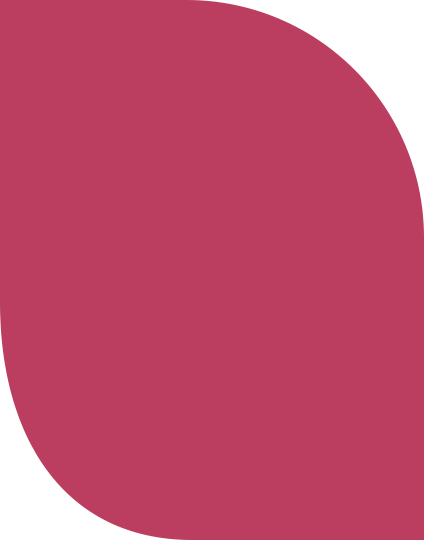

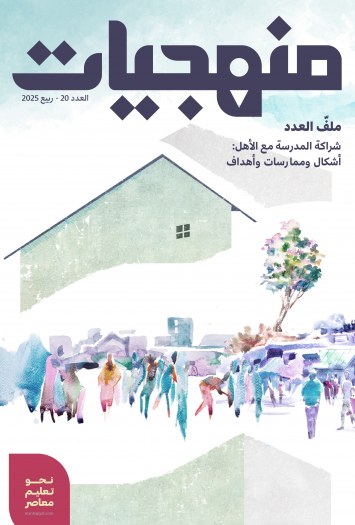






 نشر في عدد (20) ربيع 2025
نشر في عدد (20) ربيع 2025 

