"المعلّم الملهم ليس من يحمل شهادة، بل من يشارك الناس بما تبلور ونضج بداخله، وما يجسّده في أسلوب حياته" (السكاكيني، 1982).
خير ما أستهلّ به كتابتي، مقتطفٌ من أقوال السكاكينيّ، والتي شكّلت جذور فكره في التعامل مع العمليّة التعليميّة التعلّميّة بعناصرها الأساسيّة: المعلّم والطالب والمنهج الدراسيّ والبيئة التعليميّة. ذلك مع التركيز على الهدف والوسيلة التي تصوغ كلّ ذلك، في سبيل بيئة تعلّميّة نوعيّة تزخر بالإبداع والاستقلال والاحترام والتقدير والكرامة لكلّ من الطالب والمعلّم. فالطالب كائن اجتماعيّ، لا بدّ من إعداده لدوره الكامل في الحياة، مع مراعاة أبعاده الفكريّة والنفسيّة والسلوكيّة والإبداعيّة، على امتداد رحلته التعليميّة.
عندما التحقت ببرنامج اللغة العربيّة في جامعة بيرزيت، كنت أطمح إلى التحرّر من حدود جملة "مادّة اللغة العربيّة"، باعتبارها مجرّد مادّة دراسيّة محصورة في أنماط تقليديّة من الإعراب والنسخ والحفظ، وغيرها من الإملاءات المجرّدة.
لا يمكن أن يقتصر التعليم الحقيقيّ والناجح على المساحيق التي تفرضها قيود السلطة التربويّة، والتي تعمل بدورها على تقييد إبداع الطلّاب، وبالتالي تكبيل قدرة المجتمعات على النهوض. فالمدرسة التقليديّة، الخاضعة لأنظمة وقوانين تُفرض من الأعلى، لا تخرّج سوى عناصر رأسماليّة تخدم المصنع، بينما تقمع الفكر الإبداعيّ، وتعتمد على الامتحان والتقييم معيارًا وحيدًا للنجاح، لتنتهي بمنح الطالب "كرتونة الشهادة" بعد استيفائه للمتطلّبات الشكليّة، من دون أن تقوده إلى جوهر التعليم المتمثّل في الإبداع والمغامرة والنقد.
لذلك، لا بدّ من تزويد الطلّاب بأدوات النقد وتدريبهم عليها، وإفساح المجال أمامهم لإبداء آرائهم، وتنمية حسّ المشاركة في تشكيل عمليّة التعلّم وصياغة المعنى، ليكونوا فاعلين لا مفعولًا بهم.
حذّر خليل السكاكينيّ من التعليم الرسميّ الذي يتميّز بالانضباط الدقيق للأهداف والمناهج والجداول الزمنيّة، واعتبره إذلالًا واحتذاءً بحذاء الغير. ورأى في اللغة العربيّة لغة الكرامة في فكره وعمله. فهي الأساس الذي يقوم عليه دور المعلّم في المجتمعات العربيّة؛ إذ لا تكمن قيمته في عدد الشهادات أو نوعها، بل في مدى مشاركته ما يتعلّمه وما ينضج بداخله مع مجتمعه وطلّابه. فجوهر فكر السكاكينيّ يركّز على الطريق بدلًا من المحتوى، وعلى عمليّات التفكير، ودور الطالب في التعلّم، ونموّه في مختلف الجوانب، مع احترامه، وتوسيع مداركه، وتقوية عقله، وضمان سعادته بعيدًا عن رهبة الامتحانات، وبثّ الدافع الذي يعزّز همّته، ويقوده إلى أن يكون طالبًا حرًّا وقويًّا وأخلاقيًّا ومنسجمًا داخليًّا (فاشة، 2018).
معلّمة أبحث عن دور، لا عن وظيفة
"إنّ ما يصنع جودة التعليم هو تبيان الكيف لا النوع".
"ماذا تقصد عندما تقول: هذا مدرّس ممتاز؟"
"بالنسبة إليّ، المدرّس الممتاز هو ذلك الشخص الذي يعرف الفرق بين العلاقة بالأشياء والعلاقة بالناس"(هيثكوث، 2016).
طالما تحدّثت عن حلمي في البحث عن دور وكينونة وانتماء وعطاء وحبّ وأمل. لم أكن أبحث عن "وظيفة "، بل عن "دور"، أبحث "عمّا أريد أن أكون". ربّما كان حلمي في يوم من الأيّام أن أكون سفيرة لدولة فلسطين، إلى أن قرّرت مع بداية مسيرتي الجامعيّة أن أكون سفيرة للغة العربيّة. فكيف أكون سفيرة للغتي إن لم أتقنها، وأعشقها، وأغوص في دررها، وأنهل من معارفها؟ كيف أعلّمها طلّابي، وكيف أمارسها وأقدّمها إليهم؟ هل كما قُدّمت إلينا عندما كنّا طلّابًا: أعرب... احفظ الأبيات... اكتب ما تحفظ...؟
تعلّم بلا حدود
يقف الطالب أحيانًا أمام المعلّم متذمّرًا من أنّ المسألة الواردة في الامتحان لم تُطرح بالطريقة نفسها في الصفّ، أو عندما يعبّر عن نفوره من مادّة اللغة العربيّة، أو الرياضيّات، أو الجغرافيا، نتيجة نمط التعليم السائد الذي يختزل دوره في تلقّي المعلومات، وأداء الواجبات من دون تفاعل حقيقيّ.
حين تصبح ظاهرة الاعتماد المطلق على المعلّم في الشرح أمرًا شائعًا، وكأنّ الطالب مجرّد وعاء يُملأ بالمعلومات، نجده مستسلمًا لما تقدّمه المادّة الدراسيّة، فاقدًا الشغف، يدرس من أجل الاختبار فقط، من دون أن يمتلك القدرة على قراءة النصوص وتحليلها ونقدها، أو التفاعل مع جماليّاتها. وعندما يتحوّل الحكم على الطالب إلى عمليّة محصورة في اختبارات وتقييمات ظالمة، لا تراعي الفروق الفرديّة، ولا تمنحه دورًا فاعلًا في الصفّ والبيت والمجتمع... هنا، يجب أن نقف ونفكّر مليًّا، حتّى لا نتحوّل إلى مجرّد امتداد للنظام التعليميّ السائد.
الدراما منهجًا
وصفت دوروثي هيثكوث التعليم بأنّه عمليّة إبداعيّة تتميّز بخمس ظواهر أساسيّة: الدافعيّة؛ والشعور بالرضا عند ممارسته؛ والتغذية الراجعة التي تواكب تنفيذه؛ ووجود مؤشّرات للتواصل أثناءه؛ بالإضافة إلى الطقوس الخاصّة بالشروع فيه.
فجوهر العمليّة التعليميّة هو التركيز على الطريق بدلًا من المحتوى، وذلك عن طريق تدريب المعلّمين على خلق وضع تعلّميّ، وتطوير خبراتهم، ومنح الطلّاب فرصة لمكافحة المشكلات ثمّ الوصول إلى حلّ، وتحقيق الانخراط الإيجابيّ لديهم (هيثكوث، 2016).
من هنا برزت الحاجة إلى تعلّم الدراما، باعتبارها وسيلة ونهجًا يساعدان في بناء فهم أعمق حول عمليّتيّ التعليم والتعلّم، وتحقيق التعليم التكامليّ الذي يتيح لنا استكشاف مكنونات الأشياء عن طريق تأطيرها. حيث تسهم الدراما في خلق حالة من "الأمان" لدى الطالب، ما يشجّعه على الاستكشاف، والمشاركة، والمراقبة، والتجريب، إلى جانب تطوير مهاراته، والتعبير عمّا في داخله، والاستمتاع بالتعلّم. وبهذا يتشكّل لديه وعي متنامٍ، وتنمو لديه مهارات التفكير العليا والتخيّل، إذ تساعده الدراما في خلق عالم من الخيال يمكّنه من التجريب، والمشاركة، والتفاعل بحريّة وإبداع.
تُعدّ الدراما وسيلة قويّة لتعزيز التعاون والتواصل، إذ تمتلك القدرة على تغيير طرق التفاعل والتعبير بين الأفراد. كما أنّها جزء أصيل من الثقافة، تمنح المتعلّمين أداة لفهم ذواتهم، والتواصل مع محيطهم، وشحذ قدرتهم على الفهم، وتعزيز مهارات التعبير، وتنمية المعرفة الفكريّة والعاطفيّة (بويل، 2009).
ليست الدراما مجرّد استراتيجيّة تدريسيّة بالمفهوم التقليديّ، بل استجابة إبداعيّة تسهم في ابتكار النصوص والعروض ضمن عمليّة تكوينيّة مستمرّة، تستكشف الأوضاع والموادّ من زوايا متعدّدة. يتحقّق ذلك من خلال تجربة المشاركين طرائق هذا الشكل الفنّيّ واستراتيجيّاته وأعرافه، وتجسيدها داخل عالم مُتخيّل، ما يسمح لهم بنقل الخبرة من الخيال إلى الواقع. وتكمن أهمّيّة هذه التجربة في إمكانيّة تنفيذ التجارب الدراميّة في مشروعات جديدة.
الدراما… من التجربة والتطبيق إلى المشروع
"المشوار يبدأ بخطوة"، ومشوارنا في التخطيط للدراما يبدأ بأفكار تتنقّل في أذهاننا، ونكتبها بشكل عشوائيّ على الورق، على هيئة ملاحظة، أو عبارة، أو اقتباس، أو هدف تعلّم. بعد ذلك، نبحث في أجزاء المنهاج لنرى ما يمكن استكشافه في كلّ منطقة، ونتساءل ما إذا كان هذا سيلبّي احتياجات الطلّاب، ويحقّق الأهداف المرجوّة. ثمّ ننتقل إلى مرحلة أكثر تحديدًا، وهي مرحلة وضع المخطّط الإجرائيّ الذي يمكن تطبيقه في الصفّ. يشمل هذا المخطّط الأنشطة والخطوات والاستراتيجيّات والمهامّ التي ستُنفذّ مع الطلّاب، مع مراعاة توزيع الوقت على الأنشطة. يتعيّن أن تتوافق هذه الأنشطة والاستراتيجيّات مع الموضوع المطروح والأهداف التي نسعى لتحقيقها. كما يتعيّن ترتيبها وفقًا لما يقتضيه السياق واحتياجات الدرس، فيدعم ذلك بناء الأدوار واستكشاف الموضوعات باستخدام الخيال، بهدف صنع معنى، سواء على شكل فهم، أو شعور، أو فكرة، تمهيدًا لاستكشاف المفاهيم والقضايا ضمن سياق اجتماعيّ وثقافيّ، ما يسهم في بناء تصوّرات، واتّخاذ مواقف وتقييمها. كما تساعد هذه الطريقة في التنبّؤ بالمشكلات المحتملة، وتوفير حلول لها إذا ظهرت. وغالبًا يبقى السؤال: كيف أبدأ؟ هل أبدأ بنشاط تفاعليّ؟ أم بعرض فيلم؟ أم بصورة؟ أم ربّما باقتباس محفّز؟ كيف سأنتقل إلى النشاط التالي وصولًا إلى لحظة التأزّم أو الذروة التي ستقود إلى اللحظة الدراميّة؟ وكيف سنختتم الدراما؟ هل باستخدام استراتيجيّة معيّنة؟ أو بالتأمّل داخل الدور أم خارجه؟ من الطبيعيّ أن نواجه كلّ هذه التساؤلات أثناء التخطيط المكتبيّ والإجرائيّ.
ساحة الحناطير: من قصّة في المنهاج الفلسطينيّ، إلى تجربة دراميّة مثيرة
ما هو مصير الإرث الثقافيّ والتاريخيّ والوطنيّ، في ظلّ وجود فجوة بين الأجيال؟
في هذه المنطقة التي نستكشفها من أجل صنع معنى ما، ذاتيّ واجتماعيّ وثقافيّ، قمنا ببناء هذه التجربة العميقة استنادًا إلى قصّة "ساحة الحناطير" للكاتب أنور أبو مغلي، وهي جزء من منهاج الصفّ العاشر. في هذه الدراما، عملت مع الطالبات في سياق متخيّل حول قصّة جدّ يعيش في المهجر، وكان يعرف ساحة الحناطير قبل اللجوء، فهو يحتفظ بتراث هذه الساحة وذكرياتها في غرفته، مثل صور تذكاريّة، ومفتاح، وأدوات، ودفتر مذكّرات. أمّا في الغرفة المجاورة لغرفته، تسكن الحفيدة التي لا تكترث لهذا الموضوع، فلديها مساحتها الخاصّة، وأشياؤها التي تنتمي إلى جيلها، فهي تعتزّ بصور لها ولصديقاتها وللمشاهير.
من هذا السياق المتخيّل، استكشفنا الفجوة بين الأجيال، ومصير الإرث الثقافيّ والوطنيّ في ظلّ هذه الفجوة. لم نكتف باستكشافها فحسب، بل تعرّفنا أيضًا إلى إرث غنيّ وتاريخ عميق، يحكي حكاية شعب وهويّة وانتماء، واعتزاز بالتراث والماضي يسكن داخلنا. هذا الإرث حاضر في قلوبنا وعقولنا، مهما ارتحلنا أو ابتعدنا، فإنّه يظلّ حاضرًا. بهذه التجربة، نقضت الطالبات مقولة الاحتلال: "الكبار يموتون والصغار ينسون"، وكرّرن مقولة "من لا ماضي له لا حاضر له".
كلّ هذه المعرفة والمشاعر ظهرت وتكوّنت باستخدام استراتيجيّات الدراما وأعرافها، وخلق مستويات من التوتّر.
حقّقت هذه التجربة أهدافًا أخرى، مثل تعلّم اللغة العربيّة في سياق حيّ، بتنمية مهارات القراءة والكتابة والتعبير الوظيفيّ والإبداعيّ والمحادثة والمسرح. استُخدمت استراتيجيّات الدراما وأعرافها لتطوير هذه المهارات، مثل كتابة الرسائل، والبيانات، والتقارير، والأوصاف، وتعزّزت المهارات التعبيريّة الشفويّة والكتابيّة لدى الطالبات، باستخدام استراتيجيّات مثل السرد، والرواية، والأحاديث المسموعة، وغيرها من الأساليب التي تخدم هذا الغرض.
اختتمت هذه الدراما بموت الجدّ ورحيله، تاركًا إرثه وذكرياته.
ماذا ستفعل الحفيدة بتلك الذكريات؟
هذا ما اكتشفته الطالبات في اللحظة الدراميّة، عندما دخلت الحفيدة إلى غرفة الجدّ، وأخذت أغراضه وذكرياته ووضعتها في كيس، لتُخلق بذلك لحظة توتّر:
ماذا ستفعل الفتاة بهذه الأغراض؟
في لحظة توتّر دراميّ، تخيّلت الطالبات ردّ فعل الأب حين دخل غرفة والده ولم يجد الأغراض. ثمّ قامت المعلمة بدور الحفيدة التي ناداها الأب ليفهم ما حدث. بعد ذلك، تقمّصت الطالبات دور الأب (جماعيًّا)، إذ استعرضن الموقف بحوار الفتاة مع والدها. شرحت الفتاة الأسباب التي دفعتها إلى إزالة الأغراض، مثل رغبتها في توسيع غرفتها الضيّقة، وشعورها بعدم الجدوى من وجود هذه الأغراض بعد وفاة الجدّ. بهذه الأدوار، أكّدت الطالبات أنّ هذه الأغراض تمثّل إرثًا ثقافيًّا ووطنيًّا، وأنّ من لا ماضي له، لا حاضر له ولا مستقبل. اقترحت بعض الطالبات وضع هذه الأغراض في زاوية خاصّة، أو متحف للحفاظ عليها.
ثمّ تأمّلت الطالبات تصوراتهنّ لاحقًا بكتابة رسالة وجدت بين أغراض الجدّ في الكيس. كانت الرسالة مكتوبة من الجدّ لحفيدته، وأظهرت فيها مجموعة من الطالبات انتماءهنّ واعتزازهنّ بالماضي، وأهمّيّة الحفاظ على هذا الإرث، وبناء مساحة خاصّة بهنّ مع الالتفات إلى الماضي، واستخلاص ما فيه من عبر ودروس وعراقة وإنجازات، تمهيدًا لبناء ساحة تضمّ الماضي والحاضر، لتحقيق مستقبل أفضل. فكتبت إحدى الطالبات مقتطفات لكتّاب عبّروا عن رؤيتها. نقلت:
من شعر أحمد مطر:
"نموت كي يحيى الوطن!
يحيا لمن؟
من بعدنا يبقى التراب والعفن.
نحن الوطن!"
"سألت ما هو الوطن؟ وكنت أسأل نفسي ذلك السؤال قبل لحظة. أجل، ما هو الوطن؟ أهو هذان المقعدان اللذان ظلّا في هذه الغرفة عشرين سنة؟ الطاولة، ريش الطاووس، صورة القدس على الجدار، شجرة البلّوط، الشرفة، ما هو الوطن؟" و"أتعرفين ما هو الوطن يا صفيّة؟ الوطن هو ألّا يحدث ذلك كلّه". لغسّان كنفاني
"على هذه الأرض ما يستحقّ الحياة". لمحمود درويش
تعلّمت الطالبات الكثير عن الذكريات، والإرث، والوطن وحبّه، والانتماء، والمواجهة، والدفاع عن الممتلكات، تمهيدًا لبناء مساحة تجمع بين هذا الإرث والحداثة. فعن طريق الفعل، تقود الدراما إلى الانخراط والبحث في قصّة خياليّة، وسياق يخلق تعلّمًا تفاعليًّا وتكامليًّا، يسهم في بناء مشروع تعليميّ تعلّميّ يحدّده المعلّم والطالب معًا، بالمشاركة والفهم والتفاعل والإبداع.
المراجع
- هيثكوث، دوروثي. (2016). مختارات في الدراما والتعلّم. (ترجمة: بشارة، عيسى، وعيسى، منى، وسلامة، رامي). رام اللّه، مؤسّسة عبد المحسن القطّان.
- بويل، باميلا، وهيب، إس. (2009). تخطيط الدراما التكوينيّة (ترجمة: بشارة، عيسى). (الطبعة الأولى). رام اللّه: مؤسّسة عبد المحسن القطّان.
- فاشة، منير. (2018). حول رؤية السكاكينيّ في التعليم وتأسيسه المدرسة الدستوريّة. مجلّة 28.
- السكاكينيّ، خليل. (1982). كذا أنا يا دنيا. (الطبعة الثانية). بيروت: الاتّحاد العامّ للكتّاب والصحفيّين الفلسطينيّين.

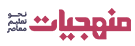


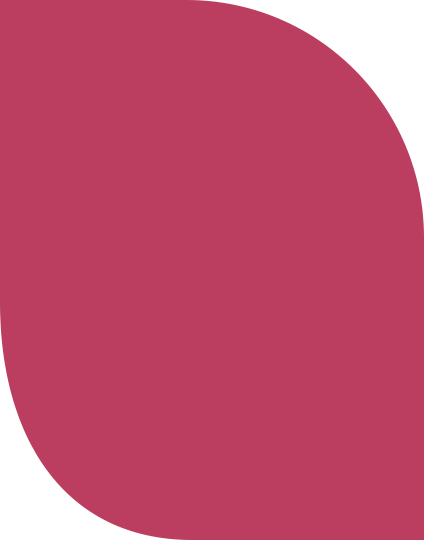

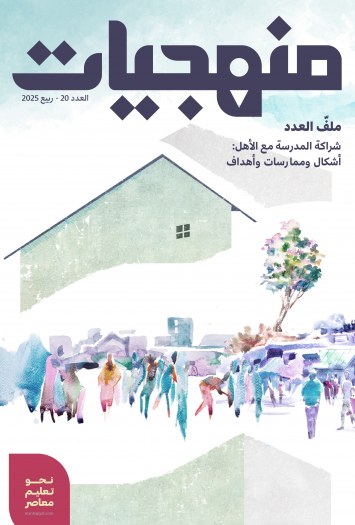






 نشر في عدد (20) ربيع 2025
نشر في عدد (20) ربيع 2025 

