نشأتُ في الريف الأردنيّ، وهو مثل باقي الأرياف في البلدان الأخرى، يرتبط سكّانه بروابط اجتماعيّة أقوى من تلك الموجودة في المدينة، فالتواصل بينهم أعلى بحُكم الجوار والقُربى والنسب والمُصاهرة، أو مصالح العمل المتشابهة. وفي الريف -غالبًا- يوجد مركز يلتقي فيه الناس، أو أهل الحلّ والعقد، مثل الدواوين، أو القاعة العامّة، أو حتّى أمام الدكّان، يناقشون فيه أمور حياتهم والقضايا الشخصيّة، أو ما يحتاجون إليه من خدمات يطلبونها من المسؤولين في مراكز المدن.
غالبًا ما تكون المدرسة محور النقاشات عند الحديث عن الخدمات الرسميّة التي يحتاج إليها سكّان القرية، إذ ينظرون إليها باعتبارها الطريق المضمون للوصول إلى المكانة الاجتماعيّة والاقتصاديّة. فهي المساحة التي يظهر فيها نبوغ الأبناء، وحيث يتفاخر الأهالي في ما بينهم حول من يُهيّئ أبناءه لنيل شهادة علميّة ووظيفة رسميّة في المدينة أو العاصمة، ليصبح الرجل بينهم والد الأستاذ، أو الطبيب، أو المهندس، أو المحامي. لهذا السبب، يُولون المدرسة اهتمامًا كبيرًا، يتابعون شؤونها، ويحرصون على معرفة المديرين والمعلّمين وزيارتهم بانتظام، لا سيّما وأنّ مدارس المناطق النائية غالبًا ما تعاني شحّ الموارد، وتُصنّف ضمن المدارس الأقلّ حظًّا مقارنة بنظيراتها في مراكز المدن.
تطرح منهجيّات هذا الملفّ لتُخرج علاقة المدرسة مع محيطها الاجتماعيّ من التقزيم الذي وقعت فيه، أو الذي أوقعناها فيه عندما حصرنا دورها بإخبار الأهل بمستوى أبنائهم التدريسيّ أو السلوكيّ، وعقد لقاءات دوريّة، غالبًا لا تخرج عن هذَين الأمرَين، لتوجّهنا إلى ضرورة إعادة تشكيل هذه العلاقة لتصبح أكثر تفاعليّة، تتأثّر فيها المدرسة بالاتّجاهات المجتمعيّة وتؤثّر فيها، ونتجاوز في ارتباطنا مع المدرسة مسألة الدعم الماليّ المحدود، إلى أفق مدرسيّ يعزّز جودة التعليم، ويخلق البيئة المتكاملة التي ينمو فيها الطلبة أكاديميًّا ومهاريًّا وسلوكيًّا.
استغراب مشروع
عرف العرب النظام الوقفيّ مبكّرًا، فالمدارس النظاميّة التي تنسب إلى الوزير نظام الملك؛ وزير السلطان السلجوقيّ أرسلان في سنة 455، كانت منتشرة، ومنها ما استمرّ بالعمل لأربعة قرون من الزمان، وكانت تمدّ أجهزة الدولة بالموظّفين المدرّبين في مجالات القضاء والحسبة والأدب، والفقه. إلّا أنّ الكثير منها تراجع في العصر الحاليّ. وربّما يجب التفكير بآليّات فعّالة لإعادة النظام الوقفيّ، إذ نجد في الغرب كثيرًا من دور التعليم التي تقوم على الوقفيّات التعليميّة التي يُخصّصها الأثرياء من أموالهم، حتّى تطوّرت تلك الدور وأصبحت معاهد وجامعات، تعتمد على أموال المتبرّعين بالدرجة الأولى كي تدوم وتستمرّ. فعلى سبيل المثال، تمتلك جامعة هارفارد الأمريكيّة أكبر حجم أوقاف عالميًّا، يصل إلى نحو 36.5 مليار دولار، وتحوّلت إلى جامعة تعتمد على الأوقاف في عام 1870، حتّى فاق عدد أوقافها 11 ألف وقف حاليًّا، لتتفوّق بذلك على موازنات بعض الدول العربيّة المعلنة في عام 2015، مثل تونس (15.96 مليار دولار)، والأردنّ (11.42 مليار دولار)، والسودان (10.13 مليار دولار)، وسوريا (9.1 مليار دولار).
أُورد هذا المثال في سياق لفت الانتباه إلى فكرة مهمّة، قد تبدو غريبة، فالمدارس الغنيّة هي التي تنال التبرّعات والوقفيّات، بينما تكاد المدارس النائية تكون محرومة منها بالكامل.
إذا تأمّلنا في بعض المجتمعات، نجد وقفيّات كاملة مخصّصة للمدارس، ونجد أغنياء تلك المجتمعات يُخصّصون مبالغ ماليّة بشكل ثابت للمدارس في مناطقهم، مع أنّها قد لا تكون بحاجة فعليّة إلى ذلك الدعم المادّيّ. إلّا أنّ الأمر في المناطق النائية مختلف، فالمدارس فيها هي الأكثر حاجة إلى الموارد التعليميّة التي تجعل بيئة التعلّم فيها آمنة داعمة؛ لذلك، فإنّ هذه دعوة إلى أصحاب الوقفيّات بضرورة تخصيص دعم للمدارس المحرومة منه، والتي هي في أمسّ الحاجة إليه، ومحاولة بناء جسور من الشراكة والتوأمة بين مدارس الأرياف والمدن، تكون فيه مصلحة الطالب الدافع والمُنطلق للمحافظة على ديمومة هذا التواصل.
استثمار في المستقبل
لا ينبغي حصر العلاقة مع المدرسة في الإطار المادّيّ أو التبرّعات العينيّة، إذ إنّ أغلب سكّان المناطق النائية قد لا يملكون القدرة على تلبية احتياجاتها. بل إنّ توجيه الرعاية المجتمعيّة للمدرسة في هذا الاتّجاه قد يؤدّي إلى نفور الأهالي وشعورهم بالضيق، حيث يفسّرونه على أنّه تخلٍّ من الجهات الرسميّة عن مسؤوليّاتها.
تُجسّد هبّة أبناء قريتي سنة 2019 هذا الأمر بوضوح، حين أطلقوا حملة تبرّع لتركيب ألواح بيضاء للاستغناء عن الطباشير، فنجحت المبادرة في تلبية احتياجات مدارس القرية جميعها. غير أنّ محاولة تجديد الحملة لاحقًا، بالدعوة إلى تركيب أنظمة صوتيّة للإذاعة المدرسيّة، لم تلقَ الإقبال ذاته، ما أدّى إلى إلغائها. شعر الناس حينها أنّهم يتحمّلون عبئًا ليس من مسؤوليّتهم، وأنّ توفير هذه الاحتياجات ينبغي أن يكون من واجب الجهات الرسميّة لا المجتمع.
في المقابل، لو فُتحت أبواب المدرسة للمجتمع بعد انتهاء الدوام الرسميّ، لكان ذلك دافعًا إلى تعزيز اهتمام الأهالي بها ودعمهم لها. وهذه فكرة يجب أن تنال اهتمام المسؤولين، خصوصًا في المناطق النائية التي تفتقر إلى المرافق العامّة للترفيه وممارسة الهوايات. ففي هذه الحالة، تصبح المدرسة مكانًا حيويًّا يلبّي احتياجات المجتمع، ويجد في المقابل دعمًا مجتمعيًّا حقيقيًّا يفعّله ويقوّيه. لذلك لا بدّ من فتح قنوات دعم أخرى.
مثل هذه الأمور تؤكّد أنّ المدرسة استثمار للمستقبل، وأنّ دعم المدرسة يمكن أن يتحقّق في جوانب أخرى غير الدعم الماليّ. لذا، من الضروريّ تكوين رأي مجتمعيّ، يقوده المؤثّرون في المناطق النائية بالتعاون مع قادة المدارس، يتمحور حول الاهتمام المشترك بمصلحة الطلبة.
فعندما يتّفق المجتمع ومدير المدرسة على ترسيخ ثقافة الاهتمام بالمدرسة ومرافقها، وتعزيز احترام المعلّم وتقديره، يصبح ذلك خطوة أولى نحو بناء علاقة صحّيّة ومستدامة بين الطرفين. ففي المناطق الريفيّة النائية، نجد شخصيّات إصلاحيّة تحلّ الخلافات بين الناس وتتصدّر المجالس، والذين يمكنهم، بالتعاون مع مدير المدرسة، توظيف مكانتهم المجتمعيّة في توجيه تفكير الأهالي نحو نظرة أكثر إيجابيّة تجاه المدرسة وكوادرها.
مجالس التطوير التربويّ
يحرص قادة المدارس على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بين الأهل والمعلّمين، ويرغبون في الوقت ذاته بتنمية مهارات المعلّمين بطرق مختلفة، إحداها الاستفادة من خبرات أبناء المجتمع المحيط بالمدرسة، من الخبراء والمختصّين الذين تقاعدوا بعد سنوات طويلة من الخدمة العمليّة. من هنا جاءت فكرة إنشاء مجالس التطوير التربويّ.
راكم أعضاء هذه المجالس خبرات عميقة، يمكن توظيفها في النهوض بأداء المدارس في المناطق النائية، فإذا وجدت هذه الفئة الترحيب الكافي والتعاون المطلوب من قيادة المدرسة وكوادرها، يمكن لها أن تمهّد الطريق نحو المساعدات المادّيّة والعينيّة، عن طريق استثمار علاقاتها في المدن، وفتح قنوات التواصل مع المسؤولين، بهدف جلب الدعم اللازم لتحقيق الخطط والأهداف المتّفق عليها بين المتقاعدين الخبراء وكوادر المدرسة.
العلاقة بين المتقاعدين والعاملين ليست عشوائيّة أو خاضعة لرغبات أحد الطرفين، فيأتي ويغيب متى شاء، بل هي منظومة محدّدة الأدوار والمسؤوليّات. في الأردنّ، على سبيل المثال، نظّمت التعليمات الرسميّة هذا الأمر بوضع آليّات واضحة، تمكّن المدارس من الاستفادة من خبرات المتقاعدين، في اجتماعات توثّق نتائجها، وما يتمخّض عنها من قرارات.
تُناط بهذه المجالس مهمّات متعدّدة، مثل عقد دورات توعويّة وإرشاديّة للطلبة، وتطوير مهارات المعلّمين في مجالات الحياة، وأساليب التدريس، والتقويم. وفي بعض الحالات، تُنظّم دورات متخصّصة حول استخدام الأدوات في المشاغل والمختبرات، إلى جانب إقامة ندوات ومحاضرات وأمسيات تثقيفيّة تخدم المجتمع المحيط بالمدرسة.
وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أهمّيّة هذه المجالس، حتّى وإن لم تهتمّ بها الجهات الرسميّة، فهي مسؤوليّة مجتمعيّة تجاه المدرسة، يسهم فيها خبراء على دراية بالسياق المجتمعيّ المحلّيّ. ويمكن للوجهاء والمؤثّرين وأصحاب المكانة المجتمعيّة، بالتعاون مع قادة المدارس، وضع إجراءات تنفيذيّة تضمن استفادة المدرسة من خبرات المتقاعدين من أهل الريف، والذين يشكّلون إضافة هامّة، ويوفّرون دعمًا معنويًّا لدور المدرسة ورسالتها.
ما يميّز هذا المجلس أنّ الدافع المحرّك وراءه، رغبةُ الأعضاء الذاتيّة في خدمة المدرسة، فيحملون على عاتقهم مسؤوليّة دعم قدراتها لقيادة التغيير، وتخريج طلبة يمتلكون مهارات شخصيّة عالية، وتحقيق شراكة فعليّة مؤثّرة مع المجتمع، تقوم على الندوات والورشات التدريبيّة، أو الأمسيات الأدبيّة، أو مشاركة المدرسة في مناسبات المجتمع المحلّيّ والتفاعل معها، وتنظيم المدرسة لفعّاليّات لا منهجيّة بعد الدوام المدرسيّ. سيؤدّي هذا التفاعل إلى توازن مجتمعيّ قوامه القيم الإنسانيّة، وعماده الروح التطوّعيّة، ويمكن لهذه الشراكة أن تتطوّر، لتصبح وسيلة للتحسين والتطوير والمراقبة، والمساءلة.
تواصل وتعارف
أزعم أنّ كثيرًا من الآباء لا يعرفون أسماء معلّمي أبنائهم، وقد تكون الأمّ أكثر اهتمامًا بهذا الجانب، وغالبًا ما تتولّى التواصل مع المدرسة للاستفسار عن أبنائها. لا أريد إصدار حكم أو تعميم، لكن هذا ما لمسته طوال تجربتي معلّمًا. إلّا أنّ الأمر يختلف في الريف، إذ يزور الآباء المدارس بوتيرة أعلى، وغالبًا ما يكون ذلك برفقة الأمّهات، ونادرًا ما تذهب الأمّ وحدها.
تفرض البيئة الريفيّة المحدودة، إلى جانب قلّة الموارد الماليّة للأسر، وغياب المراكز الخصوصيّة التي تدعم الطلبة بعد المدرسة، ضرورة أن يتعرّف الأهل إلى المعلّمين والمعلّمات. لكنّنا نريد لهذا التعارف أن يتطوّر إلى أدوار أكثر تأثيرًا في تحسين تجربة تعلّم الطلبة. تخيّلوا لو أنّ الأب والأمّ يستخدمان المفردات نفسها التي يستعملها المعلّم، ولو أنّ البيت والمجتمع كانا على دراية كافية بما يدور داخل أسوار المدرسة!
لا ينبغي أن يُفهم هذا السياق على أنّه تهديد للطلبة، أو تخويف لهم من عواقب السلوكيّات غير المنتجة، بل هو تنسيق للجهود، ورعاية إضافيّة، ودعم متنوّع؛ إذ إنّ الغاية التي يسعى الأهل لتحقيقها لأبنائهم هي ذاتها التي تسعى المدرسة لها، فلا خلاف بينهما. وسيأخذ التعارف بين الطرفين منحًى نوعيًّا، حين يشترك الأهل والمعلّمون في فعّاليّات اجتماعيّة مشتركة، مثل مواسم الزراعة والأعياد والأفراح، إذ يمكن لهذه اللقاءات أن توجد لغة مشتركة ترسّخ العلاقة بين المدرسة والمجتمع.
سيكون الأمر أكثر فاعليّة إذا نُسّق بين المعلّمين الذين يدرّسون الصفّ نفسه وأولياء أمور الطلبة، ستصبح النقاشات أكثر ثراءً. بالإضافة إلى أنّ هذا التنسيق سيوفّر دعمًا خاصًّا للطلبة الأيتام، أو الذين يعانون مشكلات أسريّة، ما يجعلهم يشعرون أنّ جميع الآباء في الصفّ هم آباؤهم أيضًا، وسيشملهم الاهتمام والرعاية، ما يقلّل من شعورهم باليتم، ويعزّز التكافل بين أفراد المجتمع والمدرسة.
أمن وحماية
يؤدّي الفقر والبطالة في البيئات الريفيّة إلى مشكلات اجتماعيّة، والتي لا بدّ أن يكون للمدرسة دور في مواجهتها، لكنّها لن تستطيع وحدها معالجة تلك المشكلات، فهي تحتاج إلى تكاتف شعبيّ، وتضامن يرتقي إلى درجة أخذ زمام المبادرة بتقديم الدعم العينيّ والمعنويّ. فيشعر الطالب أنّ مغادرة أسوار المدرسة والعطلة لا تعنيان توقّف التعلّم أو غياب المساءلة، بل يوجد مجتمع واعٍ خارج سور المدرسة، يدعم جهدها ويتابع تنشئة الطالب. وفي الجهة المقابلة، فإنّ دعم المجتمع للمدرسة في البيئات الريفيّة يعني إلغاء الفوارق مع مدارس المدن، وتحسين البيئة التعليميّة فيها، واستثمار الموارد المتاحة في جعل الطلبة ينفّذون الأنشطة والمهمّات. وقد يكون الدعم المعنويّ للمجتمع دافعًا إلى جعل الطلبة يبتكرون ويتطوّرون، وحافزًا للمعلّمين والمعلّمات كي يضاعفوا الجهود، فتصبح قلّة الموارد الدافع الذي يحرّك المعلّمين والطلبة للاختراع وإعادة التدوير، لا سيّما إذا حصلوا على دعم مجتمعهم المحلّيّ.
هذه الحاجات لا تعني بأيّ حال من الأحوال تحميل الأهالي ما يفوق قدرتهم، فربّما يكون القليل ذا تأثير كبير عندما يُضاف إلى قليل غيره. إنّه نوع من التضامن والتكاتف الذي يحقّق نتيجة فعّالة، عندما يلتقي دعم المجتمع مع جهود المدرسة.
***
يُعدّ الدعم المجتمعيّ للمدرسة، سواء في المناطق النائية الأقلّ حظًّا، أو حتّى في مراكز المدن، استثمارًا حقيقيًّا في مستقبل الطلبة، بغضّ النظر عن نوعه أو حجمه، فهو يسهم في توفير بيئة تعلّم أكثر شمولًا، تواكب متطلّبات العصر، وتضع الطالب في إطار مساءلة إيجابيّة متنوّعة. كما يعزّز دور المدرسة لتكون مصدرًا للأمن المجتمعيّ، وعاملًا لاستقراره، ونموذجًا يُحتذى للبيئات المجاورة.
المراجع
- شمس الدين، أحمد. الوقف التعليميّ: سبق عربيّ وتفوّق غربيّ. (2025، 14 فبراير). الشرق الأوسط.
- وزارة التربيّة والتعليم الأردنيّة. برنامج تطوير المدرسة ومديريّة التربية والتعليم.

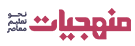


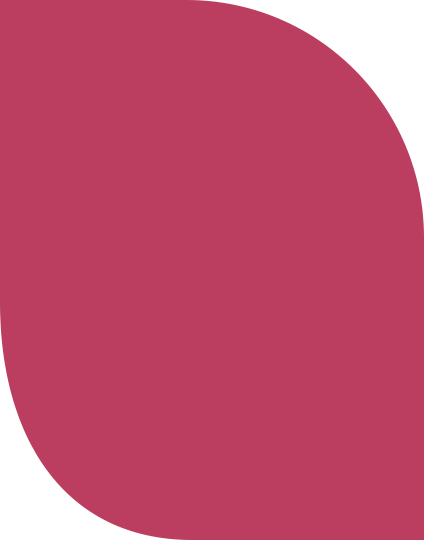

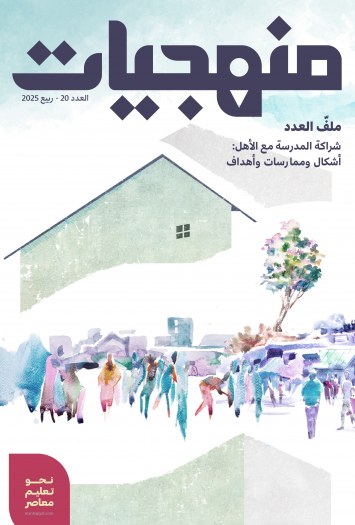






 نشر في عدد (20) ربيع 2025
نشر في عدد (20) ربيع 2025 

