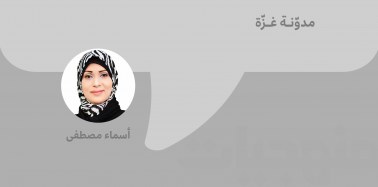لربّما وجدت إجابة سؤالي: لِمَ ما زلتُ على قيد الحياة إلى الآن؟!
في أحلك أيّام إبادتنا، ولياليها، في أشدّها ألمًا وحزنًا، ضيقًا وعجزًا، كنت أقول لنفسي: ما دُمتُ لا أستطيع أن أنتشل نفسي من ثقوب سوداء تبتلعني، كلًا وجزءًا، فالعجزُ يلفّني لفًّا. ما بيدي حيلة لأحمي صغاري، أو لأنتزع القلق والخوف من قلوبهم. وهم لا يرغبون بأيّ فعل سوى اللعب هربًا من متاهات القلق. منطقتي ليست آمنة طوال شهور طويلة من الحرب، فلا يُمكنني أن أعمل وإن تطوّعًا، في مجالي مع طالباتي. لا أستطيع أن أُحدث فرقًا في أيّ زاويةٍ من زوايا حياة غيري، أو حتّى حياتي. بدأت حتّى أتخلّص من كلّ ما يعني لي في هذه الحياة... فقد كلّ شيءٍ قيمته، وكدت أنزع عنّي ثوب التجمّل والتحمّل في معاملة الآخرين وإن أساؤوا؛ فلم تعد عندي طاقة على الصبر على أذى أحد، فوق أذى ما نعيشه من إبادة وحصار وحرمان من أبسط الاحتياجات الأساسيّة.
واشتدّ الفكر يأسًا وانغلاقًا مع مأساويّة النزوح...
حتّى عُدنا إلى منطقتنا، وقد غدت شبه إنسانيّة و"بعض" آمنة. شجّعني أحدهم لأنطلق، فعُدتُ إلى العمل على كتابي. بدأت الطاقة تتسرّب إليّ تدريجيًا، لأنتشل أبنائي وطالباتي معي. بدأت مبادرة "ثقوب سوداء" منذ يونيو، من وسط سواد لفّ حياتنا، وكسا جدران بيتي الحبيب.
جميعنا جرحى بدرجاتٍ متفاوتة، وكلّنا بحاجة إلى يدٍ حانيّة تمسح على جراحنا ،علّ الألم يهون.
وجدت فتياتٍ غارقات في الحزن والألم والدموع أكثر منّي بدرجات وطبقات؛ فأحسنهنّ حالًا فقدت منزلها أو جزءًا منه. ومنهنّ من فقدت والدها شهيدًا. ومنهنّ من بقي والدها في عداد المفقودين، ولا يُعلم له أثر. ومنهنّ من لم تودّع والدها. ومنهنّ من لا تدري عن والدها وأخيها الذي غلّه الأسر وأخفاه. والأشد بؤسًا، تلك التي خرجت من تحت أنقاض منزلها حيّة، بعد أربعة أيّامٍ تحت ظلمات الركام والخوف والفقد. بعدما شهدت استشهاد أفراد عائلتها، واحدًا تلو الآخر، تحت ذاك الركام. ورأت ارتخاء رأس أختها استسلامًا للموت، على حجر بائس، ثمّ شعرت بانقطاع أنفاس والدها بينما هو فوق رجليها، والركام فوقه.
سرنا معًا نشدّ على أيدي بعضنا، في خطٍّ ومسارٍ وهدف واحد. نطبطب على أرواحنا المُنكسرة وجراحنا النازفة. كان بعضهنّ مستمعًا فقط، وكان بعضهنّ لا يُشارك إلّا بالنذر اليسير. ولم نكتشف ما لدى البعض من مواهب وقدرات بسبب انسحابهنّ مع لطمات أمواج الحزن.
وها هم الآن بين يدَي. ما زالت الدموع تتساقط من حين إلى آخر. وما زالت بعض الحوارات تعيدهنّ إلى أشدّ اللحظات خوفًا وألمًا وحسرةً، فيعدن إلى سرد القصّة من جديد، ونسمعهنّ من دون ملل.
ولكنّهنّ الآن أيضًا يضحكن، ينشدن، يرسمن، يعبّرن، يكتبن، يندهشن، ويُصدمن. يحلّلن ويخطّطن وينفّذن، بل ويبدعن. يُشاركن بكلّ فعّاليّة عن رغبة وقناعة، بشغف وفضول، وكأنّ في كلّ فعّاليّة ننفّذها فرصة للنجاة.
وبعد انطلاقهنّ، وتمكنهنّ من النجاة من ثقوبهنّ السوداء، رأيت ما لم أكن أتوقعه في أكثرهنّ من مشاركات وإبداعات وتميّز وحنان وعطاء وتعاون وحرص على مساعدة الأخريات ودمجهنّ.
عملنا معًا، ونحن نعيش عوالم ازدواجيّة تجمع بين واقع وخيال، ونتنقل ما بين ماضٍ وحاضر ومستقبل. تنهال عليّ التساؤلات بعد كلّ تقدّم في السياق، وكلّما وصلنا إلى تبئير جديد، غموض ولهفة. حتّى أكاد لا أتمكّن من سماع التساؤل الأوّل، فيكون التالي يُسابقه، لتكون التساؤلات الملحّة دافعًا إلى البحث العميق.
سياق وعمل قمّة في الحماس والتفاعل والإثارة. مليء بالمشاعر (خوف؛ رهبة؛ حماس؛ شجاعة؛ إقدام؛ قشعريرة؛ فخر؛ ألم؛ حزن؛ يأس؛ أمل؛ ضحك؛ شهقات؛ دموع؛ ثقة؛ إحباط؛ شدّ أعصاب) والمعارف والإضافات العلميّة والثقافيّة التي كان بعضها بمثابة صدمات معرفيّة للمشاركات. قادهم كلّ ذلك إلى حوارات معمّقة تلقائيّة مع الأهل، شكّلت انخراطًا للأسرة في الفكر الذي تنقله المشاركات: صراع بين القيم والأفكار؛ تحليل من منظور علميّ ودينيّ، قيمي وأخلاقيّ وإنسانيّ؛ مقترحات تسحب الفكر إلى عالم ما وراء المعرفة، وتقود إلى تساؤلات أكثر توسعًا وعمقًا؛ بحث تقوم به الطالبات من دون تكليف، بدافع الفضول والنهم لمزيد من إجابات شافية؛ إبداعات جديدة ومستمرّة من مشاركات تميّزن بشغف الإنجاز والإتقان.
السابق وأكثر يتحقّق في كلّ لقاء لنا، بعد أن يُكتب لنا استمرار في الحياة.
"ثقوب سوداء" بدأت حين بدأت الحرب. وكلّما تعمّق أذاها ازدادت الثقوب سوادًا وجذبًا، حتّى أصبحت رُعبًا أسود، يسحبنا بعيدًا عن حيواتنا، عن ذواتنا، عن مزايانا وإمكانيّاتنا، طموحاتنا وأحلامنا وآمالنا التي لطالما رسمناها مع أنفسنا، ومع شركائنا في العيش. تُغرقنا وسط الموت والهدم والدمار والنار. تصمّ آذاننا سوى عن أصوات صواريخ نهايتنا، وقذائف تدمير بنائنا وذكرياتنا. تُعمي أعيننا سوى عن ألوان النار والدم. نيران تحرق كلّ ما أنجزنا في هذه الحياة، وتحرق ذواتنا. مقيّدون وسط آثار إبادتنا وتبعاتها، فَقدِنا، فلا الأمر يقتصر على أسباب الموت والدمار المهول، وإنّما تأبى إلّا أن تحيط بنا التبعات كأشباح تلتهمنا: نزوح وتهجير؛ نزاعات وخلافات؛ أعباء تتفاقم، وصعوبات تقتلع حكمة أكثرنا عقلًا ورجاحة فكر.
وإذ بنا نفتح أعيننا فلا نرى سوى سواد يجذبنا إلى أعماقه. ويُنسينا كيف كنّا مصدرًا للأمل والإلهام والطموح، العمل والإنجاز، الإفادة والتحدّي... إنّها الثقوب السوداء.
نتأمّل بعض ما تبقّى لنا من صور ودروع وأدوات، تُذكرّنا تدريجيًّا وببطء شديد، بما كنّا عليه. تنهضنا من وسط يأسنا وكآباتنا، لنحاول من جديد.
نبدأ العمل مجبرين أنفسنا لا راغبين، لأنّنا نُدرك أنّ لا شيء يُعيد بثّ الروح فينا سوى العمل والتواصل والإفادة. سوى وجود هدف نسعى له، فيشحذ همّتنا ويكسر حلقات كآباتنا. وبالعمل مع فتيات التهمت الحرب من أرواحهم ونفوسهم وعقولهم ما التهمت، غارقات تائهات، نمسِك بأيدينا جميعًا معًا، نتعاهد على ألّا يغرق أحدنا، ونمضي مثقلين نجرجر أرواحنا، نشحن عقولنا، ببطء شديد. نستعيد أنفسنا، ثقتنا، أملنا... معًا.
وبعد أن يتعمّق انخراطنا في العمل، يعود الجيش إلى مهاجمة حبيبتنا مدينتنا، سكننا وطمأنينتنا، فنُجبر على أن نغادرها نازحين، مجرجرين فتات انكسارات أرواحنا، وتحطّم بنائنا الذي بدأناه للتوّ.
نعود إلى مدينتنا، يقهرنا كمّ الدمار المهول الذي لا تصفه الكلمات، يزعزع نفوسنا، يحرق أرواحنا، يقتل كلّ أمل ما زال ينبض فينا. نتردّد كثيرا في العودة إلى استكمال مشروعنا الذي بدأناه. لكنّ المشاركات يُصررن على العودة إلى العمل والتعلّم، فتبثّ فيّ الروح من جديد لأكون الشعلة التي تُضيء طريقهنّ، لأكون كما يرينني وكما يأملن منّي؛ فلا أخذلهنّ، لا أسحب القشّة التي تشبّثن بها خوفًا من الغرق في ظلمات ثقوبهنّ.
ونعود إلى العمل عبر سياقات أكثر إحكاما وتطويرًا..
نتمكّن في كلّ سياق درامي نعمل عليه وفيه، من النجاة من أحد ثقوبنا السوداء. ننّمّي وعينا. ندرس الواقع ونحلّله فلسفيًّا ونفسيًّا وعقائديًّا واجتماعيًّا ونفسيًّا. ننقده، نقترح البدائل.
نتأمّل الشخصيّات والأفعال والأقوال وما وراءها: الدوافع والمشاعر والقيم.
ننطلق في موضوعات علميّة، نتفحّصها من منظورات أوسع وأعمق، وأكثر إثارة وفضولًا ممّا كنّا ندرسه في منهاجنا الرسميّ. نربطه بكافة المجالات: فنّيّة، علميّة، دينيّة، جغرافيّة، تاريخيّة، بيولوجيّة، جيولوجيّة وفلكيّة، فلسفيّة ونقديّة، نفسيّة وشخصيّة ولغة جسد وإشارات ورموز. ونضفي عليها المصطلحات الإنجليزيّة لنوّسع ثقافاتنا وخبراتنا ومهاراتنا اللغويّة. نعايش الدور والشخصيّة، وسط المكان والزمان، ونتأمّلها بعمق. نصفها وندرك دوافعها ومشاعرها. نعبّر عنها بصور ولوحات وتماثيل ومشاهد وسيناريوهات. نستنطق أفكارها لنولّد فهمًا عميقًا للآخر. نتخيّل طبيعة الحوار بين الشخصيّات وطرق الإقناع. نضع الخطط والقوائم. ونصمّم النشرات. ونكتب من داخل الدور وخارجه، مذكّرات ورسائل وقصص ويوميّات. نبحث بشغف كبير، لا كواجب نؤدّيه لننتهي منه. بل لنعرف المزيد، ولنجد إجابات تساؤلاتنا التي أثارها الغموض، وحفّزتها الدهشة والصدمة والخوف والترقّب، وسط الحدث المتخيّل في السياق.
تنخرط المشاركات في العمل، إلى الحدّ الذي أحاول أن أنترعهنّ منه انتزاعًا. أنادي بحلول وقت الاستراحة حيث سنوزّع الضيافة ونتسامر قليلًا. يرفضن ترك العمل. يأبين إلّا أن يتمّمنه، وبأعلى درجات الدقّة والإتقان والإبداع التي تُهيّئها لهنّ الإمكانيّات والظروف. وبعد إنهاء البحث والتلخيص والترتيب والتنظيم، بأشكال فنيّة متنوّعة، يبدأ الاستعداد للعرض؛ يحرص كلّ منهنّ على أفضل دقّة في المعلومة، وأفضل أداء في العرض. يطرحن الكثير من التساؤلات الاستيضاحيّة، فأجيبهنّ وكلّي إعجاب بهنّ وبحرصهنّ وبإنجازاتهنّ.
أوسّع أبعاد العمل، لتشمل تدريبهنّ على بعض برمجيّات رقميّة. وهذا أمر صعب جدًّا في ظلّ انقطاع الكهرباء، وصعوبة شحن الأجهزة. ولكنّهن يستحققن ذلك لاجتهادهنّ العظيم، ونهمهنّ للتعلّم والاستفادة، وتطبيقهنّ كلّ ما أعلّمهنّ إيّاه. نتدرّب معًا على تصميمات هندسيّة للمباني والشركات والبيوت ثلاثيّة الأبعاد، وتصميم الخرائط الذهنيّة الإلكترونيّة، والنشرات التوعويّة الإلكترونيّة. جميعها عبر تطبيقات الواقع المعزّز، والتجارب العلميّة الافتراضيّة عبر برمجيّات المعامل الافتراضيّة، فيُبدعن كما عهدت منهنّ.
أتساءل من أين أتت هذه الطاقة والإبداعات والانخراط؟ لماذا لم أكن أراه إلى هذه الدرجة حين أعلّم في المدرسة، موظِّفة النهج نفسه (دراما تكوّنيّة وعباءة خبير متضمّنين منحى STEAM)؟
وبينما أدرس وأحلّل الاختلافات، أجد ما كنت أقوله دائمًا، حقيقةً وفعلًا واقعا، كم كنّا نضيّع الوقت والجهد والفرص: في أعباء المناهج وتكدّسها؛ وتتابع الحصص الدراسيّة بلا فاصل كافٍ بينها، للاستراحة أو لتناول ما يمدهنّ بالطاقة؛ وانعدام الجوانب الترفيهيّة تقريبًا؛ ونظام الاختبارات التي تحكم على الطالب، متجاهلة جميع قدراته وإمكانيّاته وإبداعاته وشخصيّته؛ ونظام المدارس وقوانينها التي تجبر الطالب إجبارًا على كلّ شيء، حتّى تجعل من لديه نهم التعلّم يملّ ويتمرّد، ليس لأنّه فاشل أو مهمل، ولكنه لا يستشعر أنّ لاحتياجاته الجسديّة والنفسيّة قيمة، أو لمهاراته ومواهبه متّسعا كافيًا لتبرز. عليه فقط أن يدرس ويحفظ، ويفرّغ معلومته في الاختبار بأعلى كفاءة، ويطيع القوانين إلى أعلى حدّ ممكن، وإلّا فسيتعرض إلى الكثير من النقد.
أسأل المشاركات ما المميّز في عملنا معًا، ويجعلكن تخرجن إبداعات، وتُبدين انخراطًا في العمل، واستمتاعًا أكبر بكثير ممّا تفعلن داخل المدرسة؟
فيُجبن: انقطعنا طويلًا عن مجالس العلم والتعلّم، حتّى بلغ منّا الاشتياق إليها ما بلغ. وعشنا وسط المشاكل والصعوبات والقهر والنزوح والفقد، حتّى كدنا ننسى أنّ هناك حياة تضيف إلينا لا تسلبنا. حياة نستكشف فيها ذواتنا ونطوّرها ونبنيها، لا تهدمنا.
أدركنا أنّ مجالس العلم والتعلّم متعة عظيمة، وفضل كبير، ورقي وسموّ، نُزِعت منّا طوال عام تهنا فيه بعيدًا عن بوصلتنا التي تهدينا لأهدافنا ومساعينا. وانهارت خلاله ثقتنا بأنفسنا.
نحن هنا نبحث لأنّنا نرغب بذلك. نطيل العمل في البوسترات، وفي مجموعات، لأنّنا نريد أن يكون عملنا مميّزا، فهو يعبّر عنّا فعلًا . في المجموعة، لا نشعر أنّ هناك شخصًا أفضل وأعلى، وشخصًا أقلّ قيمة. نحن جميعًا متساوون. نتشارك ونتشاور في الفكرة والشكل والمخرَج، ونوّزع الأدوار. كلّ ينال ما يحبّ. لا أحد مجبر على فعل شيء لا يرغب فيه. في المجموعات نحن من يختار شركاءنا، فنختار صديقاتنا اللاتي نتوافق معهنّ فكرًا ونفسًا، بينما في المدرسة يُبعدوننا عن أصدقائنا كي لا نتشتّت ولا نُحدث الفوضى. لا يعلمون أنّ بقاءنا مع أصدقائنا يشجّعنا ويرفع طاقتنا أضعافًا، ويسهّل الفهم والتفكير. لا نخجل من جهلنا، بل نتساءل فنتعلّم. لا أحد يسخر منّا. فلا حاجة إلى الخلاف ولا الخوف. حتّى أنّ ذلك يُيسّر علينا تقبّل أشخاص جدد في مجموعاتنا، وفي علاقاتنا. بل ونرغب في التعرّف إلى الآخرين؛ فمع صديقاتنا نكون أكثر ثقة وقوّة، حتّى من ناحية تفاعل اجتماعيّ مع الأشخاص الجدد. كما إنّ التشجيع يكون للجميع على حدّ سواء، وبالقدر نفسه. فلا نحزن على إنجاز تعبنا فيه ولم ينل التقدير الذي يستحقّ، ولا نقارن عملنا بالآخرين من باب الغيرة، بل من باب تطوير أفكارنا وتوجّهاتنا. فنحن جميعًا متساوون في العمل والهدف والإنجاز والإبداع. لا توجد درجات تقارن بيننا، بل مخرجات تُبرز جهدنا، ومعلّمة وزميلات يشجّعننا حتّى وإن كان عملنا أقلّ من الآخرين.
أمّا حول انغماسهنّ في الأفكار والثقافات التي يكتسبنها بسياقات الدراما التكوّنيّة والعباءة، فإنّهن يعدن إلى البيت، ولا يتوقّف معظمهنّ عن الحديث حول فعّاليّات لقائنا داخل المشروع، مع عائلاتهنّ طوال يومهنّ. وفي بعض الموضوعات الأكثر إثارة للعقل والفكر، تندمج العائلة في الحوار، فيطرحون التساؤلات ويتعجّبون مما تضيفه المشاركات إلى أسرهنّ. وكم أحبّ حين تأتي طالبة لتخبرني أنّها ناقشت مع أحد والديها موضوعًا ما، وقد أخبرها بمعلومة تخالف ما عرضته عليهنّ وناقشناه؛ فإمّا يضيف إلينا الجديد، أو يفتح المجال لتعلّم أوسع وفهم أعمق، ولأناقشهنّ في كيفيّة التحقّق من المعلومات: كيف ننقّحها ونتأكّد من صحّتها بالعقل والمنطق؟ أو بتحديد مصدرها؟ كاتبها؟ كتابها الذي وردت فيه؟
نحن في مشروعنا نعمل معًا، معلّمة وطالبات. نبحث ونتطوّر، ونبني ثقافاتنا وتوجّهاتنا وقيمنا ورمزيّاتنا. نفهم الآخرين ونحلّل دوافعهم. نحدّد الفكر والفعل الأنسب، تبعًا للمنطق والظروف. نتعرّف إلى النموذج الذي تعلّمنا منه كيفيّة الفعل. ونُدرك الاستثمار الذي يجب أن نصل إليه بتنوع تعلّمنا وسعته. نعي بشكل أوسع أدوارنا في عائلاتنا وأسرنا ومجتمعاتنا وأمّتنا. وفي النهاية نبني منظورًا للحياة يتمثّل في مبادئنا وقيمنا التي نبني عليها قراراتنا ومساراتنا، والتي نستند إليها حينما تعصف بنا الحياة من كلّ جانب، فتشتّتنا وتهزّنا؛ لنكون في النهاية على أتمّ استعداد لنواجه مستقبلنا بكلّ ما أضفناه إلى أنفسنا، من خبرة ومهارة وعلم وما طوّرناه في أنفسنا من مهارات شخصيّة واجتماعيّة، وما تميّزنا به بالتدريب والإعداد لنكون الأفضل والقدوة والنموذج لأبنائنا ومحيطنا.
وها أنا الآن أُدرك تمامًا لما ما زلتُ على قيد الحياة...