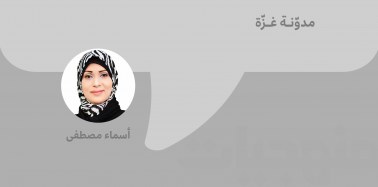سؤال لطالما راود الكثير من المهتمّين بقضايا التنمية والتعليم وتحدّيات النهضة، فعلًا هل ينتج التعليم شيئًا؟ وهل ما ينتجه يحمل طابعًا مادّيًّا أو معنويًّا؟ وما علاقة ذلك بالتنمية الاقتصاديّة والبناء الحضاريّ للشعوب؟
إنّ الإجابة عن هذه الأسئلة هي التي تحكم، في الأخير، على المستوى الثقافيّ والفكريّ لأيّ مجتمع، ومدى قدرته على تقديم الإجابة المناسبة عن أسئلة الحضارة والتنمية، ومن خلال ذلك تفترق المجتمعات ما بين صانعة للحضارة، ومن هي على هامش الحضارة، ومن تناصب العداء للحضارة.
لا يمتري اثنان في أن التعليم هو عماد نهضة الشعوب في الأزل وللأبد، لكن جدلية التعليم- التنمية تظلّ من أكثر القضايا التي تشكّل تحدّيًا مؤرّقًا لأنظمة العالم الثالث، التي لم تتبلور لديها الإرادة الكافية والوعي اللازم للاستثمار في التعليم، وتحويله إلى قاعدة ارتكاز للانطلاق في مشاريع التنمية والبناء، إذ ما يزال ينظر إلى التعليم عند القادة السياسيّين لهذه الدول، على أنه قطاع عموميّ خدماتيّ يستنزف من خزينة الدولة ميزانيّة ضخمة دونما أثر مادّيّ محسوس، وحتى هذه الميزانية ينصرف جُلّها إلى التجهيز دون التكوين والتطوير، لذا فلا يشغلها منه أَرَبٌ سوى ضمان الحدّ الضروريّ من الخدمة العامّة التي يحتاجها المجتمع من التعليم، أمّا قضايا الاستثمار في التعليم، وتطوير الكوادر التعليميّة، والمناهج وجودة التعليم وتنافسيته واقتصاداته، وتحسين أوضاع المعلّمين والباحثين والمخترعين، وتنمية مراكز البحث العلميّ، فهي مسائل ليست ذات أولويّة في المنظور السياسيّ لهذه الدول!
أما لدى المجتمعات صانعة الحضارة، وهُنا لا أقصد نموذجًا بعينه وإنما كلّ المجتمعات التي أسّست منتجًا حضاريًّا من المستقدمين أو المستأخرين، فمؤسّسات التعليم تُعتبَر بالنسبة لها مَشَاتِلُ لتنشئة وتنمية رأس مالها الفكريّ والمعرفيّ والبشريّ، كما أنها تتوجّه وتسترشد في سياساتها العامّة انطلاقًا من مؤشّرات التعليم، فبناء على مخرجاته تتحدّد أوضاع ومستويات التنمية في القطاعات الأخرى سلبًا أو إيجابًا، إذ يمثّل التعليم القيمة الحقيقيّة والمقياس المرجعيّ لهذه المجتمعات على نجاح سياساتها العامّة أو إخفاقها، فهو القلب النابض الذي يبعث بالدماء عبر الشرايين إلى مختلف أعضاء الجسم لتؤدّي وظائفها الحيويّة بكفاءة.
ولهذا يحظى الموقع الاجتماعيّ للمعلّم والأستاذ والباحث، في هذه المجتمعات، بالصدارة والأولوية القصوى في السلّم التراتبيّ للقيم والوظائف والمسؤوليّات، ويوليه ساستها عناية بالغة قد تمثّل ضربًا من الخيال لدى غيرهم من الشعوب الأقلّ اهتمامًا بالتعليم وأهله، وليس هذا سوى تعبيرًا عن الوعي المتجذّر بالأدوار الاستراتيجيّة للتعليم وعلاقته المباشرة بالمسألة الحضاريّة وجودًا أو عدمًا.
وإذا أردنا أن ندرك، بطريقة حسابيّة، القيمة الاستراتيجيّة لمنتجات التعليم باعتباره موردًا خلّاقًا للأفكار والقيمة المضافة في اقتصادات المعرفة فلننظر، مثلًا، إلى الهاتف المحمول، Mobile، الذي تنكمش تكلفة خاماته لتشكّل عُشُرَ ثمنه تقريبًا، معنى هذا أن الفرق بين هذه التكلفة وبين سعر البيع هي القيمة المضافة، التي خلقتها عقول البشر كمصمّمين ومبتكرين ومطورين. انظر إلى الشخصيّة الشهيرة بيل جيتس Bill Gates، الذي اشتهر بأنه أغنى رجل في العالم، من أين جاءت ثروته؟ لقد جاءت من برامج الحاسب، وهي سلعة لا تعتمد على الموادّ الخام بل تعتمد على المعرفة الهائلة في عقول العاملين في شركته "مايكروسوفت Microsoft"، ويرى جيتس أن العامل الأساسيّ في نجاح شركته هو خيال وابتكار العاملين بها. "هذا هو أبلغ مثال على عصر اقتصاد المعرفة الذي تلا عصر الصناعة، والذي يتطلّب استثمارًا مكثّفًا في البشر، في تعليمهم وتدريبهم وتحفيزهم على الابتكار ليصبحوا قادرين على المنافسة في عصر قادم ستكون المنافسة فيه بالمعرفة وليس بالمادة الخامّ أو بمجرد توافر الآلات والتجهيزات".
إنّ التعليم هو المولّد الأساسيّ للمعرفة، والمجتمعات التي تمتاز بجودة التعليم هي المجتمعات المتفوّقة صناعيًّا وعلميًّا، ذلك أنها ركّزت على تطوير حاضنات المعرفة من المدارس والمعاهد ومراكز البحث والجامعات، ومنحتها الأولويّة والاهتمام الأكبر من حيث التمويل والاستثمار، لأنها تضمن لها استمرارية رأس مالها الحقيقيّ، الذي هو السبب الأساسيّ لأي تفوّق أو ربح أو ميزة تنافسيّة، فالتعليم يمثّل لها ركيزة الاقتصاد والتنمية ومصدرًا منتجًا لرأس المال البشريّ الذي تحتاجه بقيّة القطاعات، فإذا صلح التعليم صلحت باقي القطاعات وانتعشت، وإذا فسد التعليم فسدت باقي القطاعات وانتكست.
وفي سياق متصل، يؤكّد الخبير ألفن توفلر Alvin Toffler، أنّ "المعلومات هي أهمّ مادّة أوليّة على الإطلاق، وهي مادّة لا يمكن أن تنفذ أبدًا. ونظرًا لتزايد أهمّيّة المعلومات عمّا كانت عليه من قبل، فإنه يتعيّن على حضارتنا المعاصرة إعادة النظر في نظم التعليم، وفي تنظيم البحث العلميّ".
ولعلّ هذا الذي جعل رئيس وزراء سنغافورة السابق، لي كوان يو Lee Kuan Yuw، ينتبه مبكّرًا، وبشكلٍ ينمّ عن وعي الطبقة السياسيّة بأولويّات التنمية، إلى أن التعليم هو أولى خطوات التطوير الشامل، فقال: "الدول تبدأ بالتعليم، وهذا ما بدأت فـيه عندما استلمت الحكم فـي دولة فقيرة جدًّا، اهتممت بالاقتصاد أكثر من السياسة، وبالتعليم أكثر من نظام الحكم، فبنيت المدارس، والجامعات، وأرسلت الشباب إلى الخارج للتعلّم، ومن ثم الاستفادة من دراساتهم لتطوير الداخل السنغافوريّ".
أمّا محمّد مهاتير، رئيس وزراء ماليزيا ورائد نهضتها، فيؤكّد على أن التعليم كان هو سرّ نجاح مشروعه التنمويّ فيقول: "التعليم هو سبب نجاح التجربة الماليزيّة، ونقلها من العالم الثاني لتصل إلى مصاف الدول المتقدّمة"، مُضيفًا أن ربع الميزانية كان مُخصّصًا للتعليم.
تلك هي الحقيقة السرمديّة التي أكّد عليها المفكّرون عبر التاريخ الإنسانيّ، وأكدّها محمّد عبده، رحمه الله، في قوله: "إن الذين يرومون الخير الحقيقيّ لوطنهم، يجب أن يوجّهوا اهتمامهم إلى إتقان التربية ونشر التعليم، إذ إنّ إصلاح نظام التربية والتعليم في البلاد يجعل وجوه الإصلاح الأخرى أكثر يسرًا".
إن التعليم يساهم، بصفة مباشرة وغير مباشرة، في تحقيق المكتسبات الحضاريّة التالية:
1. تحسين مستويات التفكير لدى الأفراد وتنمية قدراتهم العقليّة، كالخيال العلميّ والإبداع والتفكير الابتكاريّ والنقد العلميّ.
2. التعليم والتعلّم هو المصدر الأساسيّ لإنتاج المعرفة وتوليدها وتطويرها عبر المشاركة والممارسة.
3. يساهم التعليم في تخفيض مستويات الأمّيّة والفقر والتخلّف، لأنه يمنح الفرد فرصًا أكثر للارتقاء الاجتماعيّ وتنمية الذات.
3. يرتبط التعليم بصفة مباشرة بالاقتصاد المعرفيّ والذكاء الاصطناعيّ، وهي أهمّ مجالات الاستثمار في العصر الحديث.
4. التعليم يساهم في رِفَادَةِ مشاريع التنمية المستدامة والقطاعات الحيويّة للدولة، من خلال إمدادها بالنوعيّة اللازمة من الموارد البشريّة المؤهّلة معرفيًّا ومهاريًّا.
5. التعليم هو مصنع الإنسان المفكّر والناقد الفعّال، المتميّز فكرًا وسلوكًا، والجدير بأداء المهام الحضاريّة، وإرساء معالم البناء النهضويّ للدول.
6. إنّ المعلّم، من خلال أدائه التعليميّ والتربويّ وأدواره الحضاريّة في المجتمع، يستأثر بالمهمّة الأصعب في سياسة البشر، وتنمية مداركهم العقليّة والنفسيّة، وتطوير مهارات التفكير لديهم وإعدادهم للمستقبل.
7. يتأكّد الدور الحيويّ للتعليم في عصر التكنولوجيا الرقميّة والثورة الاتصاليّة والعولمة المعرفيّة التي انتهت إليها مجتمعات المعرفة والمعلومات، أي أصبح التعليم سببًا للبقاء والنماء، فمن لم ينافس على مصادر المعرفة المتقدّمة، فالموت الحكميّ سيكون مصيره.
8. يساهم التعليم في العصر التكنولوجيّ في قدرة مؤسّسات الدول، لا سيّما الصناعيّة منها،على تحقيق الكفاءة الإنتاجيّة، فالتعليم المستمرّ يمنح العامل امتيازًا مهاريًّا في الأداء، بحيث سيتمكّن من ترشيد تكلفة المدخلات وتقليص زمن الإنتاج وتعظيم المخرجات، مع الحفاظ على القيمة المضافة ومستوى جودة المنتج.
9. إن التعليم يرفع من كفاءة الأداء المؤسّسيّ لمؤسّسات الدولة، ويجعلها قادرة على تحقيق معايير الجودة والتنافسيّة في شتّى القطاعات.
10. التعليم يحسّن من أذواق وتصوّرات وسلوكات أفراد المجتمع، ويجعلها منسجمة مع المنطق العلميّ السليم، والحسّ المدنيّ الراقي، والتوجّهات الحضاريّة للمجتمع.
وبناء على ما سبق، ندرك مدى فداحة الخطيئة الحضاريّة السائدة لدى أغلب القادة السياسيّين والحكومات في عالمنا المتخلّف، التي تقضي بعدم جدوى الاستثمار في التعليم ظنًّا بأنه استثمار متهالك ولا يقدّم عوضًا مادّيًّا يوازي ما يُنفَق عليه من ميزانيّات، والحقيقة على خلاف ذلك تمامًا، فقد أكّدت التجارب الإنسانيّة في التنمية البشريّة والبناء الحضاريّ، أن كلفة الإنسان الجاهل والأمّيّ على المجتمعات هي باهظة ومتزايدة مع الزمن، لأنه من خلال ممارساته التي تكون في غالبها معطّلة للتنمية ومعرقلة لمسيرة الحضارة، سيكبّد الدولة خسائر وتكاليف مضاعفة في مشاريع الصيانة وإعادة التهيئة، والإصلاحات المتكرّرة جرّاء الممارسات السلبيّة المعادية للحضارة والتقدّم والمدنيّة، وهي تكاليف تفوق كثيرًا ما تنفقه الدولة لأجل تطوير التعليم وازدهار البحث العلميّ، الذي يعود عليها بمردود أعظم. كما أنّ ما تنفقه الدولة على جميع القطاعات الاقتصاديّة الأخرى، سيفقد فاعليّته ونجاعته بسبب غياب الكفاءة والعنصر البشريّ المتعلّم القادر على الاستثمار الجيّد، وتوظيف معارفه وذكائه في تخفيض كلفة المدخلات وتحويلها إلى مخرجات أكبر، وتقليص حجم النفقات من خلال ابتكار طرق عمل أكثر فاعليّة. وفي هذا السياق، يقول د. فيكتور شيا، خبير الجودة في كوريا الجنوبيّة: "لا توجد دولة تتحمّل إنتاج جيل كامل دون تعليم جيّد، فهذا الجيل سيدمّر الدولة داخليًّا لتتفتّت وتفقد وجودها".
فالاستثمار في التعليم تظهر نتائجه، بصورة غير مباشرة وعلى المدى المتوسّط، في كل القطاعات والمجالات الحيويّة الأخرى، وهي نتائج مؤكّدة ومضمونة، وليست من قبيل المخاطرة والمغامرة، وهو ما يؤكّده المثل الصينيّ القائل: "إذا أردت أن تزرع لسنة فازرع قمحًا، وإذا أردت أن تزرع لعشر سنوات فازرع شجرة، أما إذا أردت أن تزرع لمئة سنة فازرع إنسانًا".
إن التعليم يعتبر الركيزة الرئيسيّة لأي نهضة تقدّميّة وحركة فعّالة عبر الزمن، فهو روح الأمم، وبقدر ما تحمله هذه الروح من قيم إيجابيّة، بقدر ما تكون طاقة الأمم وحركيّتها في التغيير أقوى وأكثر حيويّة. ونظرًا لما أفرزه مجتمع المعرفة من تحدّيات ومتغيرات، فإن على الدول أن تواكب هذه التغيّرات، وسبيل ذلك يكون بإصلاح التعليم وتطويره والاهتمام بالبحث العلميّ وتنميته، لترقى إلى مستوى التحوّلات التي تشهدها الحضارة المعاصرة.