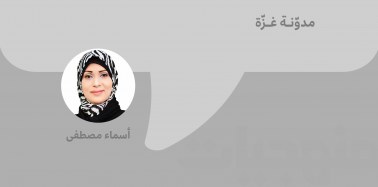في أحيان كثيرة، وعبر كلّ ربوع الوطن العربيّ، وأحسب أن الأمر يسري على بقيّة الرقع الجغرافيّة في العالم، طالعت أيّما مرّة في "فيسبوك" أخبارًا مفجعة، شاذّة؛ خارجة عن المألوف، تكاد لا تصدقها أذن، لولا تأكيد بعض المنابر الإعلامية هكذا أحداث. هذا المكان الافتراضيّ الذي أصبحت هجراتي إليه، وإن كانت متباعدة، تفتح إدراكي على فداحة تأثير الدين الرقميّ الجديد، الذي اعتنقه الكبراء قبل العوام.
اغتصاب أستاذة وقتلها من طرف مجهولين؛ تلميذ يعتدي على مدرّس داخل الفصل باللكمات والرفسات وأصدقائه يوثّقون المشهد بهواتفهم؛ أستاذة تتعرّض للتحرّش داخل مؤسّسة تربويّة؛ اعتداء بسكين على مدير مدرسة ثانوية... هكذا تجيء الكلمات تباعًا في كلّ مرّة، باردة ومحزنة جدًّا، ومشرّعة باب التساؤلات المتعب: ما الذنب الذي اقترفه شبّان وشابّات وهبوا زهرة أيّامهم البئيسة لأبناء جلدتهم، حاملين على عواتقهم المثقلة أصلًا حملًا تنوء بحمله الجبال، أمام الله والضمائر والتاريخ هو بذر بذرة العلم والمعرفة، وتشكيل وعي جمعيّ متّزن وجيل مقبل نتوسّم فيه رتق الثقوب ودفع الخطوب؟
لِكُلٍّ سبيلٌ في الحياة لا بدّ أن يسلكه. ولعلّ حوادث كهذه، وإن بدت مروّعة، تنطوي على شرف يتحصّل لرجال التربية وهم يحملون رسالة الأنبياء؛ رسالة المعرفة والتنوير. وكم من واحد من بيننا غادر وأيّامه قضاها بغير غاية يطمئن إليها ولا مرفأ يتقصّده؟ غير أن تفشي العنف العويص هذا يسائلنا مفجوعين، لمَ صار الأستاذ الحائط القصير الذي يكاد تُسوّى به الأرض؟ الأستاذ الذي كان منذ زمن، الشخص الذي تنحني له الرؤوس وتهمس بحمده وشكره النفوس، في التاكسي والحافلة والسوق وفي كلّ مكان وزمان، ما الذي تغيّر؟ من يؤلّب عليه الآن الإعلام والمجتمع؟ من يكرّس ثقافة الاستهانة برجل التعليم والتنكيت عليه؟ من يستهين بسلامة حيوات الأطر التربويّة العاملة بالفيافي والقفار؟ وأيّما مرّة سمعنا بأُستاذات يشتكين من التحرّش والعنف اللفظيّ والجسديّ، وقدمن بذلك شكايات تلو الشكايات، فوجدن الأذيّة نفسها من الأمنيّ الذي لجأن إليه مستعصمات. لمَ أصبح الأستاذ كيس الملاكمة الذي ينفّس فيه رجل السلطة عن غضبه؟ لمَ أصبح غاية الإعلام المأجور الذي سيتغاضى، غالبًا، عن هكذا حادث؟ وحتى لو تطرّق إليه، قزّمه واعتبره أمرًا اعتباطيًّا يجري عليه "قضاء الله وقدره".
بدأت هذه المواضيع تضيق بالكتابة، وأضحى المعنى يتوالى مبتورًا مشوّشًا ثقيلًا، إذ إنّ مشاكل بهذا الكبر لا تتّسع لها شساعة الورق مهما رحبت. وبالطبع، وللضرورة، لا بدّ من تجفيف منابع هذه الأزمة الأخلاقيّة أوّلًا، عبر تعميم خطاب يولي الأستاذ ما يستحقّه من احترام ومهابة وتقدير، في الإذاعة والصحيفة، والتلفاز والأسرة، والشارع، وبعث معاني حبّ العلم والمعرفة وتقديسها في نفوس الناشئة. وبعدها لا بدّ من إعادة النظر في التشريع المدرسيّ، وفي القوانين المنصّصة على العنف المدرسيّ، واعتماد مقاربة أكثر زجرًا وردعًا للمتهتّكين؛ فما لا ينصلح بالكلام لا ينصلح حتمًا بمزيد من الكلام.