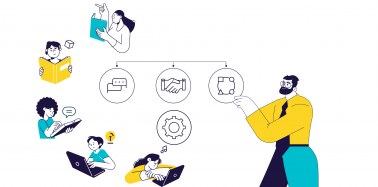لم يكن ارتباط التعليم التحرّريّ بالشعوب المقهورة أكثر من غيرها وليدًا عضويًّا متلازمًا؛ ففكرة التحرير فكرة مستمرّة في كلّ مجتمع، سواءً أكان مقهورًا أم مستتبًّا اجتماعيًّا. ذلك أنّ معضلة الاستبداد التي تقود إلى التربية التحرّريّة غير مقتصرة على النتوءات التي تخدش المجتمعات المحكومة مركزيًّا حكمًا سلطويًّا عنيفًا، بل تتعدّاها إلى المجتمعات التي تدّعي الحرّيّة. وهذا يعني الحاجة إلى التربية التحرريّة في كلّ أطياف المجتمعات الشماليّة والجنوبيّة، باعتبار ازدواجيّة القاهر والمقهور في صراعهما الذي يتجلّى في أدوات متباينة، يصوغها العقل التحرّريّ نفسه، وضمن سياق الثقافة السائدة ونمطها، من أجل إعادة إنتاج الوعي الذي تكلّست خطورته في امتدادات التعليم البنكيّ التطبيعيّ، والذي جعل الإنسان سلعة التعليم.
من هنا، تكمن أزمة التعليم في المجتمعات المتخلّفة في اعتمادها أسلوب التعليم التلقينيّ البحت، والقائم على وجود طرف ملقِّن وطرف متلقٍّ، لينتهي بملء عقول الطلبة بكلام ومعلومات أفرغت من محتواها الفعليّ؛ فيترتّب على ذلك تطبيع المتعلّم وتطويعه لقبول فكرة التعليم من أجل حفظ المعلومة من دون محاكمتها، فيما التربية التحرّريّة تجعل من الإنسان أداة التحرّر وجوهرها.
فالمسألة المهمّة التي يجب أن تبقى متّقدة في التربية التحرّريّة شعور القائد (الطالب) فيه كمربّّيه، أي أن يسمع صوت الذات الفخورة، وصوت ذواته الجمعيّة في مسائل حياته المجتمعيّة، باعتبار المجتمع من مسؤوليّته التي لا تنفكّ. فهذا النوع من التربية ينطلق من قناعة واعية بأنّ المبدأ التعليميّ المبنيّ على التربية، لا يكون تعليمًا ما لم يتّخذ من التحرّر نقطة انطلاق؛ فهو يقدّم بالممارسات فاعلًا في الحياة ولها، وبطرائق تعليم المقهورين بالأسلوب الذي يسهمون فيه إسهامًا واقعيًّا إيجابيًّا وفاعلًا وهادفًا ومشوِّقًا في العمليّة التعلّميّة المبنيّة على حرّيّة الفكرة، وحرّيّة اتّخاذ القرار الناتج عن التفاعل التعلّميّ. يعني ذلك أنّ الطالب يأخذ قراره الخاصّ من مطبّات الحياة التي تخلو من الصعوبات والتحدّيات.
ففكرة التحرّر في التعليم تمنع الإخلال الفوضويّ، وتمنع استنساخ طلبة في القارّات المتباعدة، متشابهين ومتقاربين في سطحيّة تعاملهم مع الحياة، لأنّ تحرير التعليم يقتضي وضوح الأهداف ووضوح المنظومة التعلّميّة، ويمنع منعًا باتًّا الإخلال المنهجيّ في التعليم، والذي يكون حائلًا، فسيولوجيًّا وسيكولوجيًّا، دون تحقيق مشتهى التحرّر المطلوب دون غيره؛ لأنّ المقهورين حينها إن لم يشعروا بإنسانيّتهم التي هي وقود العمل، ووعيهم الثقــافـيّ الذي هو محرّك الخطأ، وحسّهم الوطنيّ الذي هو دافع الغاية، لن يستطيعوا التعامل مع بعضهم، بل لن يكون هناك تناغم وانسجام موحّد بينهم حول الفكرة الحقيقيّة لمعنى التحرّر الذي هو مبتغى الممارسة. لذا، لا بدّ من أن يدافعوا بأظافرهم عن تعليمهم الباني، وعن إنسانيّتهم الجريحة، وإنسانيّة قاهريهم الملطّخة بالافتراس الوحشيّ في الوقت ذاته.
ومن هنا، أيّ تعليم تحرّريّ يجب أن يصادم علاقات القوى في هرم التربية السائدة ويناجزها، ويخلخل سلطتها وتراتبيّتها الفوقيّة المستمدّة من الإرث الرتيب بعنف واعٍ، حتّى يتمكّن من إعادة إنتاج سلطويّة القوّة التربويّة والتعلّميّة بطريقة تتلاشى فيها الفروق الواضحة بين متعلّم أرستقراطيّ ومتعلّم أنهكته تجاوزات المواصلات التي لا تنتظره. بالإضافة إلى التمايزات النفسيّة والاجتماعيّة بين المعلّم والمتعلّم، والتي تفرضها اجتماعيّات الشارع وفق ما تبصرها التربية الرسميّة، والتي لها اشتراطاتها على مسيرة التعليم الصدئة ونتاجها. وهذا الأمر يعني نسف الاشتراطات، وإعادة هيكلة الأولويّات هيكلة مختلفة عن تسليع المناهج.
التعليم الذي لا يقوم على مبدأ معالجة المشكلات تعليم انبطاحيّ، ينتج طلبة معتقلين في تفكيرهم؛ ممّا يعني أنّه حيث تُناقش المشكلات التي تواجه المتعلّمين والمعلّمين والمجتمع بعلاقة بعيدة عن الأسلوب التقليديّ، يكون بداية تحرّر التربية وتحرير النصّ. وبذلك، ينضوي إحلال علاقات جديدة في المفهوم، هي علاقة المتعلّم المريد بالمعلّم المريد، بما يستثير العقل في مسؤوليّته عن تغيير الواقع، سواء بحلّ المشكلات التي تُهضَم مسبِّباتها للخروج بقاعدة انطلاق للمعالجات، أم بالعلائقيّة التي تحوي الاستفادة من الطرفين للطرفين والمجتمع. أي أنّ الجميع يتبادلون إنتاج المعرفة ويتشاركونها، في ممارسة جمعيّة تحرّرت من بروتوكولات التعليم الهاوي.
فالتربية التحرّريّة المنبثق عنها التعليم للتغيير، طريقة للتعليم في معالجة المشكلات معالجة ترفض الواقع بعدم السكوت، وبإزالة الأتربة عن الجذور المتيبّسة، وقلعها إن لزم الأمر. هي تربية يشارك الطلبة فيها بالتبصّر لإيجاد الحلول من دون مهادنة. وهكذا، تُمارَس عمليّة تغيير مستمرّة ومستمدّة من رؤية المتحرّرين في التعليم.
لا يقتصر دور المتعلّم هنا على الاستماع فحسب، مع أنّ الاستماع أوّل خطوات المواجهة، بل يتعدّاه إلى المشاركة بالنقد والبحث والحوار: المشاركة بطرح السؤال، لأنّ السؤال أوّل المعركة، وكلّ هذا يدور بين المعلّم والمتعلّم والمجتمع دورة إيجابيّة، مع خطورته على الشركات التي تصنع مئات الملايين من علب الهندسة التي لا تستطيع قياس محيط شجرة في ساحة المدرسة.
ولمّا كانت التربية التحرّريّة تمكِّن الطلبة والمعلّمين من تجاوز ظاهرة الاحتكار المعرفيّ والثقافيّ والسياسيّ، والخضوع للتصوّرات الكاذبة والساذجة عن العالم والحياة، كتلك الخيالات التي بدأت مع المراحل الأولى من التربية الركيكة، وصولًا إلى القواعد التربويّة التي فرضها القاهرون على المقهورين، كان التعليم التحرّريّ أداة نسف القهر الموسوم بالتربية الانتهاكيّة وفق نظام يتناول فيه المعلّم والمتعلّم أدوارهما الإيجابيّة داخل النسيج المدرسيّ التفاعليّ والاجتماعيّ الحواريّ، والذي لا يتقيّد بقواعد ترقيم البشر وترقيم الطلبة، بناء على ببّغاويّة الحفظ، بينما التركيب والتقييم في غبار الذاكرة.
انطلاقًا من إطار عمليّة التفاعل الاجتماعيّ وترسيخ أسس التربية الحواريّة في التربية التحرّريّة، نجد هذه الأخيرة نظامًا عصريًّا يتلاءم مع الدم الذي يسيل في غزّة، ومع اغتيال المدارس والجامعات، ومع قهر الأوروبيّين من تحكّم رأس المال بمصيرهم المتدحرج. هي تعليم ينبش في جدوى الصناعة التي تغتال نظافة الهواء، وهي التعليم الذي يجب أن يحاسب مدّعي الحرّيّة في عمليّات القتل الممنهجة للاحتلال الصهيونيّ في فلسطين ولبنان بلا رادع. ولا شكّ أنّ التربية التحرّريّة تسهم إسهامًا لازمًا في تنمية روح الاستقلاليّة لدى الناس، وتشجّعهم على بناء حبّ التساؤل وممارسة التفكير المستهدف في الغيابات، واكتساب كثير من المهارات العقليّة وتوسيع آفاقها، وتعميق الوعي التربويّ، والقدرة على حلّ المشكلات، والتخلّص من الجمود العقليّ وتبلّد الحواس.
لذلك، لا بدّ من أن يعتمد التعليم التحرّريّ آليّات فطريّة ابتدائيّة ونظيفة، مثل التعاون والانطلاق والمشاركة والاشتباك، ليكون الهدف المشترك تطوير العالم وتغييره نحو الأنسنة المبتغاة، والتي يحتاج إليها القاهر والمقهور، والحاكم والمحكوم، والتي يحتاج إليها الإنسان بوصفه المجرّد.
فوحدة القوى المقهورة من أجل التحرّر من الآليّات مهمّة لتحقيق الغاية. وذلك بإيجاد وعي طبقيّ أفقيّ في المجتمع العالميّ، أي الشعور بالظلم الاجتماعيّ بين المقهورين من أجل أن يعرف القاهر وحشيّته اللا آدميّة، وما يعني ذلك من خروج عن الفطرة. بالإضافة إلى التآلف العاطفيّ والثقافيّ الذي هو آليّة تحرّريّة بنّاءة ومعطاءة، وباعتبار أنّ العمل التحرّري يستهدف احتواء المتناقضات ويجمعها، وقد يفرّق بين المتشابهات والمضلّلات. وبذلك يتمكّن من تحقيق حرّيّة الذات والآخر بالتآلف بين أفراد المجتمع، ليصبحوا متشاركين في العمل الذي يقومون به معًا تجاه العالم المخطوف بالتعليم المضلّل.
فتآلف القوى المقهورة المعرفيّ والوجدانيّ والثقافيّ، لا يرفض الاختلاف في وجهات النظر، لأنّه مبنيّ على مثل هذا الاختلاف. فبين الخلاف والاختلاف ثمّة مساحة تعلّم كبيرة، ولكنّ التآلف بالضرورة يرفض الغزو الثقافيّ - المعرفيّ (العولمة)، والذي تمارسه فئة نافذة سلطويًّا على فئة ما، ويؤيّد ذلك الدعم المشروط الذي تقدّمه فئة إلى أخرى.
حدّد فريري في مجمل أعماله، المعالم الرئيسة لفلسفة الثورة، وهي التي تستهدف تحرير الإنسان وتوجيه طاقاته نحو تغيير العالم الذي يعيش فيه. وذلك باعتبار الثورة عملًا يمارسه المقهور من أجل تجاوز ظروف القهر واكتساب حرّيّته، وهو في هذه الممارسة يواجه القاهرين الذين لا يريدون له أن يتحرّر، بل يريدون له أن يستبطن ظروف القهر ويعتبرها قدرًا لا يمكن ردّه. فهذه الثورة لا يمكن لها أن تتحقّق إلّا بالتعليم الحواريّ. وما يعنيه فريري بالتعليم الحواريّ ليس الجدل العقيم الذي يمارسه قادتنا، وإنّما ضرب من وعي الواقع الإنسانيّ. فالإنسان عندما يتبيّن واقعه يدخل في علاقة حواريّة مع نفسه وزملائه والعالم الذي يعيش فيه، وهذه العلاقة الحواريّة هي التي تخدم الوعي، وهي التي تؤدّي إلى الحرّيّة، وبالتالي إلى تغيير العالم.
* * *
أثبتت التجارب عبر التاريخ أنّ ما يبعث التفكير عند الناس ليست النظريّات ولا كتب الفلسفة، على رغم أهمّيّتها، بل التفكير في الأحداث الدمويّة التي تسحقهم. وهذه الأحداث قد تكون طبيعيّة أو بشريّة. وأمّا الأحداث الدمويّة البشريّة التي تسحق الناس، والتي تحصل جرّاء علاقات القوّة المدفوعة بالمصالح، فعلاجها الذي لا يخيب هو إعادة التعليم إلى التحرّريّة. وعليه، تكون التربية التحرّريّة مشكاة العالم التي من خلالها سيقف ابن القاهر التحرّريّ بوجه أبيه البنكيّ، وهنا تعاد صياغة ترتيب العلاقات.













 نشر في عدد (18) خريف 2024
نشر في عدد (18) خريف 2024