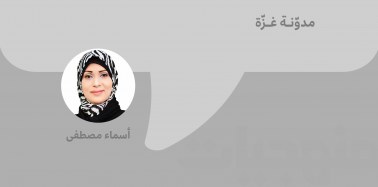لم أكن أرغب أن أعمل في حياتي معلّمة، كان المسرح والموسيقى والشعر كلّ ما أحلم بهِ، ولكوني شخصًا متمرّدًا لم أحصد علامات عالية، بالذات عندما أصبحت بالإعداديّة. كانت تجذبني كتابات مصطفى المنفلوطي، وشعر نزار قباني، وأعمال دريد لحام، وموسيقى وكلمات فيروز، لم أكن أجد ما يغريني أو يدهشني في الكتب المدرسيّة، ولا حتى في المدرسة والمعلّمين، كلّ ما أذكره أنني كنت دائمًا مصابة بحالة من الملل، ومن لحظة نهوضي صباحًا أبدأ في حساب الدقائق لينتهي اليوم وأعود إلى البيت.
شاءت الأقدار ودرست اللغة العربيّة، التخصّص الذي أحبّه، مع أنني لم أحصد معدلًا عاليًا في الثانويّة العامّة، إلّا أنني كنت أملك من الأحلام ما يفوق جميع أحلام أولاد جيلي. تخرّجت من الجامعة، وعملت في أعمال مختلفة، وتطوّعت في العديد من المؤسّسات، ومارست كلّ ما أحبّ، رغم فشلي أحيانًا، وإحباطي في مواقف معينة، إلّا أنّني كنت مؤمنة أنّ أحلامي هي الشيء الوحيد الذي يمنحني القوة للعيش على هذه البسيطة.
عملتُ معلّمة للصفّين الخامس والسادس، وكانت نظرات الطلاب في البداية مرعبة، الوقوف في الصفّ شيء يحتاج مني أن آخذ شهيقًا وزفيرًا مرّات عديدة قبل بدء الحصّة، سخافة المنهاج الذي كان عليّ أن أُعطيه بحبٍّ وإتقان لطلابي، مع عدم حبّي له ولا لطريقة عرضه، كانت تشعرني أحيانًا أنني مُصابة بانفصام شخصيّة؛ كيف أُحبّب طلابي بكتاب لا أحبّه، كان عقلي يحتوي قصائد أجمل، ومواضيع للتعبير أهمّ من مواضيع الكتاب الباهتة. كنت أرى أنّه من حقّي كمعلّمة أن أُدرّس طلابي ما أُحبّ وما أجده يستحق هذا العناء، يستحق النهوض باكرًا والقدوم إلى المدرسة، وكوني أدرّس مادة أدبيّة لا أعتقد أن فكرة عدم الالتزام بالمنهاج سوف تحدث خرقًا في طبقة الأوزون.
بدأت أتغيّر، نشأت علاقات جميلة بيني وبين طلابي، كانت أحضانهم الصغيرة تمنحني من الزاد الروحيّ والقوّة الجسديّة ما لا أستطيع وصفه، كانت كلماتهم هي الشمس التي أستيقظ كلّ يوم على ضوئها وأبتسم، وأتحمل بفضلها هذا العالم البائس، ولكن مع ذلك كنت أشعر أنني لا أرغب أن أكون معلّمة بهذا الشكل، بهذه النمطيّة المميتة. كنت أرغب أن أكون معلّمة مختلفة، ليس فقط بإيصال المعلومة أو قدرتي العلميّة في المادّة التي أدرّسها، بل كنت أرغب بإحداث فرق كبير على شخصيّة وتفكير طلابي. ومن هنا، بدأت أشعر أنني أنسلخ عن نفسي، أنني أجاهد من أجل شيء كبير، لا أجد قائدًا يقودني لأكسب هذه المعركة، ولا يوجد أتباع يسيرون بجانبي لتحقيق النصر، شعوري أن هؤلاء الطلاب أولادي الذين أنجبتهم من الحياة، كان يزيد التمسّك بفكرتي.
تعرّفت بمحض الصدفة على مؤسّسة عبد المحسن القطّان، وسمعت بدورة تعطيها للمعلّمين، هدفها دمج الدراما في التعليم، سجّلت في الدورة وقُبلت، كنت أعلم من لقائي الأول مع مالك الريماوي ومعتصم الأطرش أنّ الدورة أكبر من كونها فقط دراما وتعليم، وما توقّعته كان في مكانه.
سافرت إلى جرش تاركه ورائي عائلتي، ورفيق درب لم أفارقه منذ معرفتنا لدقائق. سافرت للمرّة الأولى في حياتي بدون رفيق أعرفه، أو فرد من العائلة، كنت متردّدة، ومع جميع الأفكار التي كانت تسطو على عقلي في الأيّام الأولى بأن أحزم أمتعتي وأعود، إلّا أنني أقفلت عقلي عن كلّ شيء باستثناء فكرة التعلّم التي جئت من أجلها.
لقاء بعد لقاء أصبحت الصورة أوضح، بعد كل لقاء كنت أطير من مكاني وأقول نعم هذا ما كنت أقصده، تعلّمت خلال الفترة القصيرة بأيّامها، الغنيّة بمحتواها، أكثر ممّا تعلّمته خلال السبع والعشرين سنةً الماضية. استغربت من قدرة المعلّمين على وضع يدهم تمامًا على موضع الفكرة التي كان يصعب علينا شرحها، دهشت من بساطة التعليم وجماله إذا تم تطبيقه بهذه الطرق، وأيقنت أن معلمًا واحدًا قادر على إحداث فرق في حياتك وشخصيّتك وأفكارك وطريقتك في التعليم.
يوم بعد يوم أصبحت أُكوّن علاقات جميلة مع زملائي ومعلّمي، أصبحت أحبّ المكان، أحبّ أحاديثنا ونحن نتناول وجبة الغداء أو العشاء، بدأت ألمس فكرة أنني نقطة في بحر هذا العالم، أدهشتني ثقافة وأفكار زملائي، اختلاف الأديان والأفكار والمعتقدات كانت تجربة تشبه الغوص في البحر دون أكسجين، دون أن ينقطع نفسك كذلك.
بدأ العام الجديد، لم أتّفق مع مدرستي التي أعمل فيها على بعض النقاط، التي تعتبر مُقدّسة لي، وتُشكّل جزءًا كبيرًا من قناعاتي، فكيف لي أن أُعلّم طلابي مفاهيم كبيرة وقيّمًا عظيمة، وأنا أرى نفسي ضمن دائرة العبد والسيّد. تركت المدرسة، أو أنا تركت وهم تركوني، أحزنني فراق طلابي، ولكن كنت على يقين بأن هذا هو القرار الصحيح، عدت للقراءة والكتابة، والبحث عن عمل، وطيلة بحثي عن وظيفة كنت أبحث عن شيء يخصّ التعليم، ليس مهمًّا المسمّى أو المكان، المهم أن أكون أنا المعلّم، بدأت العمل في التدريس الخاصّ في منزلي أو في منازل الطلاب وفي مراكز تعليميّة، كانت عندي المساحة الكافية لتعليم وتطبيق ما تعلّمته في الأيّام السابقة، وهذا ما كنت أريده.
بدأت بتطبيق نشاط الدمية، الذي تعلّمناه في أول لقاء في جرش، كتبَ الطلاب عن هذه الدمية، ومنهم من مثّل مشاهد بسيطة، ورسمنا الدمية بحالات مختلفة، أبهرني مستوى الطلّاب كلّ في جانبه، منهم من أتقن الوصف والتعبير، ومنهم من أتقن التمثيل والرسم. بعد هذا النشاط استطعت كمدرّسة للغة العربيّة اكتشاف من يمتلك مهارة التعبير والكتابة، واستطعت الوقوف على بعض المشاكل النحويّة والإملائيّة التي ظهرت في كتاباتهم. كانت هذه الطريقة المناسبة لعلاج كلّ مشاكل الضعف لدى الطلاب. مع العلم أن الطرق السابقة التي كنت أُمارسها: أن أطلب منهم القراءة، وأُملي عليهم بعض الجمل لمعرفة مستواهم.
لقد كان دور المعلم التقليديّ الذي يأمر وينهى واضحًا في أسلوبي السابق، كسائر المعلّمين، ولكن نشاطًا جميلًا بسيطًا يكتشف جميع مستويات المعرفة لدى الطالب، يشارك به المعلّم كما يشارك الطالب، يشعر الطالب بالراحة لأن ما يفعله خارج إطار الكتاب والسبورة، نشاط قد يراه البعض دون معنى، على الرغم من أنه لا يكلف الكثير من الوقت ولا الجهد، جاء بنتائج ممتازة في معرفة نقاط الضعف لدى طلابي، ومعرفة الخطّة اللازمة في ما بعد والتي يجب تطبيقها مع كلّ طالب.
بعد تطبيق أوّل ما تعلّمته، وشاهدت نتائجه الرائعة، صارت لدي رغبة كبيرة بتعلّم المزيد، وأنا على يقين أن السنوات القادمة التي سأستكمل بها متطلّبات المدرسة، سأحظى خلالها بالكثير من المعارف والوسائل والأساليب القادرة على إخراجي من قوقعة المعلّم التقليديّ إلى سماء المعلّم المُحلِّق.
أشعر الآن أنّ جميع المفاهيم التربويّة التي سبق ودرستها في الجامعة، بات فهمها وتطبيقها واضحًا وسهلًا، فمثلًا كانت مشكلة مراعاة الفروق الفرديّة صعبة عندي في البداية، فكنت لا أستطيع معرفة مواطن القوة والضعف لدى طلابي، أمّا الآن باتت لديّ القدرة بنشاط بسيط كالنشاط السابق، أن أُلاحظ ما هو أكبر، كالمواهب التي يمتلكها الطلاب، أو المخاوف التي شكّلت حاجزًا أمامهم طيلة السنوات السابقة.
ما أعمل عليه حاليًا هو التنسيق مع مدارس للحديث مع المعلّمين عن هذه التجربة، وإعطائهم بعض النصائح والمعلومات التي حصلت عليها، وأن أقوم بتطبيق ما تعلّمته على بعض الصفوف في مدارس مختلفة، وسيكون العمل تطوعيًّا؛ الهدف منه عدم احتكار المعرفة.