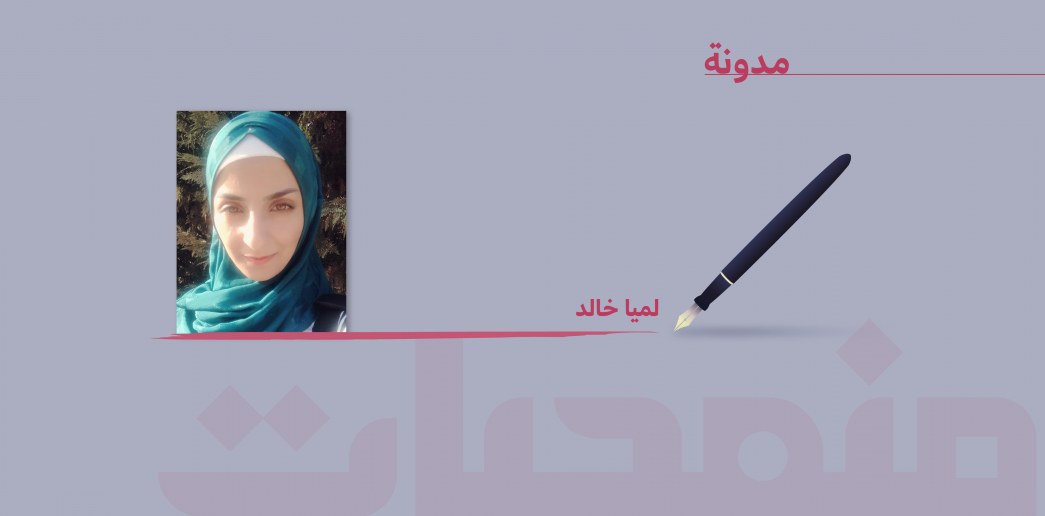ما أطرحهُ هُنا هو فضفضة، تعكس ما عانيته وما عاناهُ المعلّمون خلال ممارساتهم اليوميّة لمهنتهم على مدار السنتين الماضيتين؛ إذ توالت الأزمات الاقتصاديّة في لبنان، منذ كورونا، وصولًا إلى أزمة انهيار العملة الوطنيّة المُستمرّة. وكنت قد ذكرت في تدوينة سابقة بعنوان "فنّ التعامل الإداريّ مع المعلّم"، أهمّيّةَ توفير مساحة آمنة للمعلّم، ليتمكّن من منح أقصى طاقته لإثراء طلبته بالمعلومات، وطرق التعليم الصحيحة المُتناسبة مع القرن الواحد والعشرين، والمواكبة للتعليم الحديث، إلّا أن الوضع بات مغايرًا، بات أكثر صعوبة، والمشاكل المهنيّة ومشاكل القطاع التربويّ في ازديادٍ.
المعلّم اللبنانيّ في أزمة
خلال الأزمة واجه المعلّم مشاكل جمّة أدخلته في متاهة الضغط النفسيّ، إذ أصبح هاجسه الوحيد تأمينَ معيشة كريمة بالقليل. وبات لديه حسّ المسؤولية تجاه مهنته من جهة، وممارسة حياته من جهة أُخرى، فاختلّ توازن الميزان. وعلى سبيل المثال، في السنة الماضية، قام المعلّمون بتضحية نوعيّة؛ لقد باتت أجورهم لا تساوي الحدّ الأدنى للأجور، ومع ذلك، شهدنا استمرار ممارسات مهنيّة ذات دقّة احترافيّة عالية، بهدفٍ نبيل هو استمراريّة التعليم، والمحافظة على جيلٍ يتمتّع، على الأقلّ، بمستوى تعليميّ يليقُ بهِ.
أمثلة من الواقع
كمعلّمة في مدرسة خاصّة، لم تستطع الإدارة "دَوْلَرَة" أُجرة المعلّم حتّى الآن. وذلك لأسباب عدّة، أهمّها أنّ أغلبيّة الطبقة المُجتمعيّة المُحيطة، أي منطقة عكّار في شمال لبنان، كانت تنتمي إلى الطبقة الوسطى، والتي اندثرت لاحقًا، فباتت تعمل في مجالات مختلفة ذات دخول أقلّ: زراعيّة أو حُرّة أو حكوميّة، في ظلّ وضع متدهورٍ أساسًا، فعجزت بدورها عن الدفع للمدرسة كما كان الأمر سابقًا.
من هُنا، وجدنا أنفسنا، كمعلّمين أمام استحقاق كبير، يتمثّلُ بخيارين: إمّا القبول بالوضع الراهن، أو اتّخاذ قرار الهجرة.
وعلى الرغم من قيام أغلبيّة المدارس الخاصّة بفرض نسبة من الدولار على الرسوم المدرسيّة، إلّا أنّ هذه النسبة لم تستطع تغطية التكاليف التشغيليّة بسبب تضاعفها، وبالتالي لن يبقى منها إلّا قسمًا بسيطًا لتغطية رواتب المعلّمين.
مع هذا الواقع السوداويّ للمعلّم، قرّر الكثير، أو باتوا يفكّرون بجدّية، في اعتزال مهنة التعليم. ومنهم من هاجر لتأمين قوت عائلته؛ فراتب 3000 دولار للمعلّم في الخارج، لن يحصل على 5% منه إذا بقي في البلاد. وهو أمرٌ طبيعيّ، والمعلّم إنسان بحاجة إلى رعاية نفسه وأسرته، ومن غير المنطق أنّه يضطّر إلى دفع راتب شهرين أو ثلاثة لإصلاح حاسوبه! وأنا مثلًا، مضطرّة إلى العمل في أكثر من مؤسّسة قبل الظهر، وفي التعليم الخاصّ بعد الظهر، وخلال أيّام عطلة نهاية الأسبوع، وكلّ ذلك لتأمين الحدّ الأدنى من المعيشة وحسب.
ولتقديم حلول آنيّة، برأيي، لا بدّ من وضع هيكليّة نقف بها إلى جانب المعلّم، ومراقبة المدارس وسياساتها، واتباع سياسات تقشفيّة صارمة من قبل الدولة، وتفادي المحسوبيّات الطائفيّة، وتقديم حلول جذريّة للمعلّم حتّى نحاول إيقاف تدهور القطاع التعليميّ.
مشاكل خلّفتها الأزمة
أوّلًا: ازدياد هجرة المعلّمين إلى بلاد الاغتراب، أو النزوح نحو مهن أخرى. وقد ساهم هذا الموضوع في ظهور شواغر جمّة في المدارس. وقامت إدارات المدارس باستقبال معلّمين لملء الشواغر، من دون مراعاة الكفاءات والخبرات من جهةٍ، وبالاستفادة من الخرّيجين الجدد لتقليل كلفة الراتب بحجّة انعدام الخبرة من جهةٍ أُخرى. وهذا الوضع يهدّد أساسَ تأمين تعليم سليم للتلامذة. إنّ تردّي مشكلة التعليم، ستجعل التعليم الموثوق حكرًا على طبقة مُعيّنة. وهذا أمرٌ خطيرٌ كون الأزمة الاقتصاديّة مُمتدّة، وهذا كفيلٌ بتدمير أجيال.
ثانيًا: النزوح المدرسيّ. وكان على وجهين: من الطلّاب من اختار النزوح من التعليم الخاصّ إلى الرسميّ، لعدم القدرة على دفع الرسوم المدرسيّة. ومنهم من اختار النزوح من التعليم الرسميّ إلى الخاصّ بسبب كثرة الإضرابات وتوقّف التعليم لمدّة ثلاثة أشهر تقريبًا في السنة الفائتة، وعدم حصول الطالب على القدر الأقلّ من التعليم. وهذا بالإضافة إلى ظاهرة التسرّب المدرسيّ الذي بات واقعًا قاتمًا يحتاج إلى دراسة.
ثالثًا: المعلّم الذي كافح وناضل ومارس مهنته، خلال الأزمة، كان له أيضًا شقّ من الإرهاق النفسيّ والكسر المعنويّ، بسبب الغلاء المعيشيّ وارتفاع أسعار الإنترنت بشكل مبالغ فيه، وعدم توفّر الكهرباء وغلاء الوقود، وغيرها الكثير من المشاكل التي حدّت من عمل المعلّم، وأجهدتهُ، وهو المُطالب بأن يكون أكثر استيعابًا، وأشدّ مراعاةً للظروف ولحالات الطلبة.
رابعًا: الوضع النفسيّ الصعب للطلّاب. فالانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد يؤدّي حكمًا إلى انهيارات اجتماعيّة؛ فشهدنا طلّابًا عانوا انفصال والديهم بسبب الضائقة الماليّة، وعدم قدرة ربّ المنزل على تأمين حياة كريمة ما انعكس سلبًا على وضعهم السلوكيّ وانضباطهم. ومنهم من عانى التنمّر اللفظيّ، فأوجدت الأزمة الفرصة لتغلغل هذه الظاهرة في المدارس وفي الصفوف. ومن الطلّاب من لم يستطع تأمين أدويته بسب انقطاعها لفترة، واضطّر إلى الغياب فترة طويلة، وغيرها الكثير من المشاكل.
حلول بسيطة لمساعدة الطلّاب
لتلافي بعض المشاكل التي واجهتنا خلال هذه المرحلة، قمت وزملائي ببعض الإجراءات التي ساهمت، بشكلٍ أو بآخر، بحلّ جزء منها، والتخفيف من أثرها على طلّابنا، ومنها:
1. حملة توعية شاملة لكلّ الصفوف حول آثار التنمّر والإحباط، تخلّلتها نشطات إرشاديّة.
2. إفساح المجال أمام الطلّاب للتعبير عمّا يجول في خاطرهم، أو مساعدتهم لإيجاد بعض الحلول في بداية كلّ حصّة.
3. التكلّم عن قصّة صغيرة لشخصيّة مُلهمة، لتوعية وإثارة الرغبة لديهم في التطوّر، وحثّ الفكر للاجتهاد.
4. التواصل المستمرّ مع الأهل لمناقشة خلفيّة أي ردّة فعل.
5. تفريغ طاقات الطلّاب من خلال حصص الفنون والرياضة والموسيقى.
6. التنوّع في المشاريع المدرسيّة من ترفيهيّة وتثقيفيّة واجتماعيّة ومساعدة الغير.
7. تعريف الطلّاب بمهارات القرن الواحد والعشرين التي تعزّز لديهم الثقة بالنفس، والبحث الدائم عن كيفيّة إيجاد حلول، والتفاؤل بغدٍ أفضل، وكيفيّة البحث عن حلول.
السنة المقبلة
جميعنا يراهن على مدى نجاح هذه السنة الدراسيّة، رغم الضغوط التي ذكرناها سابقًا، والتي أجهدت الجميع ونحن ما زلنا في البداية. ورغم وضع مخطّطات لسير العام الدراسيّ، إلّا أنّنا نجهلُ النتائج التي من المُمكن أن نحصل عليها، وما هي التحدّيات التي ستواجهنا. ولا يسعنا إلّا أن نُبصر النور، ونتسلّح بكمٍّ هائل من الإيجابيّة لمواجهة هذا الواقع، ولا خيارَ آخر! وعلينا أن نتأهّبَ جيّدًا لنكون على وتيرةٍ واحدٍة، لنُشكّلَ خير مثال لطلّابنا لردع يأسهم/ إحباطهم، وإعدادهم لسنةٍ قد تكون حافلة بنجاحاتٍ مستمرّة.
في الختام
لقد انعكسَ تمدّد أكبر أزمة اقتصاديّة في تاريخ البلد، ومن أسوء ثلاث أزماتٍ في العالم، بشكلٍ واضحٍ ومباشرٍ على قطاع التعليم. وعانى المعلّمون، في القطاعين الرسميّ والخاصّ، من انهيار الأجور، وغيرها من مشاكل اجتماعيّة سلوكيّة تربويّة عديدة على مُختلف الصُّعد. وتبدو، مع هذه الحالة، استمراريّة العام الدراسيّ محفوفةً بالمخاطر والعقبات، ما يُهدّد المستقبل التعليميّ لمئات الآلاف من الطلبة على امتداد مساحة لبنان، ولا يسعنا إلّا شدّ السواعد وتأمّل الخير بعامٍ حافل لعلّنا نُحافظ على نظامنا التعليميّ.