- - حاصلة على درجة الدكتوراه في التربية من جامعة كامبريدج.
- - مديرة مركز الدراسات اللبنانيّة في لبنان وبريطانيا.
- - تشغل كرسيّ الأكاديميّة البريطانيّة للتعليم في الأزمات، في جامعة كامبريدج ومركز الدراسات اللبنانيّة.
- - باحثة في علم الاجتماع والسياسة التربويّين (Sociology and Politics of Education). وتركّز أبحاثها حول اللامساواة والعدالة في التعليم، خصوصًا الشرائح المهمّشة - من المجتمع، اقتصاديًّا وجغرافيًّا، وبسبب اللجوء.
- - عضوة مؤسّسة في الهيئة اللبنانيّة للتاريخ.
- - أسهمت في تأسيس عدّة تجمّعات للأكاديميّين والمعلّمين والحقوقيّين والجمعيّات الأهليّة تهتمّ بقضايا الفئات المهمّشة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين.
- - لها عدّة مؤلّفات أكاديميّة في مجال التربية والتعليم.
- - حائزة على عدّة منح بحثيّة من مجالس بحثيّة مرموقة، مثل: سبنسر (Spencer)، والمجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ في المملكة المتّحدة (Economic and Social Research Council)، والأكاديميّة البريطانيّة (The British Academy)، وغيرها.
- نبدأ عادة بتعريفك نفسك بطريقتك، ونضيف إلى ذلك تعريف مركز الدراسات اللبنانيّة.
أعتبر نفسي باحثة وأكاديميّة وعالمة اجتماع قريبة من الناس، ساعيةً دائمًا لجسر الهوّة بينهم وبين الأكاديميا. أرى أنّ دور الأكاديميّين أن يكونوا جزءًا من النسيج المجتمعيّ، وعلى تماسّ مباشر مع الناس وإحساسهم، وقادرين على التعبير بلغة مشتركة مفهومة، بدلًا من الانعزال وراء خطابات نخبويّة مغتربة عن المجتمع، تعتمد لغة مركّبة تجعلهم يخاطبون أنفسهم أكثر ممّا يخاطبون الآخرين. ربّما علينا أن نعيد التفكير بمصطلح "الشعبويّة" الذي يستخدم الآن بصيغة سلبيّة، بينما هو برأيي يعكس الاقتراب من الشعب/ الناس، ومخاطبة همومهم بلغتهم. كما أنّني أتّفق مع شانتال مووف، على أنّ الشعبويّة اليساريّة تمثّل استراتيجيّة هامّة للحدّ من هيمنة النيوليبراليّة، وتحقيق ديمقراطيّة راديكاليّة عادلة.
هذا الموقف في الحقيقة، شكّل أساس عملي البحثيّ؛ فأنا أستقي المشكلات البحثيّة من هموم الناس وتحدّياتهم في الواقع المُعاش، وأناقش المشاكل التي يتعرّضون إليها في يومهم، لإيجاد حلول عمليّة لها. ومن هنا يتعزّز الدور المهمّ لمركز الدراسات اللبنانيّة، والذي أراه جوهريًّا لارتباطه بالمعلّمين والمعلّمات والطلبة والأهل. وهذه نقطتي الأساسيّة المستقاة من علم الاجتماع العامّ، والتي ترتبط ارتباطًا عضويًّا بالمجتمع، فتحاوره وتتناول همومه ومشكلاته، وتسعى بالشراكة معه لإيجاد حلول مختلفة وفعّالة.
أرى نفسي تربويّة ضمن علم اجتماع التربية/ السياسة، إذ لا أرى التربية مجرّد بيداغوجيا، بل مجالًا متشابكًا بوضوح مع السياسة وعلم الاجتماع، ما يستدعي أنسنته وجعله جزءًا من الواقع المجتمعيّ. وفي هذا السياق، كان تأسيس مركز الدراسات اللبنانيّة على يد رجال أعمال لبنانيّين في المهجر، بعد الاجتياح الإسرائيليّ للبنان سنة 1982، للحفاظ على ما تبقّى من لبنان في ظلّ الاجتياح عن طريق العلوم الاجتماعيّة. أمّا الهدف الآخر، والذي أعتقد أنّنا نشترك فيه مع منهجيّات، فهو تعزيز إمكانيّات الباحثين والباحثات والتربويّين والتربويّات المحلّيّين، وتعزيز المعرفة المحلّيّة وإنتاجها.
في فترة معيّنة، اتّجه العمل في مركز الدراسات نحو الجانب البحثيّ الأكاديميّ الصرف، وكان مقرّه آنذاك في جامعة أكسفورد. ومن هنا، قرّرت أنّه من الضروريّ نقل المركز إلى لبنان، لنكون أقرب إلى الناس والمجتمع الذي نكتب عنه ونتحاور معه، ولاحتضان مبادرات المجتمع، على غرار الهيئة اللبنانيّة للتاريخ. كما نركّز دائمًا على الفئات المهمّشة؛ بما في ذلك ذوو الإعاقة واللّاجئون.
- ما الذي دفعك إلى التخصّص في سياسة التعليم والمساواة في التعليم؟
عندما كنت في الثالثة عشرة من عمري، تعرّضت إلى حادث أدّى بي إلى أن أستخدم كرسيًّا متحرّكًا. وبسبب الكرسي المتحرّك رفضت مدرستي استمراري فيها، ولم أجد مدرسة أخرى تقبلني، فاستكملت تعليمي من البيت. كان أثر هذا الرفض قاسيًّا عليّ، إذ شعرت أنّ المدرسة لم توفّر لي الدعم اللازم لتنمية قدراتي الكامنة والتعبير عنها. استكملتُ دراستي عن بُعد في الجامعة اللبنانيّة، ثمّ في بريطانيا، وتخصّصت في مجال التعليم، لأكون صوتًا للكثير من الطلّاب الذين يتعرّضون إلى الظلم، إذ كنت واحدة من ملايين الطلبة الذين أقصاهم نظام التعليم بسبب أوضاعهم الجسديّة، أو الاجتماعيّة، أو الاقتصاديّة، أو نتيجة سياسات نُظم التعليم نفسها.
هذا في الحقيقة جوهر ما دفعني إلى التخصّص في سياسة التعليم والمساواة في التعليم، إلى جانب التأكيد على ضرورة تحرّر الأكاديميا من النيوليبراليّة والكولونياليّة والنخبويّة، بالتفكير المعمّق في سياسات التعليم، انطلاقًا من احتياجات المجتمع الفعليّة، وليس استنادًا إلى أسئلة الأكاديميا الغربيّة الضيّقة. فعلى سبيل المثال، تشكّل لغة تعليم العلوم في لبنان عاملًا حاسمًا في تحديد قدرات الأطفال، وتوجّههم نحو التخصّصات العلميّة، وهي أولوية قد لا تكون ذات أهمّيّة كبيرة في بعض المجتمعات الغربيّة.
- على الأكاديميا أن تكون في خدمة الناس، وأن تتجاوز الفجوة اللغويّة التي تفصلها عنهم، كيف يمكن تحقيق ذلك؟
علينا، نحن الأكاديميّين، تقع المسؤوليّة الأكبر. فأنا مع استخدام لغة شعبيّة قريبة من الناس، أو تقريب المفاهيم إليهم، فمن دون ذلك يفقد العمل معناه.
من الملاحظ في المؤسّسات التعليميّة الجامعيّة، ولا سيّما في القطاع الخاصّ، تهميش علم اجتماع التربية، وعلم اجتماع التربية السياسيّ، مقابل الاهتمام الكبير بتعليم العلوم والرياضيّات أو اللغات الأجنبيّة. وهو ما يعكس مقاربة أسياسيّة تحصر التعليم في الموادّ الأكاديميّة، ما يؤدّي إلى تجريد عمليّة التعلّم في الصفّ الدراسيّ من أيّ أسئلة سياسيّة أو اجتماعيّة مرتبطة بالواقع، فيغيب السؤال الجوهريّ: لماذا نعلّم؟
أضف إلى ذلك النظرة الدونيّة التي تتعامل بها المؤسّسات الأكاديميّة البحثيّة مع المعلّمين والمعلّمات، مقابل تفضيل حملة شهادة الدكتوراه، وهي نظرة نخبويّة يجب تغييرها. المطلوب بناء مساحات حواريّة تشاركيّة، لا تقتصر على حملة درجة الدكتوراه فقط، بل تضمّ جميع فئات مجتمع التعلّم، بحيث تتعمّق في قضايا واقع الطلّاب والتعليم المحلّيّة، ينشغل فيها الجميع في حوار إيجابيّ مشترك وفاعل.
- اليوم، مع تصاعد الأزمات، وازدياد أعداد الأطفال اللاجئين وذوي الإعاقة، ما أبرز التحدّيات التي تواجه هذه الفئات في نُظُم التعليم؟ وكيف يمكن تحسين فرص وصولهم إلى التعليم واستدامته؟
منذ نشوء الدول بمفهومها الحديث، تعكس أنظمة التعليم رؤية الطبقة الوسطى بالأساس للمستقبل الذي تطمح إلى تحقيقه. وُجد هذا النظام أساسًا لضبط إنتاج الطبقة ذاتها، والتحكّم بما يتعلّمه أبناؤها، وتحديد نوع المحتوى الذي يُقدّم إليهم ضمن هذا السياق. ومن هنا، وباعتبار أنّ هذه الصيرورة في جوهرها سياسيّة/ اقتصاديّة، وتنطوي على شكل من أشكال القمع السلطويّ، فإنّ من واجبنا أن نقاوم هذا القهر المفروض على الطبقات الأدنى، والعمل على تحقيق الحرّيّة والعدالة الاجتماعيّة، عن طريق مقاربة تقاطعيّة (Intersectional Approach) تضمن تحقيق العدالة الاجتماعيّة لمختلف فئات المجتمع، وتمنع هيمنة فئة على حساب أخرى. كما علينا أن نكون واعين جدًّا للتدخّلات السياسيّة أو السلطويّة في المناهج التعليميّة.
في مثال هامّ، أجرينا تحليلًا لمناهج التعليم في لبنان من ناحية الشكل فقط، فوجدنا أنّ الصورة المرئيّة التي تقدّمها هذه المناهج للمرأة المحجّبة تعكس أيديولوجيا سياسيّة قمعيّة، فهي دائمًا امرأة كبيرة في السنّ، وضعيفة، ولاجئة فقيرة، في مقابل تصوير المرأة القويّة على أنّها دائمًا الشقراء وغير المحجّبة. هذا النموذج ليس سوى رسالة ضمن رسائل عديدة، تعكس نظرة استشراقيّة تُفرض لصالح مجتمع ما على حساب مجتمع آخر، ما يؤدّي إلى فرض خيارات بعينها على الأطفال داخل مجتمعات معيّنة، مثل خيارات اللغة، والتي تصبح بدورها أداة للقهر وتقييد حرّيّة الأطفال.
في الحقيقة، ومع تزايد الأزمات، ووفقًا للإحصائيّات، ستُحرم نسبة أكبر من الأطفال من التعليم، خصوصًا في لبنان. لا أعتقد أنّ هناك وعيًا حقيقيًّا بحجم هذه الأزمة، وأثرها في الفئات الأكثر هشاشة. في ظلّ التحدّيات المختلفة التي يواجهها الأطفال، مثل ذوي الإعاقة واللاجئين، إضافة إلى الممارسات القمعيّة التي تثبّط معنوياتهم، فمن الطبيعيّ أن نلحظ ازدياد معدّلات تسرّبهم من المدارس. نحن أمام مشكلة كبيرة تؤثّر في هؤلاء الطلّاب، ويجب علينا التحرّك من أجلهم.
أمّا في ما يتعلّق بمفهوم التعليم في حالات الطوارئ، فهذا المصطلح تسلّل إلينا من منظّمات العمل الإنسانيّ الغربيّة، والتي تروّج لفكرة "إنقاذ" اللاجئين أو فقراء العالم، من دون التطرّق إلى دورها في إنتاج هذه الحروب أو الكوارث. واليوم، نشهد كيف تسوّق المنظّمات الدوليّة لهذا المفهوم، على رغم أنّه طارئ على العالم العربيّ الذي تشكّل "الطوارئ" واقعًا مستمرًّا فيه. أمّا استخدام مصطلح "تعليم الطوارئ" باستمرار، من دون مساءلة التناقض الجوهريّ بين التعليم والإغاثة، فهو أمر بالغ الخطورة، إذ تتمحور فكرة الإغاثة الإنسانيّة حول إنقاذ الحياة في اللحظة الراهنة، بعيدًا عن الاهتمام الفعليّ بالغد أو بالتخطيط للمستقبل، بينما يرتكز التعليم على الحاضر والمستقبل معًا. لذلك، علينا التمعّن جيّدًا في هذه الأجندة قبل تبنّيها.
لمزيد من التوضيح، تشير الإحصاءات إلى أنّ اللاجئ يقضي ما معدّله 27 سنة في اللجوء، ما يستدعي وضع خطط متوسّطة المدى على الأقلّ، لا سيّما في قطاع التعليم، وهو ما تفتقر إليه غالبيّة برامج التعليم في حالات الطوارئ، فهي تركّز على التعليم الأساسيّ، في ظلّ ضعف الإمكانيّات الاقتصاديّة للاستثمار في التعليم المتوسّط والثانويّ والجامعيّ، ما يقلّص فرص الأطفال في الوصول إلى حقّهم في التعليم.
وهنا، لا بدّ من التطرّق إلى البعد السياسيّ الذي يتمّ تجنّبه في مصطلحات التعليم في حالات الطوارئ، فيُتعامَل مع الأزمات المناخيّة والسياسيّة على قدم المساواة. وهذا خطأ منهجيّ، وربّما متعمّد، من الجهات المموّلة ومنظّمات العمل الإغاثيّ؛ لأنّ أزمات النزوح الناجمة عن أسباب سياسيّة أكثر تعقيدًا للتعامل معها، مقارنة بالنزوح الناتج عن الكوارث الطبيعيّة. علينا في العالم العربيّ أن نكون واعين لهذه "الصيحات التربويّة" الجديدة، وألّا نتبنّاها اعتباطيًّا، من دون التفكير في أثرها في مستقبل تعليم الطلبة، كما حدث لمئات الآلاف، إن لم يكن لأكثر من مليون، من الأطفال السوريّين الذين اختبروا اللجوء، وعانوا عواقب هذه السياسات التي حرمت الكثير منهم من فرص التعليم.
في هذا السياق، أنظر إلى تعامل لبنان مع أزمة اللاجئين السوريّين بأسى. فعندما طُرحت مسألة التعليم باللغة العربيّة، قوبل الاقتراح بالرفض لأنّه يمسّ بسيادة لبنان! في حين أنّ الواقع يكشف أنّ العديد من الطلبة اللبنانيّين أنفسهم يعانون الاغتراب، بسبب التعليم باللغات الأجنبيّة التي يفرضها النظام، بحجّة إعدادهم للمنافسة في سوق العمل الخارجيّ. ما يجب أن نسعى له هو نقيض ذلك تمامًا: تأمين تعليم عادل ومتساوٍ، بعيدًا عن سياسات لغويّة تمييزيّة تحرم فئات من حقّها في التعلّم. من هنا، علينا أن نؤكّد مجدّدًا على أنّ الفئات المهمّشة تحتاج إلى دعم حقيقيّ ومستمرّ، لتحقيق العدالة وضمان فرص تعلّم آمنة للجميع.
أمّا بالنسبة إلى الطلبة ذوي الإعاقة، فالمشكلة الأكبر تكمن في النظرة السائدة إلى مفهومَيّ "السليم" و"المعوّق"، إذ تهيمن قيم التمييز والتنمّر ضدّ هذه الفئات (Ableism) في مجتمعنا. وعلى رغم الجهود الحثيثة لمكافحة أشكال أخرى من التمييز، مثل الجندر واللون، لا يزال التمييز القائم على الجسد والقدرات الذهنيّة مستمرًّا، بل مغيّبًا عن كثير من النقاشات. حتّى أجندات اليساريّين والثوريّين، الذين ثاروا على الظلم الاجتماعيّ، وانتقدوا الفوقيّة الطبقيّة والعنصريّة والجندريّة، لم تولِ اهتمامًا كافيًا للفوقيّة الجسديّة والذهنيّة، وكأنّها شكل غير مرئيّ من اللامساواة، يستمرّ بلا مساءلة. أشير هنا إلى نقطة مهمّة، وهي أنّ معظم الباحثين في مجال الإعاقة ليسوا من ذوي الإعاقة أنفسهم، ما يعكس التهميش الواضح الذي تعانيه هذه الفئة. ومن ناحية أخرى، لا يكفي التعامل مع قضاياها من منظور بيداغوجيّ فقط؛ بل علينا أن نفكّر ضمن أطر أخلاقيّة وقيميّة، ومقاومة القمع والتهميش الذي تتعرّض إليه. في دراسة أجريناها حول الأبحاث المتعلّقة بالإعاقة في العالم العربيّ، وجدنا أنّها تركّز غالبًا على الصعوبات التعلّميّة أو الصحّيّة أو النفسيّة، بينما تغيب عنها المقاربات الاجتماعيّة والسياسيّة، وهي الجوانب المسؤولة عن الإقصاء الذي تعانيه هذه الفئة. وهذا يؤكّد أنّ التهميش ليس مجرّد واقع اجتماعيّ، بل يمتدّ إلى مستوى البحث الأكاديميّ ذاته. من الضروريّ ألّا نحصر معالجة الإقصاء والتمييز الذي يمارس على الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن إطارَيّ المساواة في فرص التعليم والصحّة فقط، بل يتطلّب الأمر مواجهة الفوقيّة والتمييز اللذين تفرضهما فئة من المجتمع، بتعريفها الضيّق لمفهوم "الأصحّاء". عندها فقط، يمكننا تجاوز التفوّق القائم على القدرات الجسديّة والذهنيّة.
وهنا، أتحدّث بوضوح عن ضرورة إحداث ثورة فكريّة، تبدأ بإصلاح جذريّ للمنظومة التربويّة والمناهج، ثمّ تمتدّ إلى تطوير البنية التحتيّة للمؤسّسات التربويّة وأساليب التدريس والبيداغوجيا، لتكون أكثر شموليّة وإنصافًا.
- ما النقد الأساس للسياسات التربويّة والمناهج الدراسيّة في العالم العربيّ بشكلٍ عامّ؟
أودّ أن أبدأ بنقطة أساسيّة تعمل عليها منهجيّات، وهي التركيز على إعادة بناء الثقة بين المعلّمين والمجتمع، خصوصًا وأنّنا منذ زمن طويل، نحمّل المعلّمين وحدهم عبء المشكلات التي يواجهها النظام التعليميّ. استعادة هذه الثقة تحتاج إلى وقت، لكنّها تبدأ من إطار تعليميّ وتربويّ يسهم في خلق بيئة آمنة للتعلّم. كما تتطلّب في الأساس التزامًا واضحًا بتحقيق العدالة الاجتماعيّة على مستوى الوزارة، تمهيدًا لمعالجة الثغرات القائمة، مثل سياسات تعليم اللغة العربيّة، والتي تؤدّي إلى أشكال مختلفة من القهر والإقصاء.
أمّا في ما يتعلّق بالسياسات التعليميّة، فأنا أؤيّد اللامركزيّة والشراكات المستمرّة في هذا المجال، إضافة إلى التخفيف من التقييم التجميعيّ في مراحل التعليم. ولا شكّ في ضرورة ضمان حقوق المعلّمين، لا سيّما الحقوق الاقتصاديّة والوظيفيّة، مع التركيز على حقوق المرأة، كونها الفئة الأكثر حضورًا في قطاع التعليم، والتي برغم ذلك تفتقد العديد من الحقوق، لا سيّما إجازات الأمومة. اللامركزيّة، في هذا السياق، تسهم في بناء مدرسة مجتمعيّة محلّيّة تعزّز التعلّم، بدلًا من تقويضه بمناهج دراسيّة جامدة لا تتغيّر. كما أنّ دور نقابات التعليم يجب ألّا يقتصر على المطالب الحقوقيّة للمعلّمين فحسب، بل ينبغي أن يمتدّ إلى التأثير في سياسات التعليم وضمان حقوق المتعلّمين.
- هل علينا التفكير بإشراك الأهل/ المجتمع من أجل تطوير هذا الأفق؟ خصوصًا في سياق يعزل المدرسة عن محيطها؟
التغيير الحقيقيّ في هذا السياق يستلزم عمليّة طويلة مستمرّة، ولا يمكن إحداثه من دون تغيير الثقافة المدرسيّة والغايات من التعليم. إذًا، علينا بناء ثقافة جديدة حول المدرسة ودورها، ودور الأهالي والطلّاب، والمجالس المختلفة. كما علينا البدء بتعزيز لغة التشارك والثقة بين الأهالي والمعلّمين في خطوات عمليّة. التعليم عمليّة محوريّة ومهمّة جدًّا، وله مهمّة فكريّة وسياسيّة واجتماعيّة، وأبعاد في التشارك والتحاور. ولتحقيق ذلك، يقع الدور الأساس على كاهل المجتمع، مُجدّدًا عبر الثقة والتشارك والأدوار الواضحة للجميع، بما يحقّق الشراكة الحقيقيّة التي تخدم الطالب وتعلّمه. من الضروريّ البدء من الآن بتعزيز لغة التشارك لدى المعلّمين والمعلّمات والأهالي، ومن المهمّ جدًّا أنّ منهجيّات قد أفردت هذا العدد من أجل هذا الموضوع، فالخطوات تراكميّة، وتحتاج إلى وقت وجهد.
- كيف يمكننا تحقيق تغيير في قطاع التعليم من دون وجود تغيير اقتصاديّ حقيقيّ؟ وهل يمكن للحرّيّة السياسيّة للمعلّم أن تتحقّق في سياق دولة اليوم؟
في الحقيقة، يحتاج هذا الأمر إلى شراكة بين القطاعين الخاصّ والعامّ، إضافة إلى النظر في دور الجامعة، ودور المعلّمين وبرامج إعدادهم. اليوم حُيّد دور المدرسة السياسيّ، خصوصًا مع أنظمة داخليّة تعود إلى السبعينيّات في لبنان على سبيل المثال. وباتت مهمّة المدارس اليوم منح الشهادات للانخراط في سوق العمل. أمّا بالنسبة إلى الأطفال اللاجئين، فهي تؤدّي مهمّات محو الأمّيّة. ووفق دراسة أعددناها حول علاقة التعليم بسوق العمل في لبنان مثلًا، وجدنا أنّها تتأثّر بالوضع الاقتصاديّ والاجتماعيّ للأهل، والذي يشكّل العامل الأبرز الذي يحكم فرصة حصول الطفل على تعليم جيّد أو عمل أفضل. أمّا لدى الفئات المهمّشة، فتتّسع الفجوة بين فرصة العمل التي يستحقّها الفرد، وبين تلك التي يحصل عليها، وهي مشكلة اجتماعيّة واقتصاديّة وسياسيّة معقّدة. فمع تزايد الفجوة بين التعليم وتدنّي فرص العمل، يزدهر عالميًّا مفهوم "ريادة الأعمال"، والذي أراه في جوهره محاولة لتحميل الشباب مسؤوليّة خلق فرص عمل بأنفسهم.
من هُنا، قد نصل إلى مرحلة يصبح فيها من الضروريّ إعادة إنتاج نظام فكريّ واجتماعيّ وسياسيّ جديد، لا أعلم شكله بعد، لكن ما هو مؤكّد أنّها مرحلة تستدعي طرح أسئلة جوهريّة حول التعليم، وأدواته الحديثة، ودوره الفكريّ والاجتماعيّ والسياسيّ. هذا الدور، القائم على القيم الفلسفيّة، يجب أن يكون محور التركيز. أسأل نفسي دائمًا: هل نقترب من هذا الدور؟ وإجابتي تبقى سلبيّة، طالما أنّنا ما زلنا عالقين في دوائر الامتحانات الرسميّة، ومستوى الطلّاب، والتقييم، وهي أزمات مختلفة.
- ما الدور المنوط بالمعلّمين في مبادرات لمحاسبة المنظومات الحاكمة ومساءلتها، بهدف تحسين التعليم؟ وكيف نضمن حمايتهم؟
للأسف، هناك تواطؤ من المعلّمين ونقاباتهم وكلّيّات التربية مع المنظومة النيوليبراليّة، ما جعل التعليم مهنة معزولة عن الواقع، بدلًا من أن يكون عمليّة اجتماعيّة وسياسيّة متجذّرة فيه. المشكلة أنّ المعلّمين داخل النقابات يركّزون على المطالب المعيشيّة فقط، وهو أمر مهمّ بلا شكّ، لكنّهم يتجنّبون الحديث في السياسة، رغم أنّ هذه الحقوق نفسها مرتبطة بالسياق السياسيّ. هناك حاجة ملحّة لإعادة تشكيل دور النقابات، بحيث تستعيد دورها السياسيّ والاجتماعيّ كما كان في السبعينيّات، ما قد يساعد في تحويل مهنة التعليم من عمل تقنيّ محدود إلى هويّة سياسيّة واجتماعيّة ومهنيّة فاعلة.
وصل المعلّم اليوم إلى هذه المرحلة نتيجة مسار طويل ومتداخل، شمل تضييق حريّته وهويّته، ومسار إعداده معلّمًا، بالإضافة إلى العلاقة الاقتصاديّة التي فرضتها المدارس الخاصّة، والانتهاكات المستمرّة لحقوق المعلّمين، وخصوصًا المرأة. يضاف إلى ذلك الاصطفاف السياسيّ، وغياب الثقة بالقطاع العامّ. كلّ هذه العوامل أسهمت في تفكيك قيمة المعلّم، إلى جانب فقر مساحات الحراك الاجتماعيّ، والإحباط الناتج عن الظروف العالميّة والهيمنة.
- كيف تنعكس توجّهات العالم في سياق التخصّص والتقنيّة والبُعد عن الهويّة، في التعليم المدرسيّ؟ وكيف يُمكننا مجتمعًا وأهلًا ومعلّمين مقاومة ذلك؟
برأي يكمن الحلّ في خلق مساحات للحوار، لا سيّما في سياق أصبحت فيه الشهادات جزءًا من صيرورة تجاريّة قائمة على تبادل المنفعة. من هنا، فالمساحات التفكيريّة النقديّة، كما هو الحال في منهجيّات، تمثّل المستقبل؛ إذ تتيح للمعلّمين والأكاديميّين فرصة للتأمّل في سلوكهم ومساراتهم، ومن ثمّ إعادة توجيهها بشكل إيجابيّ. وهذا يكتسب أهمّيّة خاصّة في ظلّ تراجع التخصّصات الاجتماعيّة والفلسفيّة داخل الجامعات، لحساب تخصّصات تقنيّة أكثر وضوحًا، وهو واقع يستدعي ممارسة ضغط حقيقيّ على الجامعات من أجل تغييره.
- نحن بحاجة إلى تغيير اجتماعيّ ينعكس في المنظومة التربويّة، وفي الوقت نفسه بحاجة إلى تغيير في المنظومة التربويّة من أجل تغيير اجتماعيّ، من أين نبدأ؟
بوضوح، لا بدّ من البدء بتغيير جذريّ في مناهج إعداد المعلّمين في الجامعات، إلى جانب إحداث ثورة في التجمّعات التربويّة. يأتي ذلك في سياق انحسرت فيه أدوار المؤسّسات التربويّة إلى مجرّد تقديم خدمات من خلال مشاريع، من دون رؤية تغيير شاملة. نحن بحاجة إلى مناهج تعاونيّة، وإلى خلق مساحات حواريّة نقديّة مستمرّة تسهم في تجديد الحراكات التربويّة وتحفيز التغيير. على سبيل المثال، شكّلت تجربة الهيئة اللبنانيّة للتاريخ نموذجًا ملهمًا، إذ أعادت الروح إلى معلّمي المادّة، ومنحتهم مساحة للنقاش والتفاعل، فلم يعودوا مجرّد متلقّين ينتظرون الحلول من الخارج، بل أصبحوا فاعلين في سياقهم التعليميّ والمجتمعيّ.
عندما أتحدّث عن مساحات، لا أقصد أن تكون محصورة بين التربويّين فقط، بل يجب أن تشمل إشراك الأهالي والمؤسّسات في حوار شامل، يهدف إلى جسر الهوّة بين الاستراتيجيّات والواقع. وجزء أساسيّ من هذه المساحات يتمثّل في خلق قنوات حوار بين المجتمع والمستويات الرسميّة، مثل وزارة التربية، لتقريب وجهات النظر وتعزيز العمل المشترك، من أجل تحقيق تغيير حقيقي ومستدام.
- تنطلق منهجيّات من شعار "نحو تعليم معاصر"، هل تتوافقين مع الشعار؟ وهل ترين منهجيّات تعمل وفقه؟
الحقيقة أنّ مهمّة منهجيّات ورسالتها في غاية الأهمّيّة، وهو ما يتجسّد في الجهود التي تبذلونها، وفي الأثر الذي سيظهر بطبيعة الحال على المدى الطويل. الفكرة أنّ منهجيّات تسهم في تغيير ثقافة المعلّم، وتدعوه إلى التأمّل في ممارساته والتفكير النقديّ حولها، ومن ثمّ تحويل هذه الأفكار إلى إنتاج كتابيّ يغني الحقل التربويّ.
في هذا السياق، أدعوكم إلى التفكير في إصدار عدد يتناول موضوع النقابات المهنيّة، بهدف إعادة تخيّل الجماعات المهنيّة في قطاع التعليم تحديدًا. قد يكون الخوض في هذه القضايا حافزًا يدفع المعلّمين إلى التفكير ضمن إطار جماعيّ تشاركيّ، يسهم في بناء وعي مهنيّ جديد.

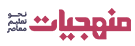


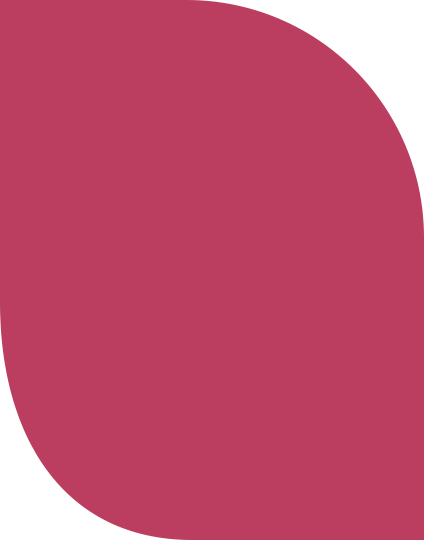

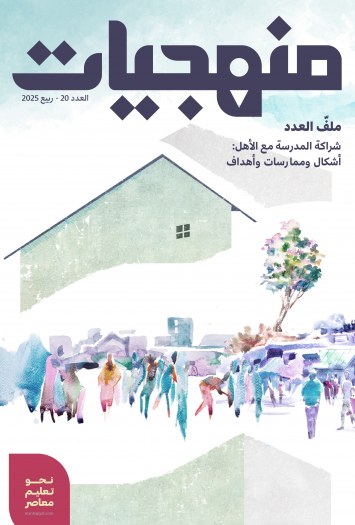






 نشر في عدد (20) ربيع 2025
نشر في عدد (20) ربيع 2025