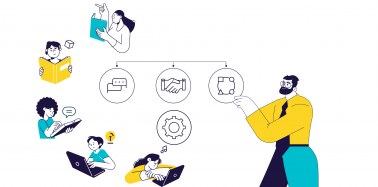قدّم فريري فلسفته التحرّريّة التي جعلت الميدان التربويّ مركّبًا رئيسًا في المجتمع، حيث نادت الفلسفة التحرّريّة بالتغيير الاجتماعيّ القائم على أساس المساواة، وتوظيف الحوار. وانطلاقًا من هذه الرؤية، تعدّ المدرسة استشرافًا لمستقبل المجتمع بعد التغيير. ويقود المعلّم هذا التغيير بالحوار الذي ينشأ حول بؤرة يختارها مع طلبته من حياتهم اليوميّة. يدعو فريري بذلك إلى تعلّم ما يفيد في حلّ المشكلة التي يواجهها الطلبة في مجتمعهم الصغير. فمثل هذا التعلّم، بمختلف مراحله، من حيث السياق الحاضن والتخطيط للتعلّم واقتراح الحلول وتجربتها، بل والتأمّل فيها ودراسة أبعادها، فعلٌ تشاركيّ بين المعلّم والطالب. كما يتّصف هذا التعلّم بأنّه ذو معنى، لارتباطه بالسياق، بل وهو يولد من حاجة ذلك المجتمع برؤية تلك العقول الناشئة.
وبناء على ذلك، وبنظرة أعمق إلى التعلّم التحرّري في إطار المدرسة بصفتها واجهةً تربويّة للمجتمع، لن تكون هناك صفة سيطرة للمعلّم على طلبته في منحى التعلّم، بل سيصبح، لكلا الطرفين، دورٌ في دحرجة عجلة التعلّم بالتبادل. فحالما يلتقط المعلّم (الميسّر النقديّ) مشكلةً من بيئة الطالب، ولو تطرّق إليها عرضيًّا، يبدأ التيسير برسم آليّة تطوير تلك المشكلة، لتصبح حاضنة التعلّم الجديد. ولكنّه، في الوقت ذاته، تعلّم من الطالب (الميسّر الاجتماعيّ)، تعلّم بعض من طبيعة التحدّيات التي يواجهها هذا الطالب، أو مجموعة الطلبة، في سياقهم الحياتيّ، ففي الكثير من الأحيان لا يأتي الطالب والمعلّم من المجتمع ذاته. هذه الإضافة من الطالب إلى المعلّم قد تبدو بسيطة وهامشيّة، لكنّها، في الواقع، مهمّة للغاية لتطوير فهم المعلّم البنية الاجتماعيّة والسياسيّة التي يعمل فيها مع الطالب.
دور التربية التحرّريّة - النقديّة وانتقال المعرفة
يمكن النظر إلى أبعاد أخرى للتربية التحرّريّة الرسميّة أو غير الرسميّة على حدٍّ سواء. فقد تكون المحرّك الرئيس في خلخلة آليّة انتقال تلك المفاهيم الاجتماعيّة، والعمل على تغييرها. ويمثّل الحوار حول سؤال "لماذا عليّ أن أقوم بذلك بهذه الطريقة؟" أو "لماذا يجب أن تسير الأمور بهذه الطريقة؟" ومحاولات الإجابة عنهما، خطوة مهمّة في تحويل الفكر التحرّريّ إلى ممارسة تحرّرية ذات معنى، بل وتضيفُ أبعادًا عميقة إلى تلك المفاهيم. فالتحرّريّة هنا تتعلّق باكتساب المعرفة، وليس بتطبيقها فحسب. فعلى سبيل المثال، لو أنّ فردًا كريمًا بطبيعته، سيكون كريمًا وسعيدًا إذا آمن أنّه لم يمتلك هذا القدر من الرزق (كالمال أو العلم) إلّا ليشاركه مع محيطه؛ فهو مالك لحظيّ لهذا المال، وإن شارك بعضه مع الآخرين، فهو ميسّرٌ المال لهم، لا مستحوذٌ عليه. هنا، تتحوّل ممارسة الكرم باعتباره موروثًا ثقافيًّا فقط، إلى موروث ذي معنى عظيم يتعلّق بفلسفة الكرم العامّة. وفي مرحلةٍ متقدّمة يذوِّت الفرد تلك الفلسفة ضمنيًّا بحسب خبراته، وبنيته القيميّة. ويمثّل فهم الموروث القيميّ فهمًا عميقًا، بكونه جزءًا من الموروث الثقافيّ، سدًّا أمام الحفاظ عليه في ظلّ انتشار وسائل الاتّصال على مستوى العالم.
وإن كانت الدعوة سابقًا إلى تبنّي فهم الموروث الثقافيّ نافلة، فهي في ظلّ العولمة والاجتياح الفكريّ المهول الذي جرّه انتشار وسائل الاتّصال فرضٌ. وإذا استمرّت هذه الممارسات التربويّة العميقة، وأصبحت عادة لدى الفرد، ستنضج لتصبح سلوكًا فرديًّا، ثمّ جمعيًّا من أجل التغيير الاجتماعيّ في مرحلة متقدّمة.
هل التربية التحرّريّة حرّة؟
من غير المنصف الحديث عن التربية التحرّريّة مفهومًا مجرّدًا له السمات ذاتها، وطريقة العمل نفسها. كما أنّها ليست وصفة صالحة للتغيير في كلّ مجتمع. فالتربية التحرّريّة ليست حرّة بالمطلق! بل محكومة بطبيعة المجتمع الذي تنشأ فيه، وطبيعة التحدّيات التي تحكمه، كإيديولوجيا النظام الحاكم وعلاقتها بإيديولوجيا المعلّم وقدرته على التأثير في مدرسته، بل وفي محيطه الاجتماعيّ. فلو افترضنا أنّ معلّمين تبنّيا فلسفة التربية النقديّة مهنيًّا، وأدركا أبعادها، ثمّ عمل أحدهما في بيئة اجتماعيّة تحكمها إيديولوجيا الاستعمار وتستبعد تنوّع الأفكار، بل ولا تقبل من يحملونها. بينما عمل الآخر ضمن مجتمع رأسماليّ قوامه المادّة، وسعى المعلّمان إلى توسيع مدارك الطلبة حول مفهوم من حقوق الإنسان، مثل حقّه في الحركة وحقّه في الوصول إلى أماكن العبادة، فلن يواجه المعلّم الأوّل صعوبةً في إيجاد حالة من بيئة الطلبة، لتحتضن شرارة الفكر التحرّريّ الذي يسعى إلى رسم معالم حقوق الإنسان فيه، وقد يناقش الطلبة مقطعًا متداولًا لشابّ فلسطيني مسيحيّ يصلّي في شوارع القدس في صفوف المسلمين. في هذه الحال أصبح النضال حالة ينطلق منها المعلّم، ليناقش القدرة على فهم مرن للحقّ في الحركة والتنقّل والعبادة، والتعدّديّة الفكريّة التي يحاربها المحتلّ، ليجد متَّسعًا يبني فيه فكرة التعدّديّة فكرةً تحرّريّة مقاوِمة الاحتلال.
أمّا المعلّم الثاني، فمن الحكمة أن يركِّز على الحقّ في المشاركة في الحياة السياسيّة. يقوم المجتمع الرأسماليّ - الليبراليّ على ترسيخ مفاهيم العمل لاستمرار الحياة. لذلك، لا يجد الأفراد متّسعًا للتفكير في قضايا سياسيّة طالما أنّها لا تؤثِّر في دخلهم، وسير حياتهم، وطالما تتكفّل النخبة بمناقشة الحياة السياسيّة واتّخاذ القرارات فيها. فالتحدّي الذي واجهه المعلّم الأوّل انحصار فهم الحرّيّة بالحركة والتنقّل، إذ كان ذلك علّة المجتمع الذي يعيش فيه، كالمجتمع الفلسطينيّ. في حين أنّ علّة المجتمع الثاني، كالمجتمعات الغربيّة عامّةً، هي مشاركة عموم الشعب في الحياة السياسيّة. وهنا يظهر التفاعل الذي أسعى إلى توضيح أهمّيّة فهم المعلّمين له، ولا سيّما الذين يتبنّون الفكر التحرّريّ فلسفةً مهنيّة في التعليم، وأداةً لتغيير المجتمع.
ما دور المعلّم في رعاية التغيير؟
يؤدّي فهم المعلّم دورًا مهمًّا في قدرته على توقّع طبيعة التفاعل الذي ينشأ إذا ما تبنّى الفكر التحرّريّ والتربية النقديّة، أدواتٍ لتغيير الواقع الاجتماعيّ والسياسيّ أحيانًا. ونقطة أخرى لا بدّ من الإشارة إليها، وقد تبدو واضحة ضمنًا لدى الكثير من المعلّمين، وهي أنّ مهمّة المعلّم تكمن في إعداد جيل ليعيش غده بمعطياته، حيث يصبح اليوم ماضيه. هذا يناقض بالضرورة تقديم المفاهيم على أنّها ثابتة، إذ ما يصلح اليوم قد لا يصلح غدًا. لكن، علينا أن نؤكِّد هنا مرّة أخرى، أنّ هنالك فرقًا بين المعلّم الذي يدفع طلبته إلى تبنّي المعرفة بشكلها الثابت، والذي قد تؤثِّر فيه ولا يؤثِّر فيها، وبين معلّم يخطِّط مع طلبته ليصلوا إلى المعرفة، وكأنّهم اخترعوها، ليحلّوا بها مشكلتهم. ففي الحالة الأولى، تكون المعرفة بنكيّة تقليديّة، أمّا في الحالة الثانية فالمعرفة أداة تغيير في السياق الاجتماعيّ، كما أنّها متأصّلة لدى الطالب، وغير مرتبطة بالسياق الذي ولدت فيه فحسب، بل قابلة للتفعيل وتغيير ثوبها في سياقات اجتماعيّة مستقبليّة ومتباينة.
فهم المعلّم العميق طبيعة هذا التفاعل بين مفهوم التربية التحرّريّة والبيئة الاجتماعيّة - السياسيّة، يدعم دعمًا مباشرًا تأصيل الفكر التربويّ التحرّريّ في مجتمع المدرسة كوحدة بنائيّة في المجتمع، على أن يتمدّد أفقيًّا ليغطّي الأسرة ومجتمعات الطالب المصغّرة، وليشمل عموديًّا بقيّة مؤسّسات الدولة. ففعّاليّة هذا التفاعل وسلاسته يعتمدان كثيرًا على قدرة المعلّم على طرح الأسئلة الصادمة، والتي تدعو الطلبة إلى تخطّي المخاوف الداخليّة من طرح الأفكار ومناقشتها، والأهمّ من ذلك عدم مراقبة عقولنا، وطرح أفكارنا للحوار وصولّا إلى الارتقاء بها إلى سلوك فرديّ، ثمّ مجتمعيّ؛ ممّا يعني التغيير الاجتماعيّ أو السياسيّ. ومن الاستراتيجيّات الأخرى التي من الممكن للمعلّم أن يوظّفها في إطار التربية النقديّة، إخضاع ما يطرحه الإعلام للمنطق قبل اعتناقه وقبوله. كما إنّ طرح الأسئلة المفتوحة، وتعزيز لغة الحوار في مجتمع الطلبة، وقبول فكر الآخر تساعد على تبنّي الأفكار التحرّريةّ وتعزيز الوعي الناقد لدى جيل المستقبل.
كيف تتفاعل المجتمعات التربويّة مع التربية التحرّريّة - النقديّة؟
أخلص ممّا تقدّم إلى أنّ تعليم المقهورين يستلزم بالضرورة معلّمًا شُفي من كونه مقهورًا، وآمن بالفكر التحرّريّ، ثمّ أدرك جيّدًا طبيعة المجتمع الذي يعيش فيه طلبته. أي أنّه كان قادرًا على قراءة التحدّيات التي تسيطر على المجتمع وتخنقه. يصبح المعلّم قادرًا على تبنّي حوار محفِّز، وقادر على توقّع طبيعة التفاعل بين الافكار التحرّريّة والبيئة الاجتماعيّة. قد يكون لهذه التوقّعات دور حاسم في إنبات أفكار يعتبرها المجتمع انقلابيّة، ويوفِّر لها مقوّمات النجاح. فالتوقّعات الجيّدة هنا تُخرِج مارد الأفكار المتقوقعة في أعماق فكر الطلبة، وتعمل على التخطيط لمرحلة العمل في أكثر من سيناريو، وقد يكون بعض هذه السيناريوهات متطرّفًا. وهنا، لا بدّ من النظر إلى الحلقة الأوسع؛ مجتمع المعلّمين. صحيح أنّ فكرة التغيير الاجتماعيّ القائم على الفكر التحرّري فرديّة في النهاية، إلّا أنّ مجتمع المعلّمين مجتمع قد يشكِّل حاضنة الفكر التربويّ التحرّريّ. وعلى الطرف المقابل، قد يكون مجتمع المعلّمين متناقضًا، فيطفئ أيّ شرارة لتوظيف الفكر التحرّريّ في مجتمع المدرسة، سواء على صعيد الطلبة، أم على صعيد المعلّمين. إذًا، الفكر التحرّريّ قد يظهر جليًّا على مستوى أعلى من مستوى الطلبة، وفي هذه المرّة يظهر صراع الإيديولوجيّات قويًّا بين المعلّمين، وتتدخّل فيه العديد من المتغيّرات، كالنظام الإداريّ في المدرسة، وعلاقة المدرسة بمجتمعها المحلّيّ، وطبيعة العلاقة بين العناصر الهيكليّة في المنظومة التربويّة. كما يكون هناك دور كبير لطبيعة العلاقة بين إيديولوجيا النظام الحاكم والمؤسّسة التربويّة. في جميع الأحوال، يلزم التغييرَ الاجتماعيّ فعلٌ جمعيّ ثوريّ، لا يأتي بلا فكرة تنمو فرديّة عند معلّم اختار أن يقود التغيير، وأن ينقله إلى مجتمع المعلّمين. وبدورهم يسعون إلى خلق مجتمع جمعيّ ثوريّ صلب يسعى إلى التغلّب على التحدّيات القاهرة في المجتمع.
وبقدرِ عمق فهم المعلّم طبيعة المجتمع وبيئته وطبيعة طلّابه كذلك، يكون قادرًا على إشعال الشرارة أو الشرارات في الوقت والظرف التعليميّين المناسبين. وهنا، يبدأ العمل على احتضان التفاعل الناشئ من هذا الانفجار الفكريّ ورعايته، ليصبح فعلًا أو سلوكًا اجتماعيًّا، ويشكِّل لبنة في بنية اجتماعيّة جديدة. ويبدو أنّ على المؤسّسة التربويّة أن تأخذ القرار بتبنّي التربية النقديّة طابعًا ثابتًا في مشاريعها، وفي أيّ تدريب للمعلّمين في المرحلة القادمة. كما أنّ إبراز قصص النجاح في مجال التربية النقديّة، وتسليط الضوء على مخرجات تلك التجارب، يعدُّ رافعة ناجحة لتغيير الوضع الاجتماعيّ والسياسيّ المدروس.
* * *
الكثير ممّن كانوا طلبة مقهورين، نجحوا اليوم في التخلّص من القيود الفكريّة، وذلك ليس أمرًا على الهامش مطلقًا، بل في صلب التجربة، ومن أهمّ مخرجاتها. وعلى الرغم من تعدّد أمثلة النجاح الحيّة، إلّا أنّها لا تشكّل بالضرورة إثباتًا لقدرة التربية التحرّريّة على التغيير الاجتماعيّ. ولكن بالإمكان النظر إلى أنّ الأفكار الثوريّة الموجودة في أعماق الكثيرين، بذرة يمكن الاستثمار فيها لخلق واقع اجتماعيّ جديد. فقيود الخوف والمراقبة الذاتيّة تمنع هذه الفكرة من التضخّم في الواقع، بل حتّى الخروج من العقول إلى ساحة الحوار. وهنا، يأتي دور التربية التحرّريّة - النقديّة التي تشجّع، بل تدفع، صاحب الفكرة إلى تحطيم قيود الخوف، وإطلاق العنان للفكرة. فتصقلها التربية النقديّة وتدعمها لتخرج من كونها احتمالًا إلى حقيقة فرضت نفسها على الواقع... لقد بدأ للتوّ واقع جديد.













 نشر في عدد (18) خريف 2024
نشر في عدد (18) خريف 2024