بين أيديكم العدد العشرون من منهجيّات، وهو عدد استثنائيّ بكلّ معنى الكلمة، من حيث عدد المقالات المشاركة فيه، ومواضيعها ورؤاها التي قاربت موضوع الملفّ والمواضيع التربويّة العامّة: ثلاث عشرة مقالة في ملفّ "شراكة المدرسة مع الأهل: أشكال وممارسات وأهداف"، أنهكت الموضوع بحثًا وتأمّلًا وتحليلًا. وتسع مقالات عامّة تشارك المعرفة والخبرات، فتعزّز رسالة منهجيّات في تحوّلها منصّةَ التربويّ العربيّ الجامعة.
بالعودة إلى موضوع الشراكة بين الأهل والمدرسة، طرحت منهجيّات هذا الموضوع لخطورته، والتي يشكّل الاعتقاد السائد بأنّ "العلاقة الطبيعيّة" بين الأهل والمدرسة، تكمن في سؤال الأهل عن أبنائهم وتحصيلهم وسلوكهم، وحضور بعض الاجتماعات مع المعلّمين. في هذا الاعتقاد تنمو إشكاليّتان مقلقتان:
- - الأولى تتجسّد في تخلّي الأهل عن حقّهم في مشاركة تخطيط تعلّم أبنائهم، وترك الأمر لإدارات المدارس. وهنا نقع في إشكاليّات نوع المدرسة، وتوجّهها، ومنهجها المُعتمد، وقدراتها، وغير ذلك ممّا يبني شخصيّة المتعلّمين، وربّما يتحكّم في مستقبلهم وسلوكهم اللاحق.
- - أمّا الثانية، فتكون في انفصال المدرسة عن محيطها، واختيارها منفردة ما يصل إلى أيديها من توجّهات ومناهج ومقاربات قد لا تكون بالضرورة مرتبطة بالمحيط الاجتماعيّ، ما ينمّي شعور الاغتراب في نفوس المتعلّمين، والذين يطّلعون على عالم مختلف عن بيئاتهم المتنوّعة. أضف إلى ما يشكّل ذلك من هدر لطاقات وتجارب اجتماعيّة يمكن للأهل أن ينقلوها إلى مجموع المتعلّمين، وذلك بورشات عمل ومحاضرات وأنشطة، تربط المتعلّمين بحيواتهم الحقيقيّة لا المتخيّلة، ولا سيّما مع واقع عيش المتعلّمين حيوات افتراضيّة في هواتفهم.
لم يكن الموضوع بسيطًا، وغزارة المشاركة فيه تدلّ على ذلك. لكن، ومع هذه الغزارة، لا نستطيع أن نقول إنّنا حللنا الإشكاليّة؛ من هنا نكتفي بالقول إنّنا نقرع الأبواب وبقوّة، وهذا دأب منهجيّات الدائم.
في مواضيع الملفّ، نقرأ عن: أهمّيّة شراكة أولياء الأمور في تعلّم أبنائهم وتعليمهم، لجمانة خروف حزبون؛ والآثار الإيجابيّة لعلاقة الأهل الوطيدة بالمدرسة في المتعلّمين، لنورا مرعي؛ وأشكال العلاقة بين الأهل والمدرسة وتأثيراتها، لمحمّد الزعبيّ؛ ودور الأهل في إعادة التوازن إلى سياسات المدرسة التجاريّة، لسحر درويش؛ واختلاف أشكال علاقة الأهل والمدرسة بين مدارس الأرياف والمدن، لمحمّد جمال صالح محمّد؛ وأثر هذه العلاقة في تحسين أوضاع الطلّاب ذوي الاحتياجات الخاصّة، لياسمين حسن؛ وموضوع حسّاس يتناول توعية الأهل في مفهوم اللغة الأولى ومعلّميها، لسابين عريسي؛ ودور الأهل في إعادة تعريف الدور التربويّ للمدرسة، لمحمّد المستاري؛ وعرض للتجربة اليابانيّة في علاقة الأهل والمدرسة، لربيع زعيميّة؛ وتفصيل أدوار جمعيّة أولياء التلاميذ في تعزيز العمليّة التعليميّة، لشيرين سوداح؛ وتفصيل أشكال العلاقة بين الأهل والمدرسة، لمنتهى البلويّ؛ وعرض لقوانين "مجالس الآباء" في مصر وأدوارها، لهاني عيّاد؛ وبحث في الاستراتيجيّات التعاونيّة بين المدرسة والأهل، لماهر منصور.
أمّا المقالات العامّة فقد انقسمت إلى قسمين. الأوّل تأمّلات التربويّات والتربويّين المعتادة، حيث نقرأ: "إشرافنا التربويّ وثقافة الاستيراد" لفهد الهاني؛ و"المهارات الحياتيّة: جسر نحو مستقبل مشرق" لبثينة مرعي؛ و"التغذية الراجعة البنائيّة: صوتُ المتعلّم في تطوير تعلّمه" لشذا حمدان؛ و"تأمّلات معلّمة: الدراما منهجًا لتعليم العربيّة" لآلاء حميدة؛ إضافة إلى أصداء الدردشة التي تناولت موضوع دور الإدارة المدرسيّة في تطوير التعليم. أمّا القسم الثاني، فهو أربعة أوراق مقدّمة من تربويّي فلسطين، شاركوها في الجلسة التي نظّمتها منهجيّات في "المنتدى السنويّ لفلسطين- 2025"، والتي نظّمها المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات ومؤسّسة الدراسات الفلسطينيّة. قدّم الأوراق كلّ من: أسماء مصطفى، أحمد عاشور، ريام كفري – أبو لبن، رفعت الصبّاح ويارا عوّاد. من غير أن ننسى المحاورة الملهمة مع الدكتورة مها شعيب، وأبواب المجلّة الثابتة.
تكبر منهجيّات عددًا إثر عدد، وهذا يعني مسؤوليّة أكبر تجاه التربويّات والتربويّين العرب، ويعني أيضًا تعاظم مسؤوليّتهم بدورهم؛ فإذا كان اتّفاقنا أنّ التربيّة والتعليم هما الركن الأخطر في تطوير العالم العربيّ، فإنّنا نقوم بدورنا، وننتظر شركاءنا لحمل هذا العبء معنا.

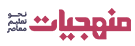


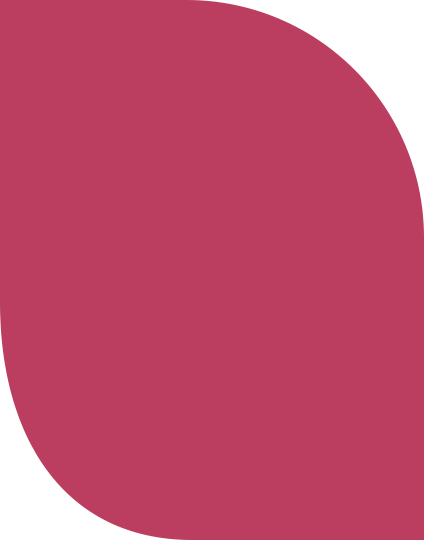

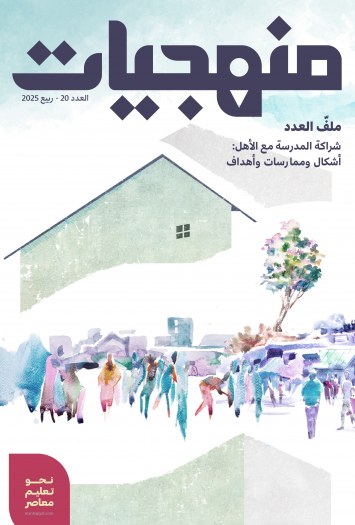






 نشر في عدد (20) ربيع 2025
نشر في عدد (20) ربيع 2025