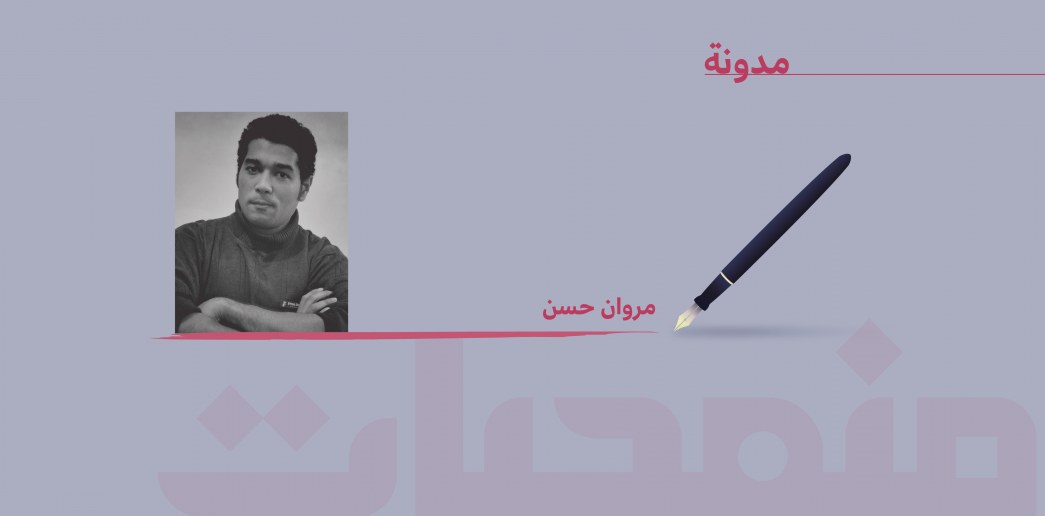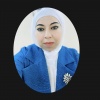تتمثّل ظاهرة الدروس الخصوصيّة في تقديم تعليم فرديّ أو جماعيّ للطلّاب خارج إطار المدرسة، أو المؤسّسة التعليميّة الرسميّة. انتشرت هذه الظاهرة في عديدٍ من البلدان حول العالم، واكتسبت شعبيّة كبيرة في وطننا العربيّ لدى أولياء الأمور الذين يسعون لتعزيز قدرات أبنائهم، أو تحسين نتائجهم الدراسيّة. وفي رأيي، بدأت هذه الظاهرة لتحقيق أهداف إيجابيّة تركّز على مصلحة الطلّاب، منها:
- - تعزيز أداء الطلّاب الأكاديميّ، إذ يحصلون على تعليم إضافيّ يقوّي لديهم المفهومات والمهارات الأكاديميّة.
- - تلبية احتياجات الطلّاب الفرديّة، إذ يحدّد المعلّم نقاط القوّة والضعف لكلّ طالب في المجموعة، ويقدّم لهم توجيهًا أو مساعدةً.
- - مساعدة الطلّاب على التحضير للاختبارات الصعبة، والامتحانات الهامّة، لذا نرى أولياء الأمور يصرّون على إلحاق أبنائهم بالدروس الخصوصيّة في المراحل الدراسيّة الحاسمة، كالإعداديّة والثانويّة العامّة، للقيام بممارسات إضافيّة تزيد من فرص نجاح أبنائهم في الاختبارات.
- - أخيرًا، تعويض النقص الحاصل في التعليم العامّ. وهُنا نتحدث عن مشكلات تعليمنا في الوطن العربيّ، كضعف إمكانات المعلّم، وقدرته على الشرح. أو التضارب الموجود في بعض الكتب المدرسيّة، وسوء تفسير المفهومات أو الموضوعات، الأمر الذي يقتضي الالتحاق بالدروس الخصوصيّة، والاعتماد على الكتب الخارجيّة.
ومع ذلك، تثير الدروس الخصوصيّة انتقادات ومخاوف كثيرة. كما يُمكن أن تزيد الدروس الخصوصيّة من الضغط والتوتّر على الطلّاب؛ فقد يشعرون أنّهم بحاجة إلى تحقيق نتائج مثاليّة في دروسهم الخصوصيّة، بالإضافة إلى دروسهم المدرسيّة العاديّة، ما يؤدّي إلى تدهور صحّتهم النفسيّة، وتقليل متعة التعلّم.
علاوة على ذلك، تؤثّر الدروس الخصوصيّة في دور المعلّم والمدرسة في تقديم التعليم العامّ، إذ يسبّب انتشار الدروس الخصوصيّة في انحسار الدعم العامّ لنظام التعليم، وتقليل الاهتمام بتحسين جودة التعليم العامّ، ما انعكس سلبًا على المعلّم، وخلق "المعلّم المفرط في الدروس الخصوصيّة".
وهنا، عزيزي القارئ، نتحدّث عن فئة كبيرة من معلّمي اليوم، ليس تعميمًا، اتّخذوا من مهنة التدريس تجارة، فتخلّوا عن لقب المعلّم وأصبحوا تجّارًا. وباتت الدروس الخصوصيّة بالنسبة إليهم أمرًا تجاريًّا، يتضمّن تبادلًا ماليًّا بين المعلّم والطالب. وما أكثر الساعين وراء الأموال، يظهرون جشعًا في تقديم الدروس الخصوصيّة بحجّة تدنّي الأجور، وظروف العمل السيّئة التي تجعل من الصعب عليهم البقاء ملتزمين بمهنتهم. وهذا سلوك غير أخلاقيّ، ويتعارض مع مبادئ التعليم الجيّد.
وأودّ أن أشير إلى أنّ أحد الجوانب السلبيّة للدروس الخصوصيّة تأثيرها في العدالة التعليميّة، فلكلّ معلّم سعر يختلف عن أقرانه، ويُقيّم المعلّم بسعره، فتصبح الدروس الخصوصيّة متاحة لمن يمتلك القدرة الماليّة من الطلّاب على تحمّل تكاليف المعلّم. وهذا يعني أنّ الطلّاب الأقلّ حظًّا اقتصاديًّا يفتقرون إلى فرص الحصول على التعليم الإضافيّ، والذي يمكن أن يساعدهم على تعزيز أدائهم الأكاديميّ.
فضلًا عن تقديم دروس خصوصيّة ذات جودة متدنّية، المعلّمون الذين يسعون وراء الأرباح الماليّة في المقام الأوّل، لا يهتمّون بتلبية احتياجات الطلّاب بشكل فعّال، أو الاستجابة إلى تحدّياتهم الفرديّة. كما يقدّمونَ الدروس الخصوصيّة بسرعة، وبشكل غير مرتبط بالمنهاج الدراسيّ الرسميّ، ما يؤدّي إلى تشويه فهم الطلّاب، والتأثير سلبًا في تقدّمهم الأكاديميّ.
ينعكس الأمر سلبًا على المعلّم المفرط في الدروس الخصوصيّة نفسه، ويظهر ذلك في ما يأتي:
- - تراجع أدائه التعليميّ في المدرسة، إذ يفتقر إلى الوقت والطاقة للتحضير الجيّد للدروس، وتقديمها بشكل ملائم.
- - التركيز على استقطاب أكبر عدد من الطلّاب للالتحاق بالدروس الخصوصيّة غالبًا ما يؤدّي إلى إهمال الجانب التعليميّ، فينصبّ تركيز المعلّم على العدد بدلًا من التركيز على تلبية احتياجات كلّ طالب على حدةٍ، ما يؤثر في جودة التعليم، وفهم الطلّاب للموادّ.
- - يواجه المعلّم المفرط في الدروس الخصوصيّة صعوبة في إيجاد التوازن بين الحياة المهنيّة والشخصيّة، إذ يفتقر للوقت الكافي للراحة، أو ممارسة هواياته، أو التنمية الذاتيّة المستمرّة، ما يؤثر في جودة حياته الشخصيّة بشكل عامّ، فضلًا عن قضائه ساعات إضافيّة خارج المدرسة، وهذا يقلّل وقته المتاح للتفاعل مع العائلة والأصدقاء.
- - وأخيرًا، الإرهاق والإجهاد المستمرّين، كونه يعمل بشكل يوميّ في المدرسة، ثم يخصّص ما تبقى من اليوم للدروس الخصوصيّة، وقد يؤدّي ذلك إلى تدهور حالته الصحّيّة والعقليّة.
خلاصة القول، لم تعد الدروس الخصوصيّة مجرد ظاهرة، بل أمرًا واقعًا وملموسًا لا تمكننا محاربته بسهولة، على الرغم من المناداة الدائمة بضرورة تدخّل الحكومات والعمل على تغيير هذه الوضعيّة، وإعادة الاحترام والقيمة لمهنة التدريس، وزيادة الاستثمار في التعليم، وتحسين أوضاع العمل للمعلّمين، من أجل جذب الكفاءات، والحفاظ عليها. ولكن لا حياة لمن تنادي، ويبقى كلّ ما نأمله في الإصلاح مجرّد خواطر عابرة.