- - حاصل على دكتوراه الدولة في علم النفس.
- - أستاذ فخريّ (emeritus professor) في علم النفس وعلوم التربية/ جامعة محمد الخامس، الرباط/ المغرب.
- - خبير دولي لدى المنظّمات التي تُعنى بقضايا التربية والتكوين (اليونيسكو/الألكسو/ الإسيسكو)، وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي (UNDP).
- - عضو الفريق المركزيّ لتقرير المعرفة العربي (2011، 2014)، وتقرير مؤشر القراءة العربي، (2016).
- - مدير ومؤسّس مجلّة علوم التربية.
- - مؤلّف العديد من الكنب والمقالات العلميّة في مجال السيكولوجيا والتربية، إلى جانب معاجم مختصّة في علوم التربية.
- - أشرف وأنجز العديد من دورات تكوين المعلّمين في دول عربيّة عدّة.
-
- فلنبدأ من مساهماتك النظريّة والبحوث التي عملت عليها، ثمّة تركيز في اشتغالاتك على تطوير عمل المعلّمين. كيف أثّرت أبحاثك في إفادة المعلّمين وتطوير عملهم؟
حاولت منذ بداية اهتمامي الأكاديميّ توجيه جهودي نحو توعية العاملين في التعليم، على قاعدة أنّ المعلّم الكفء له دور كبير في العمليّة التعلّميّة بصفته العنصر الأساس في تكوين رأس المال البشريّ. خاصّة إن كان يولي اهتمامًا للابتكار والإبداع والخلق، فالإبداع هو عملة هذا العصر. لذلك حاولت وأحاول المساهمة في تكوين المعلّم والأستاذ الكفء.
كانت بدايتي الأكاديميّة بمحاولة بناء قاعدة علميّة تنطلق من الطفل أو المتعلّم باعتباره مركز العمليّة التعلّميّة. لذلك بدأت بدراستي المشغولة بما هي صورة الطفل في المجتمع، وما هو التمثّل الذي يكوّنه العاملون مع الأطفال عنهم؟ لأنه إن لم يكن تمثّلًا صحيحًا ويمثّل الطفل على حقيقته، فسنتعامل مع الطفل تعاملًا غير مناسب. والتمثّل عبارة عن الصورة، على أنّ التمثّل يدخل فيه العنصر الاجتماعيّ، أي تأثيرات المجتمع والثقافة، في حين أنّ الصورة ذهنيّة. حاولت أن أجري دراسات حول صورة الطفل في المجتمع المغربيّ، ووجدت أنّ الصورة غير صحيحة، فحاولت أن أوجّه طلابي للاهتمام بهذا الجانب. فالطفل ليس راشدًا مصغّرًا كما يعتقد البعض، بل له تفكيره الخاصّ وحاجاته الخاصّة التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار.
حاولت كذلك أن أبيّن للمشتغلات والمشتغلين بالتعليم أنّ الطفل يزخر بالعديد من الإمكانات والقدرات التي ينبغي أن نكتشفها ونستثمرها في تربيته وتعليمه. لذلك وبعد الدراسات الأولى حول الطفل وتمثّله والتي خصّصت لها كتابًا هو " الطفل والمجتمع"، جاءت دراسة أخرى حول سيكولوجيّة الطفل، وكيف ينظر إليه علماء النفس حسب مشاربهم المختلفة وتخصّصاتهم المتنوّعة. ووجدت أنّ الطفل يزخر بالعديد من القدرات التي لا تستثمر في الحقيقة، فيضيع المجتمع.
بعد ذلك انتقلت للاهتمام بتكوين المعلّم لكي يتعرّف على الطفل معرفة علميّة دقيقة، ليس وفق علم نفس الطفل وعلم نفس النموّ وعلم النفس المعرفيّ فحسب، وإنّما أيضًا من خلال جانب علميّ حديث وهو علوم الأعصاب التربويّة، التي تبيّن لنا كيف تتمّ عمليّة التعلّم، وتبصّرنا بطبيعة الطفل. وهنا حاولت أن أوجّه اهتمامي نحو تغيير الصورة التي لدينا عن ذكاء الطفل. فمنذ ألفريد بينه (A. Binet) يشاع أنّ للطفل ذكاء واحدًا، وأنّ هذا الذكاء يولد به الطفل. فإذا بالأبحاث العلميّة في علم النفس المعرفيّ في أواخر القرن الماضي تبيّن أنّ كلّ طفل يولد بمجموعة من الذكاءات، تسعة ذكاءات على الأقل حسب هاورد غاردنر .(H. Gardner)
في التعليم التقليديّ نهتمّ ببيداغوجيّة الذكاء الواحد، والحال أنّ الذكاءات عديدة، والصفّ الواحد يضمّ مجموعة من الأطفال غير المتجانسين في ما يتعلّق بأسلوب تعلّمهم. لذلك يجب أن يتعلّم الطالب وفق ذكائه، إن كان ذكاء لغويًّا أو منطقيًّا أو موسيقيًّا.. إلخ. كلّ طفل له جسر خاصّ للمعرفة والتعلّم، لذلك ينبغي للمدرّس أن يعرف الطفل بطريقة جيدة، ولذلك لا يمكن أن نعلّم طفلًا لا نعرفه، لا بدّ أن نعرف من نعلّم، فلا أستطيع أن أهيئ درسًا أو نشاطًا تربويًّا وأنا لا أعرف لمن أوجّهه.
لقد ألححت على معرفة المتعلّم، وكانت لي كتب في هذا المجال، وبصورة خاصّة ما يتعلق بالمراهق، لأنّ المعلّم يواجه صعوبة في تعليم المراهق ما لم يعرف سيكولوجيّة المراهقة وحاجات المراهق، ولكلّ من المتعلّمين حسب شخصيّتهم وحاجاتهم وعمرهم أسلوب خاصّ في التعليم والتعلّم. وطوال عقدين من الزمان وأنا مهتمّ بنظريّة الذكاءات المتعدّدة، وقدّمت ورشات عديدة عربيًّا، في محاولة أن أجعل المعلّم يبصر ما لدى الطفل من إمكانيات وذكاءات.
-
- بماذا يجب أن نُعنى أيضًا في ما يتعلّق بتطوير المعلّم، إلى جانب الشقّ الديداكتيكيّ؟
مع الأسف كثيرًا ما ينصبّ التركيز في تكوين المعلّمين على جانب المادّة التي يدرّسونها، أي الجانب الديداكتيكيّ، والحال أنّ هناك جانبًا آخر أساسيًّا هو المتعلّم. فكثيرًا ما نتساءل عمّا ينبغي تعليمه للمتعلّمين، والصحيح أن نتساءل عن ماذا بوسع المتعلّمين أن يتعلموا؟ ما هي قدراتهم وما هي حاجاتهم وما هي استعداداتهم؟ ليس أن نفكّر فقط في المنهاج الدراسيّ. لذلك أجد أنّ الكثير من المشكلات التي تعاني منها المنظومة التعلميّة أساسها عدم وجود تواصل بين المتعلّم والمعلّم.
أعطي مثالًا من دراسة أجريتها استخدمت فيها اختبارات إسقاطية من خلال طرح جملة تقول: "عندما أرى الأستاذ قادمًا..."، وطلبت من الطلّاب أن يكملوا الجملة. أجاب معظم الطلاب إجابات شبيهة بـ"عندما أرى الأستاذ قادمًا كأنّني أرى السجّان" وفي جملة أخرى نجد ما معناه أنّ " الأساتذة جبال لا يمكن ارتقاؤها".
هذه صورة سيئة عن المعلّم تبيّن غياب التواصل والانسجام بين المعلّم والمتعلّم. إنّ المتعلّم لا يمكنه أن يتعلّم ويعالج المعلومات ما لم نوفر له مناخًا نفسيًّا يشعر فيه بالراحة، فهذا ما تؤكده مختلف الدراسات العلميّة.
في العمليّة التعليميّة لا يستطيع المتعلّم أن يكتفي بالمعلومات أو أن يعالجها في دماغه ما لم يكن مرتاحًا، وهذا الارتياح يكون عندما نهيئ مناخًا نفسيًّا ملائمًا يجعل المتعلّم يحبّ العمليّة التعليميّة والمادّة التي يتعلّمها. نحن نقدّم المادّة بصورة غير سويّة، ولا نحاول أن نوقظ في المتعلّم حبّ المعرفة لذاتها. وهذا هو المشكل الكبير، فكثيرًا ما نجعل المواد الدراسيّة وسيلة للنجاح في المدرسة وحسب. كان اليونانيون يطلبون العلوم لذاتها، لا باعتبارها وسيلة، وهذا ما جعلهم ينبغون في مختلف العلوم. يجب أن نوقظ في المتعلّم الرغبة في المعرفة لذاتها. منذ الدرس الأول على المعلّم أن يوقظ في الطالب حبّ المعرفة. وتكوين المدرّس يحتاج لهذه الجوانب لا التكوين المهنيّ فقط، وعليه أن يعرف أساليب تقديم المادّة الدراسيّة باستخدام الأساليب البيداغوجيّة الفعّالة.
تلعب الانفعالات مثلًا دورًا كبيرًا في العمليّة التعليميّة، فإذا لم يكن هناك تواصل إنسانيّ لا يتمّ التعلّم. ومن هنا مأخذنا على التعليم عن بعد، واستخدام الآلة بدلًا من الإنسان في التعليم. لذلك فالمحدّدات الأساسيّة في نظري هي: التكوين المهنيّ والسيكولوجيّ والبيداغوجيّ، مع الإلمام بثقافة المجتمع ومنتظراته من التعليم.
مثلًا لا نكوّن المعلّم اليوم في مراكز ومعاهد تكوين المعلّمين على كيفيّة التواصل مع الأسرة، وكيف يقيم جسور التواصل معها بما يخدم الطفل وحاجاته، فالأسرة شريك أساسيّ في العمليّة التعليميّة والتربويّة. مع الجائحة أصبح الأهل ملزمين بأن يتعرّفوا على ماذا يتعلّم أبناؤهم وبالتالي مساعدتهم. ولا بدّ من وجود معلومات ومعارف تحاول أن تبصّر المعلّم عن أسرة الطفل ليكوّن عن الطفل فكرة وافية.
-
- حاليًّا هناك حديث كثير عن الجانب العاطفيّ الاجتماعيّ في التعلّم، هل طروحاتك متّصلة بهذا الجانب من التعليم؟
أجريت بعض الدراسات عن ماضي بعض المتعلّمين بعد أن أصبحوا راشدين. كنت أسألهم عن المعلّم الذي لم يستطيعوا نسيانه؟ الكثير قالوا هو المعلّم الذي كان يعاملنا كأب، أو الذي كنّا نسأله عن أشياء تخصّنا. وغالبًا ما يكون المتعلّم الذي ينجح ويواصل دراسته ويجري أبحاثه، هو ذلك الطالب الذي كانت علاقته مع معلّمه علاقة إنسانيّة. وهذا الجانب الإنسانيّ العلائقيّ هو المفقود في أنماط التعليم المعتمدة على التكنولوجيا والآلة. في بعض الثقافات يسمّى المعلّم بالأب الثالث، لأنه يوفّر جوانب مكمّلة للأم والأب. وأحيانًا يغيب دور الآباء في العمليّة التعليميّة، ومن حسن حظّ الطالب أن يلتقي مع معلّم يجسر هذه الفجوة. لذلك يظلّ للمعلّم الدور الإنسانيّ العلائقيّ، لأنّ عمليّة التربيّة والتعليم ليست مجرد تقديم معارف، بل علاقة إنسانيّة فيها تعاطف وانفعالات.
-
- حتى لا نضع المسؤوليّة كلّها على كاهل المعلّم، كيف نعنى بشؤون المعلّم نفسه واحتياجاته، ما الذي يحتاجه المعلّم غير التكوين المهنيّ؟
بالطبع نهتمّ به أوّلًا عن طريق مراجعة صورتنا عنه في المجتمع ومراجعة تعاملنا معه. المعلّم اليوم بحاجة للاعتراف بالجهد الذي يقدّمه، فهو يتولّى أدوارًا عديدة ومختلفة. هذه المهنة مختلفة عن المهن الأخرى، لذلك المعلّم مسؤول أمام الوزارة وأمام الأسرة وأمام المجتمع وأمام الضمير الأخلاقيّ، ولا يمكن لأيّ شخص أن يتحمّل هذه المسؤوليّة المركّبة والمعقّدة. والكثير من وزارات التعليم للأسف جعلت مهنة التعليم بغير أسوار، تقبل أيّ شخص دون أن تبحث عن استعداده وحبّه لهذه المهنة. فإن لم يكن لديه الاستعداد سيتعب نفسه وطلّابه معًا.
وكذلك المقابل الذي يأخذه المعلّم لقاء هذه الأدوار كلّها، علينا أن نحسّن وضعيّته ماديًّا ومهنيًّا وأخلاقيًّا، وأن نوفر له مناخًا يدفعه ويحفّزه على العمل. حاليًّا هناك دول تحاول أن تجعل التعليم مهنة تعاقديًّة، ينهي المعلّم عمله وينتهي الأمر، وهذا غير مطمئن للمعلّم ولا يدفعه للعطاء. يجب توفير حاجات المعلّم كلّها حتى يتفرّغ للعطاء.
-
- كيف ترى مستقبل التعليم في العالم العربيّ بعد جائحة كورونا؟ كنت كتبت أنّنا أمام خيارين/ إمّا التطوير أو التخلّف.
المستقبل ليس شيئًا بعيدًا عنّا، المستقبل يبدأ الآن. نستطيع أن نستشرف المستقبل بناء على الحاضر. نحن نعيش في القرن الحادي والعشرين وهذا قرن يحوي عناصر تختلف عن كلّ ما عاشته البشريّة من قبل، العولمة مثلًا، والمعرفة المتضخّمة والمتدفّقة، وهناك اقتصاد المعرفة، والثورة الصناعيّة الرابعة وما جاءت به من تكنولوجيّات لم تعد هناك فواصل بينها، التكنولوجيا الحيويّة والرقميّة والفيزيائيّة. يضاف إلى هذه العناصر الجديدة التي تسم عصرنا، كوفيد 19 الذي أثّر تأثيرًا كبيرًا على العالم كلّه.
بيّنت اليونسكو أن نسبة كبيرة من الأطفال في الدول النامية لم تستطع متابعة التعليم لأنّه تعوزها أدوات التكنولوجيا. في حين أنّ الدول المتقدّمة استطاعت أن ترتبط بالتعليم خلال الوباء وتحوّل المدرسة إلى البيت. والآباء في الدول النامية لم يستطيعوا مسايرة تعليم أبنائهم، لذلك تفاقمت ظاهرة الهدر المدرسيّ والفاقد التعليميّ. وتحاول الكثير من الدول اليوم معالجة هذه الظاهرة.
نستطيع القول إنّ الدول العربيّة عرفت العديد من الفجوات الحضاريّة مقارنة مع دول العالم المتقدّمة، ولم تستطع أن تجسر معظم هذه الفجوات. نتحدث هنا عن فجوات معرفيّة ورقميّة واقتصاديّة ثم جاء كوفيد 19. ولكن يبقى مع ذلك أنّ الحلّ والأمل في التربية والتعليم. فعلى هذه الدول أن تراجع برامحها ونظمها التعليميّة لكي تقدّم تعليمًا يناسب العصر. فالتعليم في الدول النامية كلاسيكيّ يعود إلى القرن الثامن عشر، فيما نحن نعيش في القرن الحادي والعشرين، وتعليمنا ومدارسنا صورة عن المدارس القديمة.
أطفال اليوم تعوّدوا على التكنولوجيا بجانبها المغري، خارج المدرسة يستخدمون التكنولوجيا، وداخل المدرسة أسلوب التعليم تقليديّ قديم، وهذا لا يجسر الفجوة بيننا ومجتمع المعرفة، الذي يحتاج إلى الفكر التحليليّ والنقديّ والإبداعيّ، فمن لا يبدع مآله الموت والاندثار.
هذا الوباء ضرب الجرس وأيقظ الكثيرين ممّن هم بحاجة للاستيقاظ. ومؤشرات التعليم كلّها تبيّن لنا وضع الدول العربيّة ومستواها، وآن الأوان أن نستيقظ من نومنا حتى نواجه مشاكلنا بأنفسنا. وبالطبع بوسعنا إذا اشتغلنا أن نصل لأنّ ماضينا تليد، أخذ منّا الغرب، والآن نأخذ منه.
-
- وصفت المدرسة اليوم بأنّها بعيدة كلّ البعد عن "التعليم مدى الحياة". ما المقصود بهذا المفهوم؟ وكيف يمكن تحقيقه في حالتنا؟
ظهر هذا المفهوم متزامنًا مع مفهوم مجتمع المعرفة. فنحن نعيش في منعطف تاريخيّ يحتاج إلى ما تقوله ثقافتنا وهو أنّ التعليم يجب أن يستمر من المهد إلى اللحد. ماذا بوسع المتعلّم اليوم أن يتعلّم؟ هذا السؤال طرح منذ أرسطو، ماذا ينبغي أن نعلّم المتعلّم؟ وهذا السؤال يعيد نفسه مرارًا. المربي والطبيب النفسيّ كارل روجر (Carl Rogers) قال: إنّه من السخافة طرح سؤال ماذا ينبغي أن نعلّم اليوم للمتعلّم؟ لأن كلّ شيء يتغيّر، وما نعلّمه إياه اليوم يصبح دون فائدة بعد تخرّجه. لذلك على المتعلّم أن يهيئ نفسه للتغيير، لأنّه على الأقلّ سيغيّر مهنته أربع مرّات أو خمسة في حياته. تقول تقارير منتدى الاقتصاد العالميّ: إن ظلّ تعليمنا على هذا المنوال فلن يفيد المتعلّمين. لذلك علينا أن نهيّئ المتعلّم لقبول التغيير وتطوير نفسه باستمرار. ولذلك تلحّ المنظمات المهتمة بالتعليم على التعلّم الذاتيّ، لأنّها تعتبره السند الذي يفيد الشخص في خضمّ هذا العالم الذي يتغيّر فيه كلّ شيء. ولذلك نحتاج إلى بيئة تمكينيّة تساعد المتعلّم على غرس هذا الاستعداد في نفسه وأن يظل مرتبطًا بالتعلّم.
-
- الهدر المدرسيّ والفاقد التعليميّ وتأثيرهما على تطوير رأس المال البشريّ، كيف يمكن التعامل مع هذه الظاهرة وتحديدًا في المغرب؟
هذه الظاهرة آفة تستنزف الموارد الماديّة والبشريّة، وهي تمثّل في نظري عائقًا كبيرًا في تحقيق التنمية. وظاهرة التسرّب أو الهدر المدرسيّ لا تقتصر على مساءلة السياسة التعليميّة، وإنّما هي ظاهرة تسائل المجتمع والدولة، لأنّ تداعياتها تمسّ الجميع في العمق. هذه الظاهرة تؤدي إلى انتشار الأميّة والبطالة والانحراف والجريمة في المجتمع. وهذه الظاهرة مركّبة، بمعنى أنّ لها عوامل كثيرة ولا تخلو منها أيّ منظومة تربويّة.
وللظاهرة أسباب كثيرة، هناك أسباب ذاتيّة وأسباب بيداغوجيّة وأسباب اجتماعيّة واقتصاديّة. أذكر أبحاثًا مهمّة أجراها المجلس الأعلى للتعليم في 2008 وجدت أنّ هناك 300 ألف تلميذ وتلميذة خارج الفصول الدراسيّة، خاصّة الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة والخامسة عشرة، فهم ينقطعون عن الدراسة لأسباب مختلفة. وقد نجحت الوزارة في التغلّب على الظاهرة وقدّمت أرقاما مشجّعة، ولكن كوفيد 19 أعادها للوراء.
قدّمت الوزارة بعض المقاربات التي حاولت أن تخفّف من الظاهرة، مثل تقديم سند ماليّ للأسر الفقيرة، من خلال تهيئة الموادّ المدرسيّة التي يحتاج إليها الطالب، وبذلك تعين ماديًّا الآباء الذين يحتاجون إلى المساعدة حتى لا يذهب أولادهم إلى العمل أو يبقوا في البيت. وشملت المساعدة المناطق القروية والبوادي وكذلك الأحياء الهامشيّة. كما نظّمت الوزارة حملات تستهدف الآباء للتوعية بأهمّيّة المدرسة ودورها في مستقبل الأسرة. وخلقت مديريّة خاصّة للتعليم الذي يقدّم للتلاميذ ما يعرف بالفرصة الثانية، أي تمكين أطفال أعمارهم بين عشرة وخمسة عشر عامًا من الدراسة، ما يشكّل لهم فرصة جديدة بعد الانقطاع أو عدم الالتحاق بالتعليم في بدايته. وحاولت الوزارة جعل التعليم حتى سنّ الخامسة عشرة إلزاميًّا للجميع.
وعلاقة كوفيد 19 مع هذه الظاهرة لا تقتصر على الحرمان من التعليم، فالمسألة، حسب اليونيسيف واليونسكو، لا تتعلّق فقط بالمعرفة، وإنّما بالآثار النفسيّة على الطلّاب. نسمع كثيرًا أن امتدادات الجائحة لن تنتهي بالقضاء على الفايروس أو محاصرته، وإنّما ستمتد لسنوات طويلة، فالأطفال لا يستطيعون فهم الجائحة وما غيّرته في حياتهم، لذلك يعيشون حالات نفسيّة صعبة، خاصّة أن الدراسات النفسيّة لم تكوّن بعد صورة وافية عن تداعيات الجائحة.
-
- لو تحدّثنا عن مشروع "تربية الأمل"، ما هو باختصار وأين أصبح اليوم وما توقّعاتك لمستقبله؟
مشروع "تربية الأمل" هو نموذج فكريّ طموح في التنشئة الاجتماعيّة للطفل العربيّ، من إعداد المجلس العربيّ للطفولة والتنمية، وهي مؤسسة تمثّل بيت الخبرة والمعرفة بالطفل وعالمه. والمجلس يؤمن بأنّ نجاح الأمة العربيّة يكمن في نجاح الاهتمام بأطفالها، لذلك نتساءل ما هو نصيب الطفل في الفضاء الفكريّ للعالم العربيّ؟
يعتقد المشروع بأنّ التنشئة الإيجابيّة مهمّة جدًا في خلق أطفال يعتمد عليهم المجتمع، لأنّ مستقبل أيّ أمّة في أطفالها وشبابها، لذلك ينبغي الاهتمام بهم. وينبني المشروع على مجموعة من المعطيات الأساسيّة التي تساعد الطفل على أن يحرّر طاقته ويقدّم ما لديه من عطاء، فهو يزخر بإمكانات وقدرات هامّة.
والمجلس العربيّ للطفولة يحاول أن يدعوا المتعاملين مع الطفل إلى احترامه وتشجيعه ومنحه الفرصة ليتكلّم وإعطائه حقوقه وإشباع حاجاته. ويهتمّ المجلس اليوم بقياس مدى جاهزيّة الطفل العربيّ للتعامل مع الثورة الصناعيّة الرابعة، فهو يجري دراسة حول مدى جاهزية الطفل العربيّ للتعامل مع هذه الثورة، فهي قادمة لا محالة، ومن المهمّ استشراف الظاهرة وتهيئة أطفالنا للانخراط فيها بإيجابيّة.
باختصار، يشتغل المجلس ويهتمّ بكلّ ما له علاقة بالطفل وتنشئته وتكوينه ومستقبله، وبرنامج تربية الأمل هو واجهة لكلّ المهتمّين بالأطفال، ويحاول المجلس توعية كافة الجهات المهتمّة به كاليونيسيف واليونسكو والوزارات المعنية عربيًّا، بهذا النموذج وجذب اهتمامهم إليه.
أمّا التوقّعات، فالمشروع انطلق منذ سنة ونصف تقريبًا، وككلّ المشاريع المتعلّقة بالإنسان، يحتاج وقتًا حتى يؤتي ثماره. خاصّة الوقت اللازم لانتقال المفاهيم من التصوّر النظريّ إلى الواقع العمليّ، فهذا يحتاج لتوعية الأسرة والمؤسّسات التربويّة، وانخراط وسائل الإعلام ووكالات التنشئة كلّها. والمجلس العربيّ للطفولة يعمل على هذه المسائل ليل نهار، يحدوه تحقيق عالم جدير بالطفل الذي يشكّل أمل المستقبل.
-
- أسّست وأشرفت على مجلّة علوم التربية، من وجهة نظرك وتجربتك إلى أيّ حدّ تترك المجلّة وشبيهاتها أثرًا إيجابيًّا في تطوير التعليم عربيًّا؟
مجلّة علوم التربية ولدت بداية التسعينيّات من القرن الماضي، انطلقت من فكرة هائمة تداعب خيالنا وخيال بعض الأساتذة، ثم اغتنت هذه الفكرة، وأصبحت تصورًا يحتاج للتطبيق بعد نضجها. صدر من المجلّة حتى الآن نحو 75 عددًا. كانت نصف سنويّة ثم صارت فصليّة. والحقيقة أنّها صمدت في الأعاصيرـ إن صحّ التعبيرـ فهناك مجلّات كثيرة ظهرت ولم نر منها إلّا عددًا أو عددين وانتهى أمرها.
شكّلت هذه المجلّة مدرسة بالنسبة لكتّابها. بدأ بعضهم بكتابة المقالات وبتشجيعنا والعمل معهم صرنا ننشر لهم كتبًا، ووصلت منشوراتنا لثمانين أو تسعين كتابًا في مختلف التخصّصات النفسية والتربويّة. واستجابت المجلّة لتكوين المعلّمين والأساتذة، وكانت مرجعهم الأساس، لدرجة أنّني أخبرت مرّة أن مقدّمة المجلّة كانت تؤخذ وسيلة لاستشراف الحاجات الأساسيّة التي ينبغي إعدادها للعاملين في التعليم. وأعتقد أنّ المجلّة أدّت واجبها في وقت كنّا في أمسّ الحاجة إلى الإعلام التربويّ. كنّا نطبع منها أحيانًا خمسة آلاف نسخة، وهذا ليس بالشيء اليسير بالنسبة لدور النشر. ولكن مع الأسف اليوم المجلّة آيلة للأفول، وأعتقد أنّها ستتوقّف قريبًا، فالاتجاه اليوم نحو التكنولوجيا والرقمنة التي طغت على الورق، ولم تعد تترك فضاء خاصًّا للمنشورات الورقيّة، كتبًا كانت أو مجلّات.










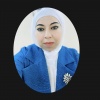


 نشر في عدد (7) شتاء 2022
نشر في عدد (7) شتاء 2022