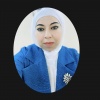حلّ أيلول من جديد، حاملًا مع نسماته اللطيفة رائحة ثمار الجوّافة وثمار البلح، والتي يتزامن موعد قطافها مع التجهيزات المدرسيّة: شراء ملابس المدرسة والقرطاسيّة، والاستعداد لتنظيم أوقات النوم إعلانًا لانتهاء فوضى إجازة الصيف المثيرة.
أيلول هذا العام كان مختلفًا، مؤلمًا، حزينًا. تحملُ نسماته اللطيفة ما يثير الحواس الخمسة عند الغزّيّين بشكل مرهق للغاية؛ فحاسّة البصر لم تعد ترى الألوان الزاهية للزهور، ولا اللون الأخضر المميّز للشجر، ولا انعكاس لون السماء الأزرق على مياه البحر. الألوان هنا إمّا سوداء، أو رماديّة باهتة، أو دمويّة قاتمة. أمّا حاسّة الشمّ، فلا تلتقط إلّا رائحة البارود والغبار المتصاعد من القصف المستمرّ، ورائحة القنابل شديدة الانفجار، إضافة إلى رائحة الحطب المشتعل، وزيت القلي المستخدم وقودًا للسيّارات.
أمّا الأذن، فهي المستشعر الأوّل بالخطر. باتت كلّ الأصوات، حتّى وإن كانت عاديّة وعابرة، مدعاة للذّعر والخوف. ولا عتب: فما سمعَت منذ سنة سوى أصوات القنابل والطائرات والقذائف والزنّانات. وإن أردت الحديث عن حاسّة اللّمس، فلم تكن بأفضل حال من أخواتها: فلم تلمس اليد سوى خشونة الأيّام وتقشّفها، حتّى القدم باتت حصى الأرض ورمالها رفيقها في غياب الأحذية - أكرمكم الله. وحين ينتهي بنا القول، حتمًا سنتذكّر حاسّة التذوّق التي لم تنل طعم الكثير من الأغذية، والتي نُسي طعمها لطول غيابها.
الحديث هنا لم يكن خيالًا يُحكى، ولا حلمًا يُروى؛ لقد كان واقعًا يُعاش ويُبكى معًا.
قد يظنّ الكثيرون أنّ هناك انطفاءًا كبيرًا، بل وعملاقًا، حدث في غزّة، فأنسى أطفالها ذكريات أيلول وزحمته الشديدة في الأسواق، والتدافع الكبير على شراء احتياجات المدارس. والواقع أنّه لا يمكن إنكار حدوث هذا الانطفاء، ومُضي عام حزين بلا علم أو تعليم أو معلّم أو مدرسة أو أسرة، ولا حتّى منزل. لكن، مع كل الانطفاءات الروحيّة والعتمة الدائمة، فنحنُ "بالعلم ننتصر".
توقّفتُ كثيرًا عند التعبير بين المزدوجين. ونفضتُ عن نفسي غبار القصف ومذاق المرار ورائحة البارود. ولمستُ حلمًا ورديًّا كنت أسحبه رويدًا رويدًا من تحت الركام، وأنا خائفة أن يفقد أحد أطرافه فيُبتر، وتعود حياته للون الرماديّ الذي أكره.
قرّرت أن أعود إلى يومي النابض بالعمل، ونهضتُ لأعود إلى يوم المعلّم المُرهق المُزدحم بالأعباء الكثيرة. بحثتُ لمدّة تتجاوز الشهرين عن مكان يصلح لبناء صفٍّ متواضع. أرهقتني رحلة البحث، وما يرافقها من مخاطر. انتظرتُ العديد من الوعود بتوفير صفّ لطلّابي الذين لا أعرف أحدًا منهم، ولكن كلّها تعثّر بالعراقيل وباء بالفشل. حينذاك، دعوتُ الله من القلب أن يجعل لعلمي فائدة، ولروتيني اليوميّ الصعب نهاية مثمرة. لم ألبث قليلًا حتّى استُجيبت تلك الدعوة ووجدتُ مكانًا، وشعرتُ بالفرح للمرّة الأولى منذ أشهر. هرولتُ إلى المكان، وكتبتُ إعلانًا أدعو فيه أطفال الحيّ إلى الحضور لنُنشئ صفًّا نجمع خيوط ذكرياتنا فيه، ونعود لننسجها بالأمل من جديد.
وفي اليوم التالي، تجمّع ما يقارب الثمانين طفلًا، من فئات عمريّة مختلفة. أخبرتُ أحدهم، وأنا أُسجّل الأسماء، أنّه صغير وليس له مكان عندي، لكن سرعان ما وقفتُ عاجزة أمام دموعه المشتاقة إلى المدرسة، فأبدلتُ رفضي بالموافقة من دون تردّد. قسّمتُ الطلبة إلى مجموعتين: صفوف الأوّل والثاني والثالث في أيّام محدّدة، وصفوف الرابع والخامس والسادس في أيّام أخرى من الأسبوع.
لم يكن الأمر سهلًا، فالتعامل مع الأطفال بمزاجيّتهم المتغيّرة وأحاسيسهم المرهفة وشكواهم المستمرّة، جعل الأمر صعبًا. ولكنّي كنت مصمّمة على تحطيم الصعاب داخل صفّي الهجين.
مرّت أيّام، واستعدادي للدوام الذي صنعته لنفسي يزيد. كنت أسعد كثيرًا عندما أدخل وأرى الطلّاب وهم جالسون ينتظرونني. كنت أقرأ أسماءهم لأتعرّف إليهم وأحفظ ملامحهم، خشية أن يحدث طارئ يفرّقني عنهم. فأنا ذلك المعلّم الذي فقد طلّابه في يوم مفاجئ، ولم يُمنح الوقت اللازم لوداعهم. نحن اعتدنا أن تفرّقنا الحروب عن طلّابنا، والفراق عندنا ليس ظرفًا طارئًا يزول.
الفراق في غزّة يعني استشهاد الطالب أو معلّمه، أو انتهاء مدرسة كانت تجمعهما بصاروخ همجيّ.
دعونا نكمل الحديث عن الحلم الجميل الذي أعادني إلى عام مضى. بدأت مع الطلبة بجلسات التفريغ الانفعاليّ. كنت أتوق إلى الاستماع إلى أحاديث الأطفال، وكيف يرون الحياة، وما يدور في خيالهم اللامتناهي أثناء صولات الحرب وجولاتها. هل يعانون مثلما نعاني نحن الكبار؟
بدأت لقاءً تعريفيًّا معهم، فكان بعضهم يُعرّف بنفسه، ثم يذكر شيئًا يحبّه أو شيئًا يفتقده، أو ربّما طبخة اشتهى أن يأكلها. بعضهم اشتاق إلى والده البعيد، أو والدته الشهيدة، أو بيته المهدوم. الآلام هنا كثيرة، والجراح لا سبيل لحصرها. وأثناء اللقاء التعريفيّ، تفاجأت بأحدهم عندما وقف ولم يستطع أن يعرّف بنفسه؛ اكتفى بالبكاء على الرغم من كلّ تشجيعي له على متابعة الحديث. أدركت حينها أنّ الهموم أيضًا استوطنت تلك النفوس الصغيرة.
يومًا بعد يوم، اعتاد الطلاب وجودي، وأحببتهم للغاية. كنت أفرح عندما أرى إحدى الطالبات ترتدي الزيّ المدرسيّ. حدّثت نفسي بأنّ تلك الطفلة ظنّت أنّني الأمل لها في العودة للتعليم... لم تعرف أنّها هي، بزيّها وحقيبتها المدرسيّة، طوق نجاتي أتشبّث به.
لطالما أحببت أن أحضر لهم أطباقًا أصنعها في المنزل، مع غلاء الأسعار وشُحّ الموارد. إلّا أنّ الأمر لم يخل من فاعلي الخير وأصحاب البصمات المميّزة في عالم الإنسانيّة، والذين أصرّوا على دعم هذه المبادرة التي أسميتها "بالعلم ننتصر".
أذكر أنّنا اضطررنا إلى تغيير مكان الدرس بسبب سكن بعض النازحين في الصفّ. لكنّنا سرعان ما تجاوزنا الأمر، وأكملنا الطريق في مكان مجاور. ولعلّ ما أضحكني وأبكاني في الوقت ذاته، هو أنّ هذا الطفل الذي يتواجد معي في الصفّ قد يضطر إلى المغادرة: بسبب نداء أبيه له لتعبئة المياه لقلّتها وانعدامها أحيانًا؛ أو نداء أمّه عليه لإحضار طعام الغداء من تكيّات الخير؛ أو تغيّبه بالكامل بسبب عدم نفاذ البضاعة التي يتجوّل بها بائعًا في أزقّة المخيم...
كثيرًا ما كنت ألتقي بأحد الطلبة من الصفّ السادس، وهو يحمل أسطوانة الغاز على ظهره، ويذهب بها إلى موزّع الغاز في المنطقة. أو يجُر عربة حديديّة تحمل كمّيّة من أوعية الماء المملوءة التي يفوق حجمها جسده الضئيل. تساءلت: لماذا يحدث كلّ هذا لهؤلاء الأطفال؟
متى ستُسعف قوانين البشريّة الكاذبة هؤلاء الأطفال من براثن هذه الكارثة؟
ذات يوم، قسّمتهم إلى مجموعات. ووزّعت على كلّ مجموعة ورقة كبيرة ومجموعة أقلام، وطلبت منهم أن يرسموا رسمة تعبّر عن قصّة معيّنة. كان عليهم تقسيم الأدوار بينهم، ما بين مؤلّف ورسّام وكاتب وراوٍ للقصّة. بدأت بتنفيذ النشاط، وراقبتهم وهم يوزّعون الأدوار، تارةً بشكل هادئ وتارةً أخرى بنزاعات بينهم. تجاهلتُ النزاعات، وحرصتُ على ألّا أتدخّل فيها، وأخذت أصوّرهم.
قال الطفل هذا الكلام، ولم يتبقَّ من الطلبة أحد؛ فقد هرول الجميع مسرعين لمغادرة المكان. تبلّدت في مكاني، وأخذت أتأمّل الرسومات. صرت أتوقّع قصّة لرسمة فيها سمكة، وأخرى فيها كوخ وشمس مشرقة، وثالثة فيها فراشات فقط.
غادرت المكان وقلبي يرتعد ألمًا وخوفًا: لماذا هذا هو المشهد الذي يتكرّر دومًا؟ لماذا نبدأ طريق البدايات ولا نحظى بشرف النهايات؟ وألف لماذا دارت في دوّامات أسئلتي.
لم يقف الأمر هنا؛ فقد مرّت الأيام وانسحبت الآليّات من المكان، وعدنا والتقينا والحمد لله. كان سؤالي بعد عشرة أيّام من الانقطاع الدراسيّ عن الرسومات والقصص، فأجاب الطلاب جميعهم: "لقد نسينا، يا معلّمتي، محتوى القصّة التي رسمناها."
هذا الأمر هو الذي قيل عنه "شرّ البلية ما يُضحك!" فهل يُعاني المعلّمون في العالم كما يُعاني المعلّم في غزّة؟ وهل نجحت الحرب في محو الذاكرة القريبة للأطفال إلى هذا الحدّ؟
كلّ ما أعلمه أنّ أيلول موعدٌ لقطاف الزيتون وعصره في فلسطين، فهل ستتساقط همومنا وتنتهي أحزاننا كما تتساقط أوراق الشجر في فصل الخريف؟